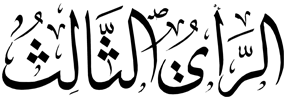"اللافعل" في اليمن: لماذا لا يحدث ما يجب أن يحدث؟
في لحظات التاريخ الفاصلة لا يكون الخطر الأكبر في حضور الخصم بل في غياب القرار، ذلك أن الصراعات في اعتقادي لا تحسم فقط بقوة السلاح بل بوضوح الإرادة ومعنى الفعل، وبالإيمان الحاسم بأن ثمة ما يجب أن يكون،
وفي الحال اليمنية تتجلى المأساة المركبة في مشهد تتداخل فيه أطياف الانهيار مع ظلال التأجيل، حيث ينهض مشروع الميليشيات الحوثية لا بصفته قوة راجحة بل لأن ما ينبغي أن يُنجز لم ينجز بعد.
وفي بنية هذا "اللاوضع" تتآكل الدولة كمفهوم ويتآكل معها المعنى، ويغدو الزمن ذاته على نحو عجيب رهينة الدوران في فراغ السياسة، فالميليشيات التي تجمع الغالبية على حتمية سقوطها لا تزال تتنفس وتناور وتهاجم،
لا لأنها جديرة بالبقاء بل لأن النقيض الذي يفترض أن يحسم أمرها لم يعد يتصرف بوصفه نقيضاً حقيقياً، وما بين يقين الانهيار واستعصاء الحسم تتبدد الفرص وتتكاثر التحديات وتتسع هوة المعنى.
وهذه المقالة لا تقرأ فقط خطر استمرار الحوثية كواقع عسكري أو سياسي أو الاثنين معاً، بل تسعى إلى تفكيك بنية "اللاحسم" بوصفها مأزقاً فلسفياً قبل أن تكون مأزقاً عملياً،
وتعيد التأكيد على أن استعادة الدولة ليست إجراءاً إدارياً أو تفاهماً سياسياً، بل معركة وجود لا تربح إلا عندما يستعاد الفعل من منطق التردد، وتستعاد الدولة بوصفها نقيضاً صريحاً لمشروع الفوضى،
ففي اعتقادي أن الانهيار يولد حين تفقد الفكرة قدرتها على الحياة، وحين يفرغ الفعل من معناه ويصبح الزمن نفسه معلقاً لا ينقضي ولا يُحسم.
في الحال اليمنية لم يعد السؤال الجوهري يدور حول حتمية انهيار الميليشيات الحوثية، فذاك المسار لا يزال قائماً من حيث المبدأ، بل أصبح السؤال الأعمق والأكثر إلحاحاً في تصوري هو لماذا لا ينهار هذا المشروع على رغم يقين سقوطه؟
أو بعبارة أدق لماذا لا يحدث ما يجب أن يحدث؟
لقد آن أوان الحسم غير أن الوقت يمضي في الاتجاه المعاكس ولو ببطء شديد، فعلى أرض الواقع تواصل الميليشيات الحوثية إعادة إنتاج نفسها كخطر متجدد،
لا بوصفها طرفاً في نزاع سياسي بل كمشروع سلطوي إقصائي مغلق يحمل في جوهره نقيض الدولة والمجتمع والحق العام، ويعيش على إطالة زمن المواجهة من دون نهاية،
وها هي تحشد مرة أخرى وتهاجم جبهات شرعية كما حدث في محور علب قبل أيام فائتة وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى من الطرفين، حين قامت الميليشيات الحوثية بحشد عناصرها في ثلاث جبهات عبر مناطق مختلفة، في مديرية الجوبة جنوب مأرب والحديدة في قطاع حيس ولحج باتجاه جبهة كرش، ضمن محاولة لاختبار توازن الردع والإيحاء بأنها لا تزال قادرة على المبادأة، حتى ولو عبر نزف مستمر للضحايا.
غير أن ما هو أخطر من الهجوم هو استمرار حال "اللافعل" المقابل، وأن تظل الجبهات على خطوط التماس لا تتقدم ولا تحسم، وأن تظل الشرعية نفسها بلا قدرة على فرض ما يمليه منطق الدولة، ولا حتى على إعلان قرار واضح باتجاه إنفاذ الشرعية ذاتها، ولقد قلت سابقاً، وبما لا يدع مجالاً للمواربة، إن استعادة الدولة لا يمكن أن تكتمل إلا بتدخل عسكري بري حاسم من جهة شرعية مخولة قانونياً ومعترف بها دولياً ويسندها تحالف إقليمي ودولي يستند إلى قرارات دولية صادرة عن هيئة الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يتغير شيء سوى أن الحسم بدا مع مرور الوقت وكأنه خيار مؤجل على نحو غير مبرر، على رغم توافر مشروعيته ومسوغاته.
في اعتقادي أن الزمن لا ينتظر ولا الدولة، وكل تأجيل للحسم يراكم تحديات إضافية لا تتوقف عند حدود المعارك العسكرية بل تتجاوزها إلى البنية العميقة للدولة والمجتمع،
ففي هذا الفراغ تنمو القوى المضادة للدولة وتتمدد مشاريع التفكيك والانقسام ويتآكل الإيمان بإمكان الحل ويتهدد اليقين ذاته، وأتصور أن ثمة ما يستدعي التأمل،
فهذا "اللاوضع" ليس مجرد توقف في سياق تاريخي بل هو حال تهدد، على نحو ما وبأي قدر، بإعادة صياغة الوعي العام باتجاه الاستسلام وخلق شكل هجين من اللاحرب واللاسلم تمنح الميليشيات شرعية الأمر الواقع، وتعيد تعريف الدولة بوصفها غائبة أو مستحيلة.
لا يمكن لأي مسار في استعادة الدولة أن يستقيم من دون كسر هذا الجمود ومن دون استعادة زمام المبادرة من يد جماعة لا تفهم الدولة إلا باعتبارها غنيمة، والسياسة باعتبارها مراوغة، والحكم باعتباره امتيازاً إلهياً،
وكل تأخير في الحسم يعمق المأساة ويجعل من المستقبل رهينة لحاضر غير محسوم وماض لم ينهَ بعد، والحق أن تحديات ما بعد الحسم، مهما عظمت، تظل في تصوري أقل فداحة من كلفة البقاء في هذا الوضع الرمادي، فتلك التحديات التي تشمل المصالحة الوطنية والسيادة والوحدة الوطنية والحكم الذاتي و تقرير المصير وفك الارتباط والدور الإقليمي والدولي والإعمار ومكافحة الجماعات المسلحة، وحتى الإجابة عن سؤال "الوحدة أو الانفصال"، لا يمكن مقاربتها أصلاً من دون وجود دولة أو مشروع استعادة للدولة في الأقل، أما في غياب القرار فإن هذه العناوين تغدو وقوداً لتفتيت جديد وصراعات أشد فتكاً من الحرب.
إننا بحاجة إلى ما هو أكثر من إدارة النزاع، إذ نحتاج إلى إرادة صلبة تؤمن بأن للحرب نهاية وأن للدولة معنى، وأن استعادة الوطن لا تكون بالتمني أو بلغة البيانات، بل بالفعل الحاسم الذي يصنع الفارق، وما لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي قراره بالمضي إلى النهاية فإن الجماعة الحوثية ستواصل تحريك عجلة الفوضى، ليس لأنها تملك مشروعية أو تفوقاً أخلاقياً، بل فقط لأن الطرف المقابل اختار أن يتعايش مع اللاحسم، وهكذا يصبح المشروع الحوثي، وهو في جوهره مشروع موت، أكثر حيوية من المشروع الوطني ذاته، لأن الأخير ظل مؤجلاً يتردد ويتشكك أو يدار بمنطق الانتظار الممل، وفي نهاية المطاف لا خلاص من دون كسر هذه الحلقة الجهنمية، ولا معنى لأي حديث عن حلول سياسية أو تسويات انتقالية في ظل غياب الدولة الفعلية.
إن الميليشيات لا تنقلب إلى شريك ولا تتحول من سلطة أمر واقع إلى طرف مدني لمجرد اتفاق شكلي، بل يجب أولاً نزع سلاحها وهزيمة منطقها وإسقاط بنيتها قبل التفكير في أي انتقال،
فالحسم ليس خياراً عسكرياً وحسب، بل هو فعل فلسفي ينهي العبث ويستعيد مركز المعنى، فإما أن تستعاد الدولة أو نواصل الدوران في زمن الميليشيات، زمن اللاحسم واللاقرار و اللامعنى، لأن استعادة المعنى في نهاية المطاف هي جوهر استعادة الدولة.
سامي الكاف
صحافي وكاتب يمني