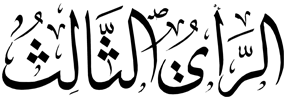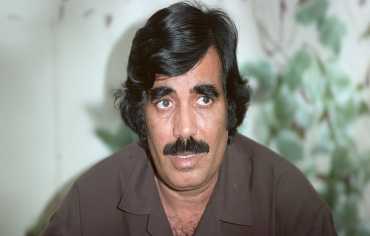تابوت الهويات
عرف تاريخ المثقفين الجزائريين فصولاً من سلاسل الاغتيالات والمنافي والسجون، تختلف اليد التي نفذتها والأسباب التي أدت إليها والطريقة التي نفذت بها، لكن الضحية في نهاية المطاف واحدة المثقف (الكاتب أو الشاعر أو الروائي أو المؤرخ أو الفيلسوف أو الإعلامي)، فمن يد الاستعمار الفرنسي إلى اليد التي أسست للدولة الوطنية المستقلة إلى يد الإرهاب خلال العشرية السوداء الساعية إلى تفكيك الدولة الوطنية ومؤسساتها.
كان الاستعمار الفرنسي ومنذ اللحظة الأولى لغزوه الجزائر عام 1830 يبحث عن أقسى الأساليب وأنجعها لقمع النخب المحلية المتأصلة في تاريخها وثقافتها المحلية والتي تمثل جدار الممانعة، وإن بدرجات مختلفة ومتفاوتة ضد سياسته الاستيطانية، والرامية إلى تعويض أمة بأمة أخرى، كل ذلك عن طريق التهميش والقتل والمتابعات والمسخ الهوياتي.
وموازاة مع سعيه إلى تصفية وجود نخب الممانعة الأهلية، كان الاستعمار الفرنسي يبحث عن سبل لتأسيس نخب جديدة ممسوخة قادرة ومستعدة على إنتاج وتوصيل رسالته الأيديولوجية، وفي هذا المجال ظهر ما يمكن أن نطلق عليه اسم "المثقف الوسيط"، وهو كائن "متوسط المستوى التعليمي" مندهش ومأخوذ بالمستعمر الذي يريد أن يجعل منه "قنطرة أيديولوجية" ممدودة ما بين ضفتي نهر نائم يُنتظر استيقاظه بين الفينة والأخرى، ضفة الآلة الاستعمارية العسكرية والإدارية من جهة، وضفة الأهالي من جهة ثانية.
في المرحلة الأولى حاول الاستعمار الفرنسي أن يستثمر في النخب التقليدية المتكونة في لغتها الأصلية والمتعاملة بها، عربية فصيحة ودارجات وأمازيغية، إلا أنه وجد صعوبة في مراقبتها والتحكم فيها، ولكن مع نهاية القرن الـ 19 وبعد أن تأسست طبقة الكولون الزراعيين الذين بدأوا يراكمون ثقافة خاصة بهم في المستعمرة ويعملون على تأسيس جمالية "جزائريانية" مختلفة عن جماليات المتروبول، بدأ الاستعمار يفكر ويعمل على تشكيل نخب أهلية باللغة الفرنسية كي يمكنه السيطرة عليها.
وتميزت هذه النخب الأهلية الجزائرية باللغة الفرنسية في بدايتها بإنتاج خطاب "المحاكاة" في الأدب والصحافة، خطاب يقوم على تقليد ومحاكاة أسلوب النخب الاستعمارية من خلال الكتابة على منوالها الجمالي والفكري، لكن شيئاً فشيئاً ومع صعود الحركة الوطنية الاستقلالية انطلاقاً من عشرينيات القرن الـ 20، بدأت هذه النخب الوسيطة الأهلية تخلق مسافة بينها والنخب الفرنسية الكولونيالية، لتنطلق في تجربة إنتاج خطاب أدبي وإعلامي مغاير أو مختلف، وبدأت الحدود بين الخطابين تتضح والهوة تتوسع، وشكلت الحرب العالمية الثانية صدمة وعي عميقة شحذت خطاب النخب الأهلية المحلية باللغة الفرنسية بأفكار تحررية واستقلالية جديدة.
مع أسماء أدبية وإعلامية وتاريخية من أمثال محمد ولد الشيخ ومولود فرعون ومحمد ديب ومولود معمري وآسيا جبار ونبيل فارس ومصطفى الأشرف ومحمد شريف ساحلي وكاتب ياسين ومفدي زكريا ورضا حوحو وعبدالكريم العقون والزاهري وجان عمروش وغيرها، وبمستويات وعي سياسي وجمالي متفاوتة، تمكنت هذه النخب باللغتين الفرنسية والعربية من أن تشكل جداراً ضد ظاهرة الاستلاب والمسخ السياسي والإثني.
واستطاعت هذه الأصوات الأدبية المشحونة بحلم جزائر جديدة تقطع مع تقاليد الاستعمار أن تؤسس لقارئ في المتروبول نفسه، وما يُشار إليه هو احتضان كثير من دور النشر الفرنسية التقدمية اليسارية والليبرالية لهذه الأقلام الأدبية ودفعها إلى منصات ثقافية مركزية وتحريرها من سجن الهامش "الأنديجيني".
وأمام هذا الصعود الواعي والجاد والعنيد لصوت النخب المستعمَرة وبداية تأثيرها في الرأي العام ضمن المتروبول وأوروبا، حرّك الاستعمار آلته القمعية وشرع في إسكات وتصفية بعض الأقلام الوطنية بالسجن والنفي والاغتيال. ويسجل التاريخ الثقافي الجزائري كيف جرت تصفية كتاب من أمثال مولود فرعون ورضا حوحو وعبدالكريم، وكيف سُجن الشاعر مفدي زكريا صاحب كلمات النشيد الوطني، وتفاصيل سجن وتعذيب الإعلامي الشيوعي هنري عليق الذي سجل ذلك في كتابه الشهير "السؤال"، وسجن الشاعرة أنّا غريكي الصوت التحرري العميق.
ولم تفرق الآلة الاستعمارية في قمعها الوحشي ما بين مثقف أهلي ومثقف أوروبي داعٍ إلى استقلال الجزائر ومنتظم في صفوف الثورة التحريرية.
وإذا كان الاستعمار الفرنسي ركز قمعه ضد النخب التي ساندت الثورة ورعتها وأسهمت في تثمير الفكر الاستقلالي، فإن الجزائر المعاصرة المستقلة فتحت صفحة جديدة في سجل ملاحقة وقمع المثقفين شملت أولئك الذين اختلفوا مع توجهات النظام السياسي بعيد الاستقلال، فباسم منطق الدولة الوطنية مارس النظام الجزائري بعد الاستقلال ملاحقة مجموعة من المثقفين والمبدعين،
وخلال هذه الفترة تكرس القمع بصورة واضحة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده هواري بومدين ضد الرئيس أحمد بن بلة في الـ19 من يونيو (حزيران) عام 1965، فبدأت الملاحقات تتسع والرقابة تتعمم، وما هو مثبت في التاريخ سجن المؤرخ الكبير محمد حربي الذي هرب من السجن ليعيش حياته في المنفى بفرنسا، والمصير نفسه عاشه الشاعر المناضل بشير حاج علي الذي سجن ثم وضع تحت الإقامة الجبرية في الجنوب ومنع من دخول العاصمة،
ويمكننا التذكير أيضاً بمعاناة الشاعر الكبير مفدي زكريا صاحب النشيد الوطني الجزائري إذ أجبر هو الآخر على اللجوء إلى المنفى، حتى إنه مات في منفاه بتونس، والمصير ذاته عاشه المسرحي محمد بودية الذي اغتاله "الموساد" في باريس،
كما أن اغتيال الكاتب والشاعر المناضل جان سيناك بالجزائر العاصمة في بداية السبعينيات ظل لغزاً قائماً.
وإذا كانت الملاحقات والسجن والاغتيالات في العهد الاستعماري حدثت باسم الخوف من الأيديولوجيا الوطنية الاستقلالية التي كانت تهدد وجوده من أساسه، فإن ممارسات القمع والسجن والملاحقات والمنع التي عاشتها النخب خلال العشرية الأولى من قيام الدولة الوطنية كانت تحصل بحجة الخوف من تفكيك هذه الدولة الوطنية الفتية.
وخلال العشرية السوداء الدموية التي عاشتها الجزائر ما بين 1990-2000، وبعد السماح بالتعددية السياسية، دخلت البلاد في تجربة الإرهاب المسلح الذي هيّأ له أيديولوجياً تيار "الإخوان" الذي تغلغل في الجامعة والمؤسسات التربوية ومفاصل الدولة بصورة عامة،
وفي هذا المخطط الإرهابي كانت النخب التنويرية الديمقراطية هي المستهدفة لما كان يمثله خطابها المعاصر من مقاومة واضحة ضد أفكار التيار السلفي، ووسط هذا العنف الإرهابي الإسلاموي الممنهج بدا المثقفون هم المستهدفون، إذ لا يمكن إسكات الشارع إلا بإسكات صوت النخب، ولا يمكن اغتيال الديمقراطية إلا باغتيال المثقف الديمقراطي، ولكل ذلك سنجد الإرهاب المسلح وضع مخططاً لاغتيالات مدروسة للرموز في الفكر والأدب والفن والعلم والإعلام، والهدف تعميم ثقافة الخوف ودفع هذه النخب إلى مربع فيه خياران الموت أو مغادرة البلاد،
بالتالي تفريغها من كل طاقة اجتهادية، وفي ظل هذا المخطط اغتيل كثير من الرموز المقاومة من أمثال الطاهر جاووت وعبدالقادر علولة ويوسف سبتي وبختي بنعودة وبوخبزة والجيلالي اليابس وبلخنشير والهادي فليسي وسعيد مقبل، واختفى الشاعر الطبيب محمد الصالح باوية الذي لم يظهر حتى الآن. وأسماء كثيرة أخرى من خيرة ما أنتجت الجزائر جرت تصفيتها بحجة الدفاع عن مشروع "الإسلام"، وكأن الجزائر كانت قبل ظهور الإرهاب في الجاهلية!
اليوم، إن الأصوات التي جرى توقيفها أو سجنها أو تكميمها تهمتها المسّ بالوحدة الوطنية أو السعي إلى تحريك مسألة الهوية التي كنا نعتقد بأن الشعب الجزائري حسمها من خلال الدستور وأصبحت واضحة المعالم، إذ أضحى المكون الأمازيغي الذي ظل لأعوام مقموعاً ومهمشاً جزءاً أساساً وطبيعياً في بنية المجتمع الجزائري.
إن هذا الوضع المقلق يؤكد أننا لم نناقش بما يكفي "قضية الهوية"، وما يتبعها من لغة وثقافة وحرية تعبير، بخاصة أن الجزائر تتعرض لحصار خارجي غير مسبوق.
ولا أحد يستسيغ أو يقبل بتوقيف كاتب أو مؤرخ أو إعلامي أو شاعر أو فنان تشكيلي لأن أيّاً من هؤلاء لم يستعمل السلاح في معركته، لكن مرات الفتنة أكبر من القتل، لذا وجب فتح باب الحوار الحر في أوساط النخب كي تتبين للجميع الحدود ما بين حرية التعبير والخيانة وإشعال الفتنة.
لا يوجد بلد واحد في العالم يتسامح مع مثقف خائن أو شاعل للفتنة أو ناشر لثقافة الكراهية بين مكونات الأمة الواحدة، مهما كان سقف الديمقراطية في هذا البلد.
وفي الجزائر يزداد الحذر من انتشار أفكار التفتين والكراهية لأنها مرت بتجربة تاريخية دموية رهيبة من خلال تجربة العشرية الدموية السوداء (1990-2000) والتي لا تزال جروحها دامية.
علينا أن نقول وبوضوح، الإسلام في الجزائر بخير فلا يحق لأحد أن يتكلم باسمه وهو مشترك بين الجميع منذ 14 قرناً، وفي الجزائر اللغة العربية أصبحت لغة المؤسسات والجامعة والإدارة والمال فلا أحد مسموح له البكاء عليها أو الاستثمار فيها أيديولوجياً، لكن ما يجب القيام به لمصلحة هذه اللغة هو تحريرها من الدروشة والفكر المتخلف الذي صادرها طويلاً ودفعها نحو الإبداع العالي والعلم، واللغة الأمازيغية أصبحت لغة وطنية ورسمية مدسترة، وصحيح أنها لا تزال بحاجة إلى دعم أكبر وإلى جرأة سياسية في تعميمها في التعليم، إلا أنها لم تعُد ورقة بين أيدي فئة كثيراً ما استعملتها سياسياً للتفرقة بين الجزائريين.
علينا وبكثير من الجرأة أن نحافظ على التنوع الثقافي واللغوي وندفعه إلى الأمام من أجل تعميقه، لا من أجل إسقاط القائم فيه والعودة لنفق الواحدية.
أمين الزاوي
كاتب ومفكر