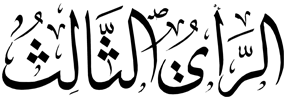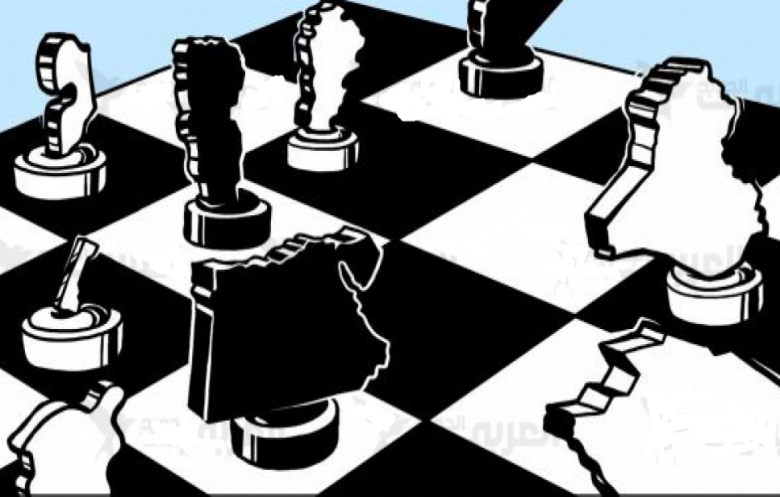
في حاجة المنطقة إلى مراجعات فكرية وسياسية جذرية
عاشت منطقة الشرق الأوسط، قبل يوم 7 أكتوبر (2023)، حالةً من "الاسترخاء الحذر"، اتسمت بحرص الدول المؤثّرة، خصوصاً إسرائيل وإيران وتركيا والسعودية ومصر، على متابعة ما يدور حولها على الصعيدَين، الإقليمي والدولي، استناداً إلى سياسات خارجية نمطية،
تُدار وفق جداول أعمال ترتّب فيها الأولويات بطريقة آلية لا تتحسّب لاحتمال وقوع مفاجآت قد تقلب كلّ الموازين وتجبر الجميع على إعادة النظر،
ليس في ترتيب الأولويات فحسب، وإنما في التوجّهات العامّة للسياسات أيضاً. كانت إسرائيل تبدو مهتمة بشكل خاص بمتابعة التطوّرات المتسارعة لبرنامج إيران النووي، وبتوسيع نطاق "اتفاقات أبراهام" لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول العربية، خصوصاً السعودية،
وتعمل، في الوقت نفسه، على إجهاض المحاولات الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلّة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق على هذا التوجّه. وبدت إيران مهتمّة بشكل خاصّ بتوسيع نفوذها الإقليمي، عبر تقديم كلّ ما تستطيع من دعم لحلفائها في المنطقة، خصوصاً حزب الله في لبنان، وجماعة أنصار الله في اليمن، وبعض المليشيات العراقية،
بالإضافة إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية لتطوير وحماية برنامجيها النووي والصاروخي في الوقت نفسه.
اهتمّت تركيا بما يجري في الساحة السورية بشكل خاصّ، ليس بهدف الحيلولة دون قيام دولة كردية مستقلّة فحسب، ولكن أيضاً لكي تصبح تركيا في وضع يسمح لها بلعب دور رئيس في تحديد مستقبل الدولة السورية نفسها،
مع السعي، في الوقت نفسه، إلى توسيع نفوذها في مناطق أخرى من العالم العربي، خصوصاً في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي. أمّا الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية، فكانت تبدو منشغلةً بأوضاعها الداخلية فحسب، رغم إدراكها أطماع القوى الإقليمية في مقدّراتها،
وبالتالي، غير مكترثة بما يدور حولها، سواء داخل المنطقة أو خارجها، إلا في الحدود التي ترى أنظمتها الحاكمة أنه يهدّد استقرارها ومصالحها الوطنية.
فجأة، وعلى غير توقع، اهتزّت المنطقة على وقع الزلزال الذي ضربها في ذلك اليوم المشهود. فلم يدر بخلد أحد، حتى في أشدّ خيالاته جموحاً، أن يكون بمقدور منظّمة صغيرة في حجم "حماس"، شنّ هجوم مباغت على واحد من أقوى الجيوش في المنطقة، وربّما في العالم، بهذه الدرجة من القوة والدقة والفاعلية،
ولم يتوقّع أحد في الوقت نفسه أن تأتي ردّة الفعل الإسرائيلية على هذا القدر من البشاعة والقسوة، وأن تأخذ شكل حرب إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري للشعب الفلسطيني تطول لما يزيد عن 21 شهراً.
لذا لم يكن غريباً أن تفضي التفاعلات الناجمة من هذا الطوفان، من ناحية، مع التفاعلات الناجمة عن تلك الإبادة، من ناحية أخرى، إلى سلسلة متّصلة ومترابطة من حروب متباينة الحدّة والعنف،
اندلعت على جبهات متعدّدة شملت، بالإضافة إلى قطاع غزّة والضفة الغربية، كلّاً من لبنان وسورية والعراق واليمن وإيران.
ربّما يكون من السابق لأوانه رصد مجمل ما طرأ من تغييرات على موازين القوى في المنطقة، نتيجة هذه السلسلة المترابطة من الحروب، خصوصاً أن الحرب على قطاع غزّة ما تزال مشتعلةً.
ومع ذلك، يمكن القول إن ما جرى للمنطقة خلال هذه الفترة قد دفع بها نحو مفترق طرق جديد، وبات من المستحيل عليها أن تعود إلى النقطة التي كانت تقف عندها قبل هجوم 7 أكتوبر.
ولأن حكومة نتنياهو تدّعي أنها انتصرت في جميع المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الـ21 المنصرمة وحسمتها لصالحها،
وأن النتائج التي أسفرت عنها هذه المواجهات تؤهّل إسرائيل، ليس لدفن القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائياً فحسب (بإجبار جميع الدول العربية على التطبيع معها من دون أي التزام من جانبها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل)،
وإنما تؤهّلها، في الوقت نفسه، لفرض إرادتها على جميع دول المنطقة وإجبار القوى الفاعلة فيها، بما في ذلك إيران وتركيا، على التسليم بالهيمنة الإسرائيلية المنفردة عليها.
ولأنه يستحيل على كلّ من إيران وتركيا أن تقبلا بما تحاول إسرائيل فرضه أمراً واقعاً،
يُتوقّع أن تشهد مرحلة ما بعد الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزّة مراجعات فكرية وسياسية جذرية، تقوم بها معظم الدول الفاعلة في المنطقة، قد تسفر عن تغييرات عميقة في كيفية التعاطي مع المشروع الصهيوني في المنطقة في هذه المرحلة.
لقد ظلّ الصراع مع المشروع الصهيوني في المنطقة، فترة طويلة، يوصف بأنه "عربي - إسرائيلي"، ما يوحي بأن العالم العربي، وفلسطين في القلب منه، وحده المعني بما يمثّله المشروع الصهيوني من تهديد،
أمّا بقية دول المنطقة، خصوصاً تركيا وإيران، فلا يشكّل لها هذا المشروع أيّ نوع من التهديد. ومن هنا حرص القوى الغربية الراعية له منذ البداية، ليس على الحيلولة دون انخراط هاتَين الدولتَين الإسلاميتَين في الصراع إلى جانب الدول العربية فحسب،
ولكن دفعهما، في الوقت نفسه، إلى تطبيع العلاقة مع إسرائيل، والاعتماد عليهما ركيزتين أساسيتَين من ركائز السياسة الغربية في المنطقة، وهو ما يفسّر انخراط تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 1952، وانخراط إيران وتركيا معاً في حلف بغداد عام 1955.
صحيح أن إيران تمرّدت على الهيمنة الغربية وخرجت من عباءتها فور اندلاع الثورة الإسلامية فيها عام 1979، ما أدّى إلى فكّ ارتباطها بإسرائيل وانخراطها بهمّة في دعم قوى المقاومة في المنطقة منذ ذلك الحين، إلى أن دخلت معها في صدام عسكري مباشر بعد "طوفان الأقصى"،
غير أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل ظلّت متينةً على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيد العسكري، حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، ثمّ راحت العلاقة بين البلدَين تتذبذب،
فتميل تارّةً نحو التوتر وتارة أخرى نحو الهدوء، إلى أن بدأت المصالح بينهما تتعارض إلى حدّ التناقض في الساحة السورية عقب سقوط نظام بشّار الأسد نهاية 2024، وتولي أحمد الشرع، حليف تركيا، قيادة المرحلة الانتقالية في سورية.
صحيحٌ أنه ليس من المتوقّع أن يصل تعارض المصالح بينهما في الساحة السورية إلى حدّ الصدام المسلّح، إلا أنه قد لا يكون من السهل عليهما إيجاد صيغة للتعايش السلمي بينهما هناك، في ظلّ إصرار إسرائيل على الإبقاء على سورية ضعيفةً وشبه منزوعة السلاح، وعلى توظيف النعرات الطائفية لتفتيتها إلى كانتونات قد تشكّل خطراً مباشراً على الأمن التركي.
لذا، فليس من المُستبعَد إطلاقاً دخول العلاقات التركية الإسرائيلية مرحلةً جديدةً يغلب عليها الطابع الصراعي.
ولوج إيران وتركيا حلبة الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني في المنطقة، وإن بدرجات متفاوتة الحدّة، بسبب ما أفرزه "طوفان الأقصى" من تداعيات، ستكون له تأثيرات عميقة قد تؤدّي في المستقبل المنظور،
ليس إلى تغيير طبيعة هذا الصراع فحسب، وإنما بنيته وموازين القوة بين أطرافه الفاعلة، سواء ما انخرط منهم فيه منذ البداية، أو الأطراف القابلة للانخراط فيه بدرجة أعمق في مراحل مقبلة. فإصرار إسرائيل على حرمان إيران من حقّها في تخصيب اليورانيوم في أراضيها، وعلى نزع سلاح حزب الله، حتى ولو أدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في لبنان،
وعلى نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في كلٍّ من القطاع والضفة الغربية، مع التمسّك في الوقت نفسه بضمّ الضفة الغربية وإعادة احتلال القطاع واستيطانه، ورفضها القاطع إعادة الجولان إلى السيادة السورية، والإصرار على أن تنصّب نفسها حاميةً للدروز وللأكراد في بلد عربي عريق...
ذلك كلّه ليس له سوى معنى واحد، أن إسرائيل لا تسعى إلى الاندماج السلمي مع جيرانها، وإنما للهيمنة على المنطقة ككل وإخضاعها لإرادتها المنفردة.
ولأنها على يقين تام من أن إدارة ترامب مستعدّة وجاهزة للذهاب معها إلى آخر الشوط، إلى أن يتم اعتمادها رسمياً شرطياً يخضع الجميع لأوامره، فليس أمام دول المنطقة كافّة سوى التضامن معاً في مواجهة هذا المشروع الاستعماري الجديد.
لا يعني ذلك أن الطريق بات ممهّداً أمام دول المنطقة لتحقيق التضامن المنشود، على الرغم من توافر شروط موضوعية تساعد على الدفع في هذا الاتجاه،
فالواقع أن هذه الدول لن تتمكّن من تحقيق ما تصبو إليه من تضامن إلا إذا تمكّن علماء الدين الغيورون، بالتعاون الوثيق مع القادة السياسيين الوطنيين، من إنهاء الصراع المذهبي المحتدم بين السُّنة والشيعة والعمل على تحويل هذا الصراع اجتهاداتٍ فقهية وعلمية متنافسة تلتزم الاحتكام إلى العقل وإلى الضمير الإنساني لحسم ما قد ينشب بينها من خلافات،
وإنهاء الصراع السياسي المحتدم بين العروبة والإسلام، والعمل على تحويل هذا الصراع تياراتٍ فكريةً متنافسةً تلتزم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها لحسم ما قد ينشب بينها من خلافات،
وأيضاً ترسيخ قيم التعدّد والتنوّع والاختلاف، والدعوة إلى احترام "الآخر"، المختلف دينياً ومذهبياً وعرقياً، من منطلق أن الإيمان بهذه القيم هو الطريق الأمثل للوصول إلى كلّ ما هو أرقى وأفضل.
لم يكن بمقدور المشروع الصهيوني الطامح إلى الهيمنة على المنطقة أن يتغلغل في تلافيفها إلى هذه الدرجة لولا نجاحه في مراحل زمنية مضت في ضرب القومي بالإسلامي،
ثمّ في ضرب الإسلام الشيعي بالإسلام السّني، ثمّ في إشعال الفتنة بين المختلفين، ليبقى قادراً على أن يسود وعلى أن يتحكّم وحده في رقاب الجميع. فهل آن لذلك كلّه أن ينتهي كي نصبح في وضع يسمح للجميع بتصويب بنادقهم في اتجاه العدو المشترك؟
حسن نافعة
أكاديمي مصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة