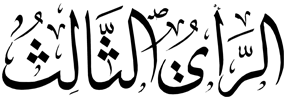القضية الجنوبية في اليمن... النشأة والتحولات والتوظيف السياسي
عادت القضية الجنوبية إلى واجهة الأحداث في اليمن مع تصاعد الأزمة السياسية التي أعقبت تحرّكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2025)، وما رافقها من تأكيده مطلب الانفصال وإعلان قيام دولة الجنوب العربي.
وقد قادت هذه التحرّكات إلى إعلان دستوري مثّل ذروة مسار تصعيدي انتهى بتدخّل عسكري سعودي وإعلان حلّ المجلس.
ما بين إعلان الوحدة اليمنية في عدن في 22 مايو/ أيار 1990، والإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي الجنوبي في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، شهدت عدن تحولاً رمزياً عميقاً، انتقلت خلاله من عاصمة لإعلان الوحدة إلى ساحة لإعلان الانفصال الثاني، ومن رفع شعار "الوحدة" إلى شعار "فكّ الارتباط". وهو تحوّل دراماتيكي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل نتاج مسار سياسي طويل كانت "القضية الجنوبية" عنوانه الأبرز.
وتتصدّر القضية الجنوبية اليوم واجهة الجدلين، السياسي والإعلامي، في اليمن، ليس بوصفها قضية حقوقية ووطنية لم تُحلّ جذرياً منذ ما بعد حرب صيف 1994 فحسب، بل أيضاً باعتبارها ساحةً مفتوحةً لتقاطعات المصالح المحلّية والإقليمية، ومجالاً خصباً لتوظيف المظلومية التاريخية في خدمة مشاريع سياسية متباينة، يصل أقصاها إلى الدعوة الصريحة للانفصال واستعادة دولة الجنوب.
ما بعد 1994: الجذور الصلبة للمظلومية
اندلعت حرب صيف 1994 بين شريكَي الوحدة اليمنية: المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح، الذي كان يحكم الشطر الشمالي، والحزب الاشتراكي اليمني بقيادة علي سالم البيض، الذي كان يحكم الشطر الجنوبي، نتيجة تصاعد الخلافات السياسية وفشل مشروع الوحدة الاندماجية.
وكان من أبرز دوافع الحرب الاستهداف الممنهج لكوادر الحزب الاشتراكي، إذ تعرّضت القيادات الجنوبية لسلسلة اغتيالات سياسية في صنعاء، ما عمّق فجوة الثقة بين الشريكَين، وأفضى، في النهاية، إلى الانفجار العسكري الشامل وانهيار اتفاقيات السلام.
شكّلت حرب صيف 1994 محطةً مفصليةً في تاريخ اليمن الحديث، ليس فقط لأنها أنهت عملياً صيغة الشراكة الهشّة التي قامت عليها وحدة 1990، بل لأنها أسّست مساراً طويلاً من الإقصاء والتهميش، خصوصاً في المحافظات الجنوبية.
فبعد انتهاء الحرب بانتصار عسكري للطرف الشمالي، جرى التعامل مع الجنوب بوصفه "أرضاً مهزومة" لا شريكاً سياسياً. وتم تفكيك مؤسّسات الدولة الجنوبية السابقة، وإقصاء آلاف العسكريين والأمنيين والموظّفين المدنيين من وظائفهم عبر الإحالة إلى التقاعد القسري أو تركهم من دون أيّ تسويات عادلة.
كما شهدت الأراضي والعقارات العامة والخاصة عمليات استحواذ ونهب من نافذين عسكريّين وقبليّين، في غياب أيّ مسار قانوني منصف.
ولم يكن هذا الإقصاء مجرّد خلل إداري عابر، بل تحوّل، مع مرور الوقت، شعوراً جمعياً بالظلم، تراكم عبر السنوات، وأصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية للجنوب ما بعد الوحدة.
ومع غياب أيّ اعتراف رسمي بحجم الأخطاء أو فتح مسار جادّ للمصالحة والإنصاف، ظلّ هذا الشعور كامناً ينتظر لحظة التعبير العلني.
تأسيس الحراك الجنوبي
يُعدّ الحراك الجنوبي المظلّة الأوسع التي انضوت تحتها، منذ منتصف العقد الأول من الألفية، قوى سياسية ومجتمعية جنوبية طالبت بمعالجة ما تُعرف بـ"القضية الجنوبية".
وقد بدأ الحراك بوصفه حركةً احتجاجيةً ذات مطالب حقوقية قبل أن يتحوّل تدريجيّاً مشروعاً سياسياً يرفع شعار استعادة الدولة الجنوبية.
وتعود إرهاصات الحراك إلى ما بعد حرب 1994، حين ظهرت تجمّعات محدودة وذات طابع شبه سرّي، إلا أن انطلاقته العلنية جاءت في 7 يوليو/ تموز 2007 من عدن، بالتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب، عبر احتجاجات قادها عسكريون جنوبيون أُحيلوا إلى التقاعد القسري مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم وإنصافهم.
وقد برزت في قيادة الحراك عدة شخصيات، منها العميد ناصر النوبة بوصفه أحد مؤسّسيه الميدانيين، وحسن أحمد باعوم أحد أبرز رموزه السياسية.
ثم ما لبثت أن اختارت قيادات جنوبية تاريخية مثل علي سالم البيض (تُوفّي قبل أيام)، وحيدر أبو بكر العطّاس، وعلي ناصر محمد، أن تقحم نفسها في المشهد،
فضلاً عن قيادات ميدانية برزت لاحقاً، ما أدّى إلى توسّع مطالب الحراك لتتخطّى المطالب الحقوقية، وبدأ الحديث عن مطالب سياسية وسط تنافس بين القوى السياسية المنضوية حديثاً وذهاب بعضها إلى رفع السقف لاستقطاب الشارع.
عملياً، مرّت مطالب الحراك بمرحلتَين أساسيَّتَين: ركّزت الأولى في الحقوق الوظيفية والعسكرية ووقف الاستيلاء على الأراضي في الجنوب، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى رفع مطالب سياسية،
أبرزها "فكّ الارتباط" بالشمال، وحقّ تقرير المصير عبر استفتاء، وصولاً إلى المطالبة باستعادة دولة الجنوب بحدود ما قبل وحدة 1990.
واعتمد الحراك في نشاطه على أدوات احتجاجية واسعة، من بينها تنظيم تظاهرات حاشدة عُرفت بـ"المليونيّات"، لا سيّما في ساحة العروض في عدن،
إضافة إلى حملات عصيان مدني متكرّرة، ورفع شعار "التصالح والتسامح" منذ عام 2006، في محاولة لتجاوز الصراعات الجنوبية الداخلية السابقة وتوحيد الصف.
ومنذ ما بعد حرب صيف 1994 تشكّلت عدّة مكوّنات تبنّت القضية الجنوبية، واختلفت في وسائلها وسقوفها السياسية، من أبرزها: 1. حركة تقرير المصير (حتم): من أوائل الإرهاصات التنظيمية ذات الطابع السرّي عقب الحرب،
وظهرت في منتصف تسعينيّات القرن الماضي متبنّيةً خطاباً يدعو إلى تقرير مصير الجنوب.
2. جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين: برزت عام 2007 بوصفها النواة الفعلية للحراك السلمي الجنوبي، قبل أن تتطوّر مطالبها من حقوقية إلى سياسية.
3. المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب: تشكّل عام 2009 مظلّةً جامعةً لعدد من المكوّنات المؤمنة بخيار الاستقلال، وقاد مرحلة تصعيد سياسي وجماهيري واسع.
4. مؤتمر القاهرة (2011): مثّل تياراً سياسياً قادته شخصيات جنوبية تاريخية، وطرح مقاربةً وسطيةً تقوم على إقامة دولة فيدرالية من إقليمين لفترة انتقالية تنتهي باستفتاء يحدّد مستقبل الجنوب.
ثورة فبراير: دينامو جديد للقضية الجنوبية
جاءت ثورة 11 فبراير (2011) الشبابية الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لتكسر حالة الركود السياسي في اليمن، إذ وجد الحراك الجنوبي نفسه أمام مشهد مغاير تماماً.
فبينما كان الحراك قد بدأ فعلياً في عام 2007، إلا أن سقوط جدار الخوف في صنعاء ورحيل نظام صالح منحا القضية الجنوبية زخماً دولياً وميدانياً لم يكن متاحاً.
لقد تراجعت القبضة الأمنية المشدّدة التي كانت تحاصر مدن الجنوب، ما أتاح مساحاتٍ أوسع للتعبير ورفع سقف المطالب التي وصلت إلى "فكّ الارتباط".
خلال تلك الفترة، تحوّلت الساحات في عدن والمكلا إلى مراكز استقطاب سياسي، فتداخلت شعارات التغيير مع مطالب استعادة الدولة، واستثمر الحراك الجنوبي حالة الانكشاف السياسي للنظام لفرض القضية بنداً رئيساً على الطاولة الدولية.
هذا الزخم أجبر القوى المحلّية والمجتمع الدولي على الاعتراف بأن "القضية الجنوبية" هي مفتاح الحل لأزمات اليمن، وهو ما تجلّى لاحقاً في تخصيص فريق عمل مستقل لها في مؤتمر الحوار الوطني.
وبذلك لم تكن ثورة فبراير مجرّد حدث عابر، بل كانت نقطة التحوّل التي نقلت القضية الجنوبية من مربّع "المطالب الحقوقية" إلى عمق "المعادلة السياسية والسيادية".
القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني
مثّل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في صنعاء عام 2013 برعاية دولية وأممية، المحطّة الأبرز في تاريخ اليمن الحديث لمحاولة صياغة عقد اجتماعي جديد عقب ثورة فبراير.
وسعى المؤتمر عبر تسعة فرق عمل إلى معالجة قضايا شائكة، بدءاً من بناء الدولة والعدالة الانتقالية، وصولاً إلى قضايا صعدة والتنمية، بمشاركة واسعة ضمّت مختلف القوى السياسية إلى جانب الشباب والمرأة.
وفي قلب هذا المخاض السياسي، برز فريق القضية الجنوبية بوصفه أحد أكثر فرق المؤتمر أهميةً وحساسيةً، إذ ضمّ 40 عضواً مناصفةً بين الشمال والجنوب، وتركّزت مهمته في بلورة رؤية شاملة تنهي عقوداً من الصراع حول الوحدة والهُويّة، ومعالجة الجذور العميقة للأزمة التي أسهمت في تصدّع النسيج الوطني.
ولضمان جدية المسار السياسي، استبق المؤتمر انعقاده بإقرار حزمة من الإجراءات التمهيدية عُرفت بـ"النقاط الـ20 والـ11"، وهي اشتراطات وضعتها اللجنة الفنّية وفريق القضية الجنوبية لتهيئة الأجواء وبناء الثقة.
وشملت الدعوة إلى اعتذار رسمي عن حرب صيف 1994، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف التحريض الإعلامي، إلى جانب البدء بعمل لجنتَي الأراضي والمبعدين من وظائفهم.
وقد اعتُبرت هذه الخطوات اختباراً جدياً لإرادة الدولة في طيّ صفحة الماضي قبل الشروع في صياغة الحلول السياسية الكبرى.
وأفضت المداولات النهائية إلى توصيف القضية الجنوبية باعتبارها قضيةً سياسيةً وحقوقيةً عادلة نشأت نتيجة اختلال مشروع الوحدة وتحوله، عقب حرب 1994، صيغةً قائمةً على الاستحواذ والإقصاء، وما رافق ذلك من نهب للمقدرات العامة وإقصاء ممنهج للكوادر الجنوبية.
ولتجاوز هذا الإرث أقرّ المؤتمر خريطة طريق تقوم على التحوّل نحو دولة اتحادية مدنية تضمن للجنوبيين إدارة شؤونهم الذاتية، مع الالتزام بمعالجة المظالم التاريخية، بما في ذلك إعادة الممتلكات المنهوبة، وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة عبر نظام الأقاليم، باعتباره مدخلاً لاستعادة الثقة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
انقلاب الحوثيين: تمديد الأزمة الجنوبية
شكّل انقلاب جماعة الحوثي على مؤسّسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014 ضربةً قاصمةً لمسار التوافق الوطني، إذ أدى إلى تقويض المرحلة الانتقالية وتعطيل آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية.
ومع توسّع سيطرة الجماعة على المدن اليمنية وصولاً إلى عدن، انتقل المشهد من مسار الحلول السياسية التوافقية إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، أعادت إنتاج سردية المظلومية الجنوبية، لكن في سياق أكثر تعقيداً وخطورةً، إذ أُزيحت لغة الحوار لمصلحة منطق السلاح وفرض الوقائع بالقوة.
وأجهض الانقلاب مسار "بناء الثقة"، الذي مثّلته النقاط الـ20 والـ11، وعطّل مشاريع جبر الضرر واستعادة الحقوق المنهوبة، كما عمّق الانقسامات بين الأطراف اليمنية، وجمّد مشروع الدولة الاتحادية الذي كان يُنظر إليه إطاراً جامعاً لمعالجة القضية الجنوبية.
ولم يقتصر هذا الانهيار على تعطيل تنفيذ المخرجات، بل دفع بالقضية الجنوبية نحو مسارات أكثر راديكالية في ظلّ تلاشي آمال الحلول التوافقية تحت وطأة الحرب، وبروز فواعل سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، جعلت من العودة إلى مخرجات الحوار الوطني بصيغتها الأصلية أمراً بالغ التعقيد في واقع سياسي وجيوسياسي متحوّل.
تعدّد المكوّنات وصراع التمثيل
أعاد انقلاب جماعة الحوثيين على السلطة في صنعاء أواخر 2014، وما تلاه من حرب مفتوحة منذ 2015، تشكيل المشهد السياسي في جنوب اليمن، ودفع الحراك الجنوبي إلى مسار جديد اتسم بتراجع طابعه الاحتجاجي الجامع، وظهور مكوّنات سياسية وعسكرية متعدّدة تنازعت تمثيل ما يُعرف بـ"القضية الجنوبية" وإدارتها.
فبعدما ظلّ الحراك منذ انطلاقته عام 2007 إطاراً فضفاضاً يجمع قوى جنوبية مختلفة حول مطالب حقوقية وسياسية، دخل مرحلة انقسام حادّ مع تعقّد المشهد العسكري وتصاعد التدخّلات الإقليمية.
ويمكن رصد ثلاثة مسارات رئيسة تشكّلت خلال سنوات الحرب:
الأول: صعود المجلس الانتقالي الجنوبي (مايو/ أيار 2017)، وفرض نفسه أبرزَ الفاعلين على الأرض، مستفيداً من دعم إقليمي مكّنه من بناء تشكيلات مسلّحة وتوسيع حضوره، قبل أن يصبح طرفاً في السلطة عبر مشاركته في الحكومة المُعترَف بها دولياً.
الثاني: مكوّنات جنوبية أخرى رفضت اختزال القضية في كيان واحد، ودعت إلى تقرير المصير أو رفضت التسويات، لكنّها عانت ضعف التنظيم وتراجع التأثير الميداني.
الثالث: احتفظ بطابع حقوقي يركز على قضايا المتقاعدين والمظالم الوظيفية، لكنّه تراجع إعلامياً وسياسياً أمام صعود الفعل العسكري.
وخلال هذه المرحلة، برزت محاولات تأثير خارجي في مسار الحراك الجنوبي، وسط اتهاماتٍ بمحاولة إيران إيجاد موطئ قدم في الجنوب، عبر دعم تيارات جنوبية ترفض التسويات.
ويشار هنا إلى الدعم الذي حظيت به تياراتٌ مرتبطةٌ بالرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض خلال إقامته في بيروت، إضافة إلى مجلس الحراك الثوري المرتبط بالقيادي فادي باعوم.
غير أن تأثير هذه التيارات تراجع ميدانياً، خصوصاً بعد عودة فادي باعوم إلى عدن عام 2022 وإعلانه الانخراط في مسار "الحوار الوطني الجنوبي" الذي رعاه المجلس الانتقالي.
وفي السياق نفسه، تأسّس الائتلاف الوطني الجنوبي عام 2018 مكوّناً سياسياً مؤيّداً للشرعية اليمنية وداعماً خيار الدولة الاتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مقدّماً نفسه بديلاً سياسياً للمجلس الانتقالي، لكن حضوره ظلّ محدوداً مقارنةً بنفوذ المجلس الانتقالي.
وتعكس هذه التفاعلات واقع الحراك الجنوبي بعد انقلاب الحوثيين: انتقال القضية الجنوبية من إطار احتجاجي جامع إلى مشهد سياسي متشظٍ تتقاطع فيه الحسابات المحلّية مع التأثيرات الإقليمية.
وبينما لا تزال القضية الجنوبية حاضرةً بقوة في الخطاب السياسي اليمني، يطرح تباين مسارات مكوّناتها تساؤلات حول إمكانية بلورة تمثيل جنوبي شامل في ظلّ استمرار الحرب وتعقيدات التسوية السياسية.
المجلس الانتقالي واستثمار القضية الجنوبية سياسياً
شكّل تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/ أيار 2017 محطةً مفصليةً في مسار القضية الجنوبية، إذ تحوّلت من حركة مطلبية وحقوقية واسعة انطلقت لمواجهة آثار حرب 1994 إلى مشروع سياسي ذي طابع انفصالي يعتمد على القوة العسكرية والدعم الإقليمي.
واستفاد المجلس بقيادة عيدروس الزبيدي من الفراغ الذي أعقب انقلاب الحوثيين وتراجع نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في المحافظات الجنوبية، ليقدّم نفسه ممثّلاً للقضية الجنوبية، معيداً صياغة خطابها من مطالب إصلاحية داخل الدولة اليمنية إلى الدعوة إلى استعادة دولة الجنوب بحدود ما قبل عام 1990.
ويرى منتقدو المجلس أن هذا التحوّل لم يكن معزولاً عن الدور الإماراتي، إذ لعبت أبوظبي دوراً محورياً في دعمه سياسياً ومالياً وعسكرياً منذ تأسيسه، في إطار مقاربة إقليمية هدفت إلى توظيف القضية الجنوبية لإعادة رسم الخريطة اليمنية.
وقد ساهم هذا الدعم في تحويل القضية الجنوبية من مسارها الحقوقي الجامع إلى أداة سياسية مرتبطة بتوازنات إقليمية، ما أضعف إمكانية معالجتها ضمن إطار وطني شامل.
ووفق مراقبين، مكّن هذا الواقع المجلس من بسط نفوذه على عدن ومحافظات أخرى وفرض رؤيته للقضية الجنوبية بوصفها أولوية سياسية منفصلة عن مسار الدولة اليمنية.
ورغم مشاركته في مؤسّسات الحكم، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي، يحتفظ المجلس الانتقالي بسيطرة فعلية على الأرض عبر أذرعه العسكرية، ما أوجد ازدواجاً بين الشراكة السياسية والهيمنة الميدانية.
وقد انعكس هذا في صدامات مع القوات الحكومية اعتبرت محاولات لفرض مشروع الانفصال بالقوة، مما عمّق الانقسام داخل الجنوب وكرّس تعدد مراكز التمثيل للقضية الجنوبية.
ويخلص مراقبون إلى أن تحويل القضية الجنوبية من حركة احتجاجية ذات مطالب حقوقية إلى مشروع سلطوي مدعوم إقليمياً أسهم في تفريغها من بعدها الجامع وحصرها في إطار سياسي ضيّق.
وبينما لا تزال المظالم الجنوبية قائمة، تظلّ معالجتها مرهونةً بإعادة فصل المطالب الحقوقية المشروعة عن مشاريع التفكيك، والعودة إلى مسار سياسي وطني يعالج جذور القضية بعيداً عن فرض الوقائع بالقوة.
ويرى نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، محمّد المخلافي، أن القضية الجنوبية في جوهرها "قضية سياسية بامتياز" ناتجة عن تمركز السلطة في صنعاء ورفض النظام السابق بناء دولة الوحدة وفق الدستور.
وأوضح المخلافي أن الحزب الاشتراكي طرح منذ عام 1993 "النقاط الـ18" التي توجّت لاحقاً بـ"وثيقة العهد والاتفاق" لبناء دولة ديمقراطية قائمة على اللامركزية المالية والإدارية،
لكنّه أشار إلى أن النظام القديم أعاق تنفيذ الوثيقة، ما دفع الحزب للمطالبة بـ"اللامركزية السياسية" الشاملة.
وأكّد أن حرب صيف 1994 كانت تهدف إلى إفشال مشروع الدولة، وترتب عليها تعديل الدستور لتركيز السلطة في العاصمة والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وتسريح آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين قسراً.
وأوضح أن معالجة أوضاع المسرحين بدأت في 2013 واكتملت في 2025، فيما لا يزال ملفّ الممتلكات المنهوبة قائماً من دون اعتذار رسمي من القوى المشاركة في الحرب.
وشدّد المخلافي على أن مخرجات الحوار الوطني الشامل أكّدت البعد السياسي للقضية الجنوبية، مؤكّداً تمسّك الحزب بحلّها عبر إقامة دولة اتحادية، ومعالجة آثار حرب 2015، واستيعاب مطالب القوى السياسية الجديدة في الجنوب.
وفي وقت تتعدّد المكوّنات السياسية في الجنوب، يبقى التحدّي الأكبر فصل المطالب الحقوقية عن الحسابات السياسية، والعودة إلى مسار وطني شامل يعالج جذور القضية بعيداً عن الانقسامات والصراعات.
فخر العزب
صحافي يمني