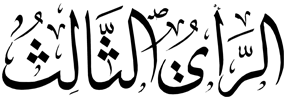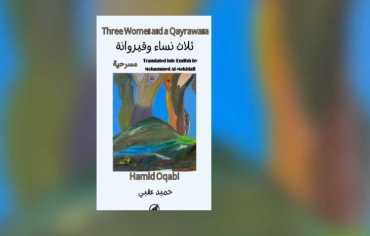المجتمع العربي والتاريخ: حين يتحول التكرار إلى مهزلة
لا نزال نعيش في المجتمع البطركي الذي بلور هشام شرابي (1927- 2005) ملامحه في مشروعه الفكري، وحدد عناصره البنائية، وأوضح آلية تجذره في تربة مجتمعنا العربي، واقترح آلية تجاوزه، وإيجاد بديل جذري له،
وقد رحل شرابي عام 2005 دون أن يرى ثمار محاولته متجسدةً على الأرض، أو يشهد بعينيه تموضعَ هذا البديل في بنية مجتمعنا العربي.
ومن أسف أننا أبقينا البنية البطركية المترسخة في تربة مجتمعنا العربي قويةً، كما كانت، وجاهدنا في ترسيخ دعائمها، وحدثْنَاها بقشور استعَرْناها من الآخَر الغربي، والأمريكي تحديداً، وظلت علاقتنا بالحضارة والحداثة وما بعدها مقصورةً على الإفادة من قشورهما لا غير،
أما اللب والجوهر فحرصْنا على الابتعاد عنه ما أمكن، ولا نزال نفعل ذلك حتى الآن بإقبالٍ منقطع النظير.
واليوم حين يطالب بَعضنا «القطيعَ»، أو»الكتلة الاجتماعية الصماء» بترك هذه القشور، والالتفات إلى الجوهر يعادَى وينبَذ كما عودِيَ عروة بن الورد قبله حين انتهج لنفسه نمطَ حياةٍ مغايراً لنمط حياة قبيلته؛ فرُمِي بعيداً كالأجرب، وأباحت قبيلته دمَه للقبائل الأخرى،
ومثلها يفعل العرب المعاصرون مع المعارضين الشرفاء، الذين أفرد لهم خليل النعيمي روايته الفارقة «الخلَعاء».
ومما نشاهده اليوم ونعجب له أن أغلب الفنانات العربيات ونساء المدن في عالمنا العربي، وحتى فتيات القرى البسيطات أصابتْهن حمى الاستهلاك واللهاث خلف القشور، فعمدْنَ إلى نفْخ شفاههن، وتغيير معالم أجسادهن كلها: خدوداً، وصدوراً، وسيقاناً، وشفاهاً، وأقفيةً
وحرصْنَ على وضع «أظافر» اصطناعية، وتغيير ألوان عيونهن، وأقبلْنَ على عمليات التجميل، للاندراج في نظام التفاهة العالمي، وتبني مظاهره المزيفة، التي يحرص نظام الاستهلاك والترفيه على إشاعتها وترويجها في فضائنا العربي ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
لقد أصبحْنا نعيش في مجتمع بطركي محدَث، ولا نزال نؤثِر الاتكاء على البنية الفكرية البطركية كموجِه لنا في الحياة، ونستعير من الآخَر، في الوقت نفسه، ما يدل على رغبتنا العارمة في الاندغام به، والتماهي معه،
مع أننا نسِمه بالكفر في العلن، ونعلِن أنه ليس مثلا أعلى لنا، وأن مواطنيه سيدخلون النار جميعاً؛ لأنهم ابتعدوا، في رأينا، عن الدين، وأداروا ظهورهم إلى تعاليم الله.
إننا نستقي من البنية البطركية مجمل عناصرها الرثة، ونستهلك من فضاء الآخَر أسوأ ما أنتجتْه مصانعه؛ فتغدو شخصياتنا في هذه الحالة مزيفةً وبالغةَ الهشاشة، ليس فيها من الأصالة ملمحٌ قابلٌ للتجدد أو للحياة،
وليس فيها مما ابتكره الآخر إجراءٌ نافعٌ أو مجْدٍ يمكن أن يساعدنا في اكتساب شخصية مستقلة عن الآخَر، أو في اللحاق بركب التطور والتقدم الذي سبقنا منذ قرون.
ونحن نحرص على البقاء في مربع النظام البطركي لا نبرحه، ونردد باستمرار وفخر قولا سائراً يلخص رؤيتنا للحياة، ورغبتنا في الالتحاف بالماضي، والتشبه بالأسلاف، مؤكدين أن «منْ شابَهَ أباه فما ظَلَمَ»،
وأن الإنسان يغدو عظيماً إذا بقي كأبيه دون أن ننتبه إلى أن هذا القول يكتنز تناقضاً واضحاً في ثناياه، ويشد التاريخَ إلى الوراء؛
ويعني تكرار المرء لذاته، وعدم رغبته في تجاوزها، مع أن بعض علماء الاجتماع يذهبون إلى أن «الابنَ» ينبغي أن يكون أفضل من «أبيه» دوماً، حسب مقياس التطور التاريخي، وليس مثلَه،
أما إذا كان نسخةً طبق الأصل منه فهو متخلِفٌ زمنياً عنه، ونسخةٌ مـزيفة منه لا غير.
وقد كان ماركس يعد تكرارَ التاريخِ في المرة الأولى «مأساةً» وفي المرة الثانية «مهزلةً»؛ لأن تكرارَه يعني توقفَ الزمنِ عن الجريان، وتثبيتَه، وفي ذلك دليلٌ على الركود، والعودة إلى الوراء، لما فيه من انعدام التطور على المستوى النوعي.
وفي هذا السياق لا أجد فارقاً في الواقع بين «مفهوم الرجولة» و»مفهوم الذكورة»، فكلاهما يحمل الدلالة نفسها،
وقد حرص المجتمع البطركي، أو الذكوري العربي على استخدام كلا المفهومين، ليؤكد هيمنته على المرأة، وتسيده عليها، وتفردَه بالقرارات التي تصدر في البنية الاجتماعية، التي يهيمن عليها. ولا يقتصر استخدام مفهوم «الرجولة» على الذكر وحده،
بل هو شائعٌ لدى قسم كبير من النساء، وحينَ تريد المرأة أو الرجل إبداءَ الإعجاب بامرأةٍ في حيها، أو مدينتها، أو اتسامها بصفاتٍ إيجابية معينة، تعمد إلى تشبيهها بالرجال،
أو تستخدم عبارة شائعة مفادها أن «فلانة هي أخت الرجال»، أي تحِيْل «المرأة» إلى «ذكر» لتؤكد اتسامَها بالصفات الحميدة السابقة، وهذا في الواقع يعكس مفهوماً بطركياً، أو ذكورياً يتبناه الرجل والمرأة معاً، ويؤكد أن مصدر القيم بطركي، أو ذكوري بحت.
لقد أعاد المجتمع البطركي العربي تشكيل هــوِية المرأة وفق ما يريد، وجعل منها نسخةً طبق الأصل من الرجل، ووصل به الحال إلى جعل الكثيرات من النساء يتبنَيْنَ وجهة نظره، ويلغِيْنَ وجهاتِ نظرهن المغايرة لوجهاتِ نظر الرجال،
وما أكثرَ النساءَ اللواتي يفخرْنَ في مجتمعنا العربي بأنهن زوجاتٌ لأطباء، أو محامين، أو مهندسين، أو ضباط، أو مسؤولين كبار، أي يفخرْنَ بتبعيتهن للرجل، لا بما يمتلكْنَ من صفات متفردة، ويصل الأمر بالمجتمع البطركي المهيمِن إلى حد أنه يلغي كينونة المرأة وهويتها واسمها؛ فتصبح: أم علي، أو أم حسين، أو أم جورج، أو أم خالد، ويغدو اسمها الدال على هويتها المستقلة نسياً منسياً،
بل إن المرأة تسهم في قمع مثيلاتها من النساء، متبنيةً مفاهيم المجتمع البطركي أو الذكوري نفسه، وتطالبهن بالانضواء تحت سيطرة الرجل، والاستجابة لرغباته، وسماع كلمته؛ وإطاعة أوامره؛ لأنه الأدرى بمصلحتهن،
ويغدو ذلك جزءاً من شخصيتها، وهي تمارسه من دون وعي، غير مدركة أنها تقوم من خلال ذلك بإلغاء ذاتها، وسحْق هويتها، ومنْع كينونتها من إعادة التشكل بما يقتضيه قانون الصيرورة الذي لا يتوقف عن التغير باستمرار.
وقد عمد الأدب العربي الحديث إلى تقصي ذلك وعكسه في نسيجه السردي منذ سبعة عقود ونيف، ومثاله الأبرز ما قام به نجيب محفوظ في الجزء الأول من ثلاثيته الشهيرة، من خلال تجسيده لشخصية الرجل البطرك «سي السيد» وامرأته التابعة «أمينة»
فضلا عما قام به آخرون من الأدباء العرب، ومن جملتهم القاصة السورية رباب هلال، في مجموعتها المتميزة «قومي يا مريم» (دار التكوين – دمشق – 2021) التي فضحت فيها هذا النموذج،
وسلطت الضوء عليه، وهو الأمر نفسه الذي قامت به الأديبة السورية لميس الزين في روايتها البديعة «الفناء الخلفي» الصادرة عن دار رياض الريس في بيروت في عام 2022.
أحمد عزيز الحسين
كاتب سوري