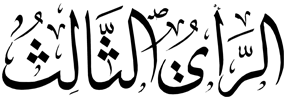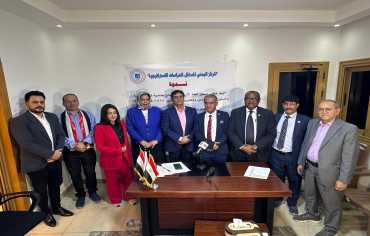ماذا جرى للغرب؟
أصبح من الشائع الحديث عن العيش في "عالم ما بعد الغرب". وغالبًا ما يُستدعى هذا المصطلح للإشارة إلى صعود القوى غير الغربية – وعلى رأسها الصين، إلى جانب البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا ودول الخليج وغيرها.
لكن إلى جانب "صعود الآخرين"، هناك تحول عميق آخر يحدث: انهيار "الغرب" نفسه ككيان جيوسياسي موحد وذي معنى.
فالغرب، بوصفه مجتمعاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً متماسكاً، يعيش حالاً من التراجع منذ فترة، وقد تكون ولاية ثانية لدونالد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة بمثابة الضربة القاضية.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قامت مجموعة متماسكة من الدول الديمقراطية، المتقدمة اقتصادياً، بتبني النظام الدولي الليبرالي المستند إلى القواعد. ولم يكن تقارب تلك الدول نابعاً فقط من تصور تهديدات مشتركة،
بل أيضاً من التزام مشترك في ما بينها بعالم مفتوح قائم على فكرة المجتمعات الحرة ومظاهر التجارة الليبرالية – والإرادة الجماعية للدفاع عن نظام ذاك العالم.
وقد شملت هذه المجموعة المتماسكة من الدول أعضاء أساسيين مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وبعض الحلفاء في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ممن كانوا في ما مضى تحت النفوذ البريطاني، مثل أستراليا ونيوزيلندا،
إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين جرى استيعابهما ضمن نظام التحالف الأميركي بعد الحرب حين تبنتا المبادئ الليبرالية للحكم الديمقراطي واقتصاد السوق.
وقد شكل الغرب صميم ما عرف بالعالم الحر إبان الحرب الباردة. لكنه تجاوز تلك المرحلة الثنائية واستمر في التوسع ليشمل دولاً من الكتلة الشرقية السابقة وبعض الجمهوريات السوفياتية السابقة، عبر توسع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
وعلى مدى الأعوام الـ80 الماضية، قامت الدول الغربية بخلق عدد كبير من المؤسسات لتعزيز أهدافها المشتركة، أهمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومجموعة الدول السبع، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى نحو موازٍ في الأهمية عملت الدول الغربية على تنسيق مواقفها السياسية ضمن أطر أكثر شمولاً ومتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ووكالاتها، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة الـ20.
وكانت تحصل بالتأكيد خلافات وتوترات دورية تجهد ذاك التضامن الغربي. الأمثلة في هذا السياق كثيرة، أبرزها أزمة السويس عام 1956، وتحدي الرئيس الفرنسي شارل ديغول لهيكلية القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي في الستينيات، والتعليق الفجائي الذي قام به الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1971 لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب،
وأزمة الصواريخ الأوروبية في أعوام الثمانينيات، والمواقف الأطلسية المعارضة لاجتياح العراق تحت قيادة الولايات المتحدة عام 2003.
لكن أية من هذه الوقائع لم تشكل اختباراً حقيقياً لتماسك الغرب بقدر ما شكلته عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
فالرئيس الأميركي يتبنى، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وبالفم الملآن، موقف "أميركا أولاً" في السياسات الخارجية والاقتصادية وسياسات الأمن القومي. كذلك تتسم رؤيته لدور الولايات المتحدة في العالم بالمغالاة القومية وبنزعة سيادية وأحادية وحمائية وصفقاتية.
وقلما يتحدث ترمب، بخلاف الرؤساء الأميركيين السابقين، عن القيادة الأميركية للعالم وعن مسؤولية الولايات المتحدة في هذا الإطار. وهو يمقت التحالفات و(الأطر) التعددية والقانون الدولي.
ولا يهتم كثيراً بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية – وقد قام بتفكيك الأطر والمؤسسات الأميركية التي تروج لهذه الأبعاد والممارسات في العالم.
كذلك فإنه يرفض دور الولايات المتحدة في الإسهام بالمصالح الدولية العامة، بما في ذلك التجارة المفتوحة، والاستقرار المالي، ومعالجة تغيرات المناخ، والأمن الصحي العالمي،
ومنع الانتشار النووي. وهو يعد في السياق الرمز الأبرز للقوى السياسية اليمينية والقومية الصاعدة في أوروبا وأميركا الشمالية، جاذباً أفكاراً ضبابية عن حضارية الغرب، ومثيراً، في الوقت عينه، الشكوك حول الأهمية الثابتة للغرب الجيوسياسي.
وقد شكلت تحولات ترمب في هذا الإطار صدمة لشركاء الولايات المتحدة الأقرب. فأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين بأسى في أبريل (نيسان) الماضي أن "الغرب كما عرفناه لم يعد موجوداً".
وحاول القادة الأوروبيون من جهتهم التغطية على تلك الحقائق المؤلمة في عدد من الاجتماعات، بما في ذلك خلال قمتي الدول السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عبر جهود تملق سعت إلى الإطراء على ترمب وملاطفته واستمالته.
إلا أن أصداء ملاحظة فون در لاين تبقى محومة في الأجواء لأنها تتوافق مع ما يراه قادة آخرون ويقولونه ولو همساً وبخفر. فهذه المرة الأمر مختلف حقاً.
ونهاية الغرب ككيان مؤثر وذي معنى ستفضي إلى خسارة كبيرة. إذ إنها ستترك النظام العالمي المفتوح والمستند إلى القواعد هائماً بلا هدف إثر فقدانه مرساه التاريخي والمحرك الأساس لتقدمه.
لقد كانت الأفكار الليبرالية التي دعمت الغرب الجيوسياسي في الأساس أفكاراً عالمية؛ فيما ترتكز الأفكار القومية التي تعلي شأن الغرب الحضاري على مبدأ الدفاع عن الحدود ومشاعر الخوف من الآخرين.
إضافة إلى تهديدها للمبادئ الليبرالية ضمن النطاق الداخلي المحلي، ويرجح أن تسهم هذه التوجهات الفكرية في تسريع قيام نظام دولي تعددي بسيط وغير ليبرالي، تشكله، وتهيمن عليه حتى، قوى عظمى استبدادية.
إن أفول الغرب سيتيح بالتأكيد فرصة لقوى متوسطة بناءة كي تنشئ شبكات تعاون دولية جديدة مفصلة على قياس القرن الـ21. إلا أن هذا السقوط سيبشر أيضاً بعالم أقل سلماً وأدنى تنسيقاً وتعاوناً من العالم الذي أسهم الغرب في تشكيله.
إمبراطورية يحلو الانضواء فيها
خلال الحرب الباردة، انبثق الغرب طرفاً جيوسياسياً متماسكاً وموحداً، فشكل كتلة بلدان ديمقراطية (في الغالب) بمواجهة الاتحاد السوفياتي والمتحلقين حوله – "الكتلة الشرقية" وفق التعبير الشائع – ومتمايزة عن بلدان "الجنوب العالمي" – المناطق المستعمَرة سابقاً التي استعرت فيها المنافسات الدولية بين الشرق والغرب على نحو دموي.
ولم يمثل هذا النسق الثنائي القطب نموذج النظام الدولي الذي تصورته الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، حين صاغ المخططون الأميركيون لعالم ما بعد الحرب مسودات نظام دولي مفتوح يستند إلى أسس العضوية الدولية، ومبادئ تعددية الأطراف والأطر، والتفهم المتبادل والتعاون بين القوى العظمى، تحديداً وفق المثال الذي جسدته الأمم المتحدة المنشأة حديثاً (بعد الحرب).
إلا أن المواجهة مع الاتحاد السوفياتي أفشلت تلك الخطط المراد تنفيذها، وقادت الولايات المتحدة إلى تبني سياسة الاحتواء. إذ لو قام بالفعل "عالمان بدل عالم واحد"، كما استخلص الدبلوماسي الأميركي تشارلز بولين عام 1947 حين فرضت موسكو سيطرتها الكاملة على أوروبا الشرقية، لن يبقى خيار للولايات المتحدة إلا توحيد "العالم غير السوفياتي سياسياً واقتصادياً، وفي النهاية، عسكرياً".
وهكذا أفضى نهج احتواء الشيوعية إلى ولادة غرب أكثر تبلوراً في المعنى الجيوسياسي – مقابل فكرة الغرب الحضاري بسماتها المبهمة – وسرعان ما تجسد ذاك الغرب الجيوسياسي بمؤسسات جديدة مثل حلف شمال الأطلسي، وأوروبا الموحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقد غدا الغرب نظاماً ضمن نظام، ومنتدى لديمقراطيات السوق المترابطة بنظام دولي أكثر شمولاً تكونه منظمات دولية كبيرة ومتعددة العضوية، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهيئة "الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة".
وتطور هذا النظام مع مرور الوقت إلى صيغة داخلية تشمل مجموعة أكثر تنوعاً من الدول المتبنية نظام ديمقراطية السوق، أبرزها اليابان، التي لم تكن أبداً دولاً غربية بالمعنى الثقافي التقليدي، بل دول متبنية المبادئ الليبرالية السياسية والاقتصادية.
وحين يشير بعض المحللين اليوم إلى "الشمال العالمي" فهو يشير بالحقيقة إلى تلك الصيغة الداخلية.
لقد شكل الالتزام المشترك بالديمقراطية، فضلاً عن الرأسمالية، ما يشبه الأساس بالنسبة إلى التضامن الغربي. وجاءت مقدمة "معاهدة واشنطن" (عام 1949)، التي أسست حلف شمال الأطلسي،
لتتعهد بأن يقوم أعضاء الحلف المذكور بـ"حماية حرية شعوبهم وتراثها وحضارتها المشتركة القائمة على مبادئ الديمقراطية، وصون الحرية الفردية وحكم القانون".
وقد يستخف المتهكمون الشكاكون بتلك اللغة ويعدونها تنميقاً عاطفياً خارجياً، لكنهم مخطئون.
فتلك الالتزامات أثرت فعلياً في تصرفات الحلفاء، مبلورة كيفية فهم الدول الغربية مصالحها الوطنية وطريقة تعاطيها مع بعضها بعضاً، ومشكلة أسلوب تسويتها النزاعات العرضية في ما بينها، حتى بدت، مثلاً، فكرة الحرب بين أعضاء تلك الصيغة الداخلية فكرة مستحيلة.
ومن المؤكد أن الدول المنضوية في هذه الكتلة المتماسكة، التي هي أعضاء في الصيغة الداخلية المذكورة، كانت، في كثير من الأحيان، تقدر أهمية الديمقراطية في أوساط كتلتها الغربية أكثر مما كانت تقدرها عند بلدان العالم النامي الخارج من الاستعمار، خصوصاً البلدان التي تميل الجماهير فيها نحو اليسار.
وقد كان بوسع الحلفاء الغربيين، فوق المثل المشتركة التي تجمعهم، الشعور بالارتياح إزاء أسلوب القيادة التوافقية المعتمد من واشنطن، الذي خفف من واقع الهيمنة الأميركية.
وأيد الرئيس دوايت أيزنهاور بدوره ذاك التوجه في خطاب تنصيبه الأول بيناير (كانون الثاني) 1953، عبر لغة تبدو اليوم كأنها من حقبة آفلة، حين قال: "لمواجهة تحديات زمننا، وضع القدر أمام بلادنا مسؤولية قيادة العالم الحر.
لذا من المناسب التأكيد مرة أخرى لأصدقائنا أننا، نحن الأميركيين، وفي إطار اضطلاعنا بهذه المهمة، ندرك ونلحظ الفارق بين قيادة العالم والإمبريالية، بين الحزم والعدوانية، بين الهدف المدروس بدقة وردود الفعل المتقطعة إزاء ما يستدعي حالات الطوارئ".
وذاك جعل الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ إمبراطوري ضمن الغرب، إذ شكلت وفق تعبير المؤرخ غيير لوندستاد، "إمبراطورية يحلو الانضواء فيها".
العالم الغربي يتفكك
وقد بقي الغرب مفهوماً وكياناً جيوسياسياً ذا معنى حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك كتلته الشرقية. إذ كان من الطبيعي لذاك المنتدى الذي تشكل في مواجهة الاتحاد السوفياتي أن يفقد تعريفه ومعناه إثر زوال هذا الخصم المنافس.
بيد أن تلك الكتلة المنسجمة، على الأقل خلال التسعينيات، لم تتفرق في مجموعات متناحرة ومتنافسة أو تنتج مشاريع هدفها تقويض الأحادية الأميركية. لا بل كان هناك في الواقع توقعات واسعة النطاق، ولو بدت ساذجة، ترى أن كتلة دول ديمقراطيات السوق – "الغرب" بعبارة أخرى – ستحقق توسعاً هائلاً وتضم مزيداً من البلدان في العالم،
وذلك تزامناً مع قيام دول أخرى بتبني القيم الليبرالية الكونية والهندسة المعيارية للنظام الدولي المفتوح المستند إلى القواعد.
لكن تلك الآمال لم تتحقق. وبدل مضي النموذج الغربي نحو مزيد من التعولم، شهد العالم صعود بقية القوى، أو القوى الأخرى (غير الغربية)، التي هي مجموعة متنوعة من القوى الكبرى والإقليمية العازمة ليس فقط على إعلاء صوتها ضمن المؤسسات الدولية، بل أيضاً، في بعض الحالات، على تحدي المبادئ التنظيمية لتلك المؤسسات.
وقد بدأ الغرب تدريجاً وبهدوء يأخذ بعداً (أو معنى) حضارياً أكثر، وتلك عملية سرعتها هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) وما تلاها من "حرب على الإرهاب"، وأزمة الهجرة الجماعية، والغضب القومي اللاحق خلال العقد الأول من القرن الـ21.
على رغم هذه التحديات، بقي التضامن الغربي نفسه متيناً، وحتى بعد ولاية ترمب الأولى والمضطربة.
فعادت كتلة ديمقراطيات نظام السوق المتقدمة إلى الانتعاش خلال ولاية الرئيس جو بايدن، معززة ليس فقط بالضمانات الأمنية الأميركية بل أيضاً بالتزام واشنطن الأوسع بالمبادئ الليبرالية وفكرة النظام الدولي المفتوح المستند إلى القواعد.
واستمرت الحكومات الغربية عموماً باتباع قيادة واشنطن، لأنها رأت في الولايات المتحدة استثماراً ثابتاً، ووثقت بأن الأخيرة لو ساءت الأمور، ستسارع إلى دعمها ومؤازرتها ومد يد العون لها.
ومثل ذلك اتفاقاً قائماً على الثقة، يرتكز على الالتزام بالقيم والقواعد المشتركة، والالتزامات المتبادلة.
بيت منقسم على نفسه
بعد مرور ثمانية أشهر على بداية ولاية ترمب الثانية، انهار ما تبقى من الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها. في قمتي مجموعة السبع وحلف الناتو في يونيو (حزيران)، بذل الشركاء الغربيون جهوداً لاحتواء الخلافات المتنامية، بما في ذلك فرض ترمب رسوماً جمركية ثقيلة، وضغوطه على الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي، وضربته الأحادية على منشآت إيران النووية.
وبينما انحنوا له وأثنوا على "جرأته"، تجاهلوا حقيقة أن أسلوبه العدواني يمثل انحرافاً جذرياً عن النهج التشاوري الذي ميّز العلاقات الغربية لعقود عن الدبلوماسية التقليدية.
حتى إن أقرب حلفاء الولايات المتحدة اليوم ما عادوا قادرين على أخذ ضمانات واشنطن الأمنية كأمر محسوم ومسلم به. وقد قادت مبالغات الرئيس ترمب وتقلباته بلداناً أوروبية عدة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي – وهذا الأمر بالتأكيد له حصيلة إيجابية ولا يتعارض بالجوهر مع فكرة الغرب الجيوسياسي المتحد.
بيد أن ترمب قام أيضاً بتهميش حلفاء واستبعادهم، محيياً بذلك جهوداً أوروبية متعثرة منذ زمن تتمثل بالسعي إلى تحقيق استقلالية إستراتيجية قد تسمح للكتلة (الأوروبية) ترجمة ثقلها عسكرياً وأيضاً سلوك مسار جيوسياسي مستقل.
كذلك يخشى الحلفاء في منطقة آسيا – المحيط الهادئ من أن تقوم الولايات المتحدة فجأة بإلغاء الغطاء الأمني الذي تؤمنه لهم.
إذ فيما يقوم ترمب عبر التعريفات الجمركية الشاملة بضرب نظام التجارة المستند إلى القواعد، فإن حلفاء الولايات المتحدة يقومون من جهتهم بالتحرك لتنويع خياراتهم التجارية والتعاون مع شركاء أكثر موثوقية، ويعيدون في سياق هذه العملية تشكيل النظام التجاري العالمي وهيكلته بطريقة مختلفة.
ويتوافق هذا السلوك الحذر مع المشاعر العامة السائدة. فاستطلاعات الرأي في أوروبا تكشف عن تدهور تأييد الولايات المتحدة وتراجع الثقة بتحالف عبر الأطلسي.
ففي ربيع عام 2025 رأت نسبة لا تتعدى الـ28 في المئة من المستطلعين (الأوروبيين) أن الولايات المتحدة لم تعد "حليفاً موثوقاً إلى حد ما" – وذلك بتراجع من نسبة فاقت الـ75 في المئة قبل عام واحد.
على أن إحدى الخسائر المؤسساتية الناتجة من افتراق ترمب عن الغرب تتمثل بـ"مجموعة الدول السبع" نفسها. إذ إن المجموعة المذكورة منذ بداية تكونها في أعوام السبعينيات مثلت رمزاً للتضامن الغربي وركناً للحوكمة الاقتصادية الدولية، موحدة في صيغتها أهم دول ديمقراطيات السوق المتقدمة، كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم أن كثيرين كتبوا في نعي هذه المجموعة خلال الأزمة المالية العالمية، حين واجهت خطر الاضمحلال لصالح "مجموعة العشرين" (G-20)،
إلا أنها عادت إلى الحياة عام 2014 عندما قام الأعضاء الغربيون في "مجموعة الدول الثماني" آنذاك بطرد روسيا بسبب دعمها حركات الانفصال في شرق أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.
لكن ترمب قام مراراً بانتقاد طرد روسيا ولم يخف مقته لمجموعة السبع – حتى إنه انسحب من قمتها غاضباً عام 2018. ويشير كثير من المراقبين اليوم إلى هذا التكتل الدولي باسم "مجموعة الدول الست زائد واحد".
وهذا الافتراق الأميركي عن "مجموعة السبع" يهدد الدول الأعضاء فيها بالحرمان من أمر تعجز "مجموعة الـ20"، الأكثر تنوعاً، عن تأمينه: نادي المتشابهين فكرياً،
إذ يمكن لديمقراطيات السوق الرائدة في العالم ضمن هذا النادي، أو المنتدى، تنسيق مواقفها بما ينسجم مع التزامها بعالم مفتوح يحترم القواعد ويتبنى المبادئ الليبرالية المشتركة.
لقد بدأت القوى الغربية المتوسطة، العالقة اليوم بين أحادية ترمب ونظرة التوجس والحذر تجاه الصين، باستكشاف شراكات جديدة ومرنة مع قوى متوسطة صاعدة في العالم النامي، وذاك يمثل جزءاً من توجه أوسع نحو نظام دولي يتسم بـ"الانحياز المتعدد"،
إذ تسعى الدول ضمنه إلى اعتماد أقصى قدر من المرونة في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، بدل الانحياز الثابت إلى قوى عظمى أو كتل محددة.
وهذا في الواقع ما يحصل اليوم بالضبط، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كل على حدة، إقامة روابط تجارية أمتن وعلاقات دبلوماسية أوثق مع دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
أفول الغرب
خلال ولايته الرئاسية الأولى حين كان مقيداً بأنصار المؤسسات، تناول ترمب مفهوم "الغرب" بين الحين والآخر. وأعلن الرئيس الأميركي بكلام أدلى به في وارسو بيوليو (تموز) 2017، أن "المسألة الأساسية في زمننا الراهن تتمثل بما إذا كان الغرب لديه إرادة البقاء".
وكان واضحاً أن ترمب نظراً إلى الأفعال التي يقوم بها وهو في منصب الرئاسة، والمتضمنة تقارباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من الحكام الاستبداديين،
لا يفهم "الغرب" ككيان جيوسياسي ولدته الحرب الباردة وعززته احتمالات الأخطار المشتركة ورغبة الالتزام بالقيم الليبرالية، بل من منطلق دلالته الأقدم، القومية – العرقية،
ووفق المفهوم الأكثر غموضاً الذي يرى الغرب حضارة مشتركة لا تقوم على مبادئ سياسية ليبرالية، بل تنبثق من جذور جغرافية وتاريخية مترابطة.
يعيش الغرب الآن حال تفرق وتفكك، فيما يتحول معناه من فكرة تضامن جيوسياسي أيديولوجي إلى مفهوم ينحو أكثر نحو المعنى الحضاري، خصوصاً في الولايات المتحدة، فيما تتآكل،
بموازاة ذلك، الثقة بحلف عبر الأطلسي وغيره من الأحلاف. ومع صعود انقسامات الغرب الداخلية إلى الواجهة اليوم وبروزها علناً، بات من المشروع التساؤل عن مدى تماسك هذا المفهوم وجدواه.
والمفارقة هنا أن منتقدي مفهوم "الجنوب العالمي" في الولايات المتحدة وأوروبا كثيراً ما اعتبروه تصنيفاً فضفاضاً لا يمكن تطبيقه على أكثر من 100 دولة نامية وما بعد استعمارية، تختلف في تاريخها وثقافتها ومؤسساتها السياسية واقتصاداتها وطموحاتها الإقليمية. فكيف يمكن لمصطلح واحد أن يفسر كل هذا التنوع؟
السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان تصنيف "الغرب"، الجيوسياسي هذا، يستحق تشكيكاً مماثلاً.
إذ إن التضامن الإستراتيجي والأيديولوجي بين الولايات المتحدة وباقي ديمقراطيات السوق الكبرى، الذي كان في يوم من الأيام أمراً مسلماً به، تآكل الآن.
على أن تفكك الغرب هذا لم يأت بفعل ترمب وحده. كما أنه ليس مجرد انقسام بسيط وعابر، حيث تسلك الولايات المتحدة وجهة محددة فيما يذهب شركاؤها السابقون في وجهة أخرى مختلفة.
بل إن الناخبين في معظم الديمقراطيات المتقدمة باتوا اليوم منقسمين في مشهد استقطاب متزايد، مما يؤدي إلى تضاؤل تأييد الوسط السياسي وانحسار شرعية الأحزاب والحكومات المعتدلة.
هذا ويتربص التقدميون من سكان المدن والقوميون المحافظون ببعضهم بعضاً، وتشمل خلافاتهم الحادة معنى "الغرب" نفسه.
وقد بلغت تلك التوترات ذروتها وبرزت للعلن خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في فبراير (شباط) الماضي.
ففي هذا المؤتمر أثار نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، غضب جمهور جله من الأوروبيين عندما رأى أن القيود المتمثلة بثقافة تيار "اليقظة" على حرية تعبير أحزاب أقصى اليمين في القارة الأوروبية تشكل خطراً على حرية الغرب وأمنه أكبر من الخطر الذي يمثله اجتياح روسيا أوكرانيا.
وقد كمن في جوهر مقاربة فانس النقدية تلك مفهوم للغرب قائم على "الدم والتراب" – كمفهوم فانس نفسه للأمة الأميركية – وذاك مفهوم لا ينبع من الإخلاص لمبادئ التنوير (عصر الأنوار) السياسية المشتركة، بل من هوية حضارية وإحساس عضوي بالمكان.
طوال عقود من الزمن، قامت ديمقراطيات السوق المتقدمة في العالم بالوقوف معاً في الأزمات والدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من القيم الليبرالية، وسعت عموماً إلى مواءمة سياساتها وتنسيقها ضمن المنتديات الصغيرة،
كذلك ضمن المنظمات الدولية الأكثر شمولاً، كالأمم المتحدة ومؤسسات "بريتون وودز". إن زوال الغرب كوحدة جيوسياسية مستقرة وموثوقة سيؤدي إلى زيادة عمل الولايات المتحدة وشركائها السابقين لأهداف متعارضة، وهم سيجدون أنفسم في خضم السجالات (الدولية) على طرفي نقيض.
وهذا الأمر لا يعد مجرد نتيجة حتمية لتراجع الهيمنة الأميركية ضمن النظام الدولي. إذ بوسع المرء مثلاً أن يتصور عملية إعادة تفاوض تدرجية على مسألتي القيادة وتقاسم الأعباء ضمن التحالف الغربي، وإلقاء مسؤولية أكبر على الحلفاء للدفاع المشترك والجماعي.
إلا أن تخلي واشنطن عن المسؤوليات الدولية وعن الاهتمام بالمعايير الليبرالية ووضع الأجندات يؤدي إلى تباعد وافتراق القيم، ويهدد وحدة الموقف بين الدول الغربية، وذاك من شأنه الإطاحة كلياً بتضامن الغرب الجيوسياسي.
وهذا الشرخ عميق جداً لأنه يصيب النواة الداخلية للنظام العالمي السائد منذ أربعينيات القرن الـ20.
كذلك فإنه يخلق خياراً (جديداً) للقوى الوسطى في العالم، ليس فقط في الغرب، بل أيضاً ضمن الاقتصادات الصاعدة التي ليس لديها رغبة في استبدال بهيمنة الولايات المتحدة هيمنة صينية.
فالقوى الناشئة والصاعدة المذكورة كثيراً ما اشتكت من استبعادها من المنتديات الدولية الكبرى.
وهذه اللحظة المتغيرة الراهنة توفر فرصة لدول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا للتعاون مع شركاء من دول ديمقراطيات السوق المتقدمة، مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا، تلك الدول الباحثة ربما عن شركاء جدد في حقبة ما بعد الغرب.
إلا أن تفاصيل وفوضى الترتيبات التي قد تبرز في سياق استبدال بأسس النظام السابق البائدة (قواعد جديدة)، لن يكون بوسعها أن تسمح بتكرار الثمرة العظمى لذاك النظام.
فالغرب، النسق الداخلي الذي نشأ من قسوة اختبار الحرب الباردة، كان مجالاً للسلام. ودول الغرب ما كانت أبداً لتقاتل بعضها بعضاً. أما اليوم فإن ما سيتركه ذاك الغرب وراءه هو عالم أكثر عرضة للشكوك والريبة والعداءات والنزاعات.
ستيوارت باتريك باحث بارز ومدير "برنامج النظام العالمي والمؤسسات الدولية" في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. مؤلف كتاب "حروب السيادة: مصالحة أميركا مع العالم" The Sovereignty Wars: Reconciling America With the World.
مترجم عن "فورين أفيرز"، 18 سبتمبر (أيلول)، 2025