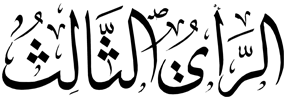الأجهزة الكهربائية... "خردة" بوظائف مختلفة في منازل اليمنيين
تحوّلت الكهرباء في اليمن إلى ذاكرة جماعية يستعيدها اليمنيون بحنين كلما نظروا إلى أجهزة مهجورة تبدلت مهامها، وصارت شاهدةً على زمنٍ كان الضوء فيه من أبسط البديهيات.
لم تعد الأجهزة الكهربائية في منازل اليمنيين تعبّر عن الرفاهية أو حتى عن الحد الأدنى من متطلبات العصر،
بل تحولت مع مرور عقد من الزمن على انقطاع التيار الكهربائي الشامل، إلى "توابيت معدنية" و"خردة" صامتة تسكن الزوايا، وكأنها قطع أثرية معروضة في متحف باعتبارها شواهد حيّة على زمن ما قبل الظلام.
في اليمن، لم تنقطع الكهرباء فحسب، بل انقطعت معها طقوس يومية، وتغيّرت هندسة المنازل من الداخل، ليتكيف الإنسان مع واقع بدائي فُرض عليه بقوة الحرب التي قضت على الحياة العامة، قبل أن تقضي على حياة عشرات الآلاف من البشر الذين راحوا ضحاياها.
داخل مطبخ أم أسامة في مدينة صنعاء، تقف الثلاجة في ركنها المعتاد داخل المطبخ، لكنها لم تعد تُصدر ذلك الطنين المألوف الناتج عن وصول التيار الكهربائي إليها.
تفتح أم أسامة باب الثلاجة لتكشف عن رزمة من القدور والأواني المنزلية، التي حلّت مكان اللحوم والفواكه والخضروات، فالثلاجة التي كانت تحفظ الطعام، صارت تحفظ أواني الطعام الفارغة.
تقول "منذ بداية الحرب وانقطاع الكهرباء، تحوّلت الثلاجة إلى خزانة إضافية داخل المطبخ. حين انقطعت الكهرباء كنا ننتظر عودتها، وكنا نظن أن انقطاعها لن يدوم سوى أسابيع على الأكثر، لكن مع مرور السنوات، استسلمنا لواقع مرّ".
وتضيف بحسرة: "صارت الثلاجة اليوم مخصصة للأواني، أما جاراتي فإحداهنّ وضعتها في غرفة الأطفال خزانة للملابس، وأخرى حوّلتها إلى 'جزامة' (خزانة للأحذية) عند مدخل الشقة".
هذا التحول الوظيفي للأجهزة ليس مجرد تدبير منزلي من قبل ربّات المنازل اليمنيات، بل هو انعكاس لعمق المأساة التي حلت باليمنيين وبالبلد في حصيلة مؤلمة لحرب دمرت كل شيء.
فقد أدّى غياب الثلاجة بمهامها المعهودة داخل منزل الأسرة اليمنية إلى تغيير النمط الغذائي لليمنيين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، إذ لا يمكن حفظ بقايا الطعام، ما يضطرّ الأسر إلى طهي وجبات صغيرة يومية، وهو أمر مكلف في ظل أزمة الغاز المنزلي.
كما أن غياب التبريد جعل شراء اللحوم أو الخضروات بكميات كبيرة مخاطرة غير محسوبة، ما ضاعف كلفة المعيشة اليومية.
ولا يتوقف الأثر الناتج عن غياب الثلاجات عند الغذاء، بل يمتد إلى الدواء؛ فالأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة محددة، مثل الإنسولين وبعض اللقاحات والمحاليل، أصبحت أكثر كلفة وأصعب توفراً.
وتلجأ الصيدليات والمستشفيات إلى مولدات تعمل بالديزل أو أنظمة تبريد بديلة، ما يضاعف كلفة التشغيل، وينعكس مباشرة على أسعار الأدوية والخدمات الصحية في بلد يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة شديدة.
يعكس هذا التحوّل القسري في وظيفة المقتنيات المنزلية قدرة اليمنيّين على ابتكار استخداماتهم اليومية، في محاولة للتكيّف مع غياب الكهرباء؛
فبدلاً من رمي الأجهزة أو بيعها، جرى تطويعها لتؤدي أدواراً بديلة، عوض الاعتراف بأنها باتت عديمة الفائدة، ما يخفف من المشاعر السلبية.
أما التلفزيون، فقد كان قبل سنوات نقطة التقاء أفراد العائلة اليمنية عند ساعات المساء. يجتمعون حول شاشة واحدة، وضوء خافت، وسهرات رمضانية أو متابعة المسلسلات والنشرات الإخبارية.
اليوم، صار التلفزيون في كثير من المنازل قطعة أثاث مهجورة، مُغطّى بطبقة من الغبار. لم يعد يجمع أحداً، ولم يعد يخلق تلك اللحظة الجماعية التي كانت تمنح البيوت دفئها.
تقول كاتبة، وهي ربّة منزل في الخمسين من عمرها، "كنا نجتمع مساء كل يوم في غرفة الجلوس، والكل ينظر إلى شاشة واحدة نشاهد من خلالها مسلسلاً أو برنامجاً ترفيهياً، بينما نتكلم ونتناقش في كل شيء تقريباً.
اليوم تغير الوضع تماماً، كل واحد منا مُنزوٍ في ركن، يتفحص هاتفه المحمول الذي يشحنه عبر لوح شمسي صغير، حتى أننا لا نتحدث معاً إلا للضرورة".
وتتابع: "أشاهد المسلسلات التلفزيونية عبر منصة يوتيوب، لكنني لا أستمتع بها، خصوصاً أن الشاشة الصغيرة لا تمنحك شعور الدفء والتعلق بمتابعة الحلقات، والضوء الخافت في الغرفة يجعلنا بمثابة أشباح. أفتقدُ تلك اللمّة التي كانت الكهرباء محرّكها الأساسي".
الغسالة أيضاً تحولت لمجرد وعاء لنقع الملابس قبل غسلها يدوياً، أو لحفظ الملابس المتّسخة. تصف ربّات المنازل هذا الوضع بأنه "انتكاسة صحية وجسدية".
الغسيل اليدوي لا يستهلك جهداً بدنياً مضاعفاً فحسب، بل يستهلك كميات أكبر من المياه التي يعاني اليمنيون أصلاً في الحصول عليها.
وبسبب غياب المجففات الكهربائية، تعتمد الأسر كلياً على أشعة الشمس، ما يجعل تجفيف الملابس عملية تستغرق يوماً كاملاً أو أكثر، مع ما يصاحب ذلك من خشونة في ملمس الثياب وتلفها بسرعة.
وتقول أم يمان إنّ الغسيل باليد متعب، ويأخذ ساعات طويلة، ومع ذلك تحتاج الملابس يوماً أو يومين حتى تجف، وهذا يؤثر حتى على جودتها. كما أن الغسيل اليدوي يعني استهلاك كميات أكبر من المياه، علماً أننا نجلبها من البئر، ويستغرق نقلها قرابة نصف ساعة".
أما في الشتاء، فقد أصبح الحمّام الدافئ "ترفاً مُكلفاً" مع انقطاع السخانات الكهربائية. وقد لجأت الأسر في الأرياف وبعض أطراف المدن إلى غلي الماء باستخدام الغاز.
ومع ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وانعدامه، لجأت معظم الأسر إلى الحطب لتسخين المياه، ما زاد معاناة النساء والأطفال في جمع الأخشاب وتصاعد الأدخنة الملوّثة داخل المنازل.
لم تعد الكهرباء مجرد خدمة غائبة، بل تحوّلت إلى ذاكرة جماعية يستعيدها اليمنيون بحنينٍ كلما نظروا إلى أجهزة مهجورة تملأ بيوتهم، شاهدةً على زمنٍ كان الضوء فيه أمراً عادياً لا يُفكَّر فيه كثيراً.
لم تكن الكهرباء في اليمن بخير قبل العام 2015، لكن الحرب كانت بمثابة الضربة القاضية.
ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه (صنعاء وعدن)، كانت قدرة التوليد قبل الحرب تصل إلى نحو 1.500 ميغاوات، بينما كان الاحتياج الفعلي يتجاوز 3.000 ميغاوات.
وبحسب تقارير البنك الدولي، حتى عام 2010 لم يكن سوى 40% من سكان اليمن يحصلون على الكهرباء،
وفق ما أفادت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بتاريخ 18 مارس/ آذار 2025.
وكانت المنصة ذاتها قد نبّهت عام 2024 إلى أن ملف الكهرباء في اليمن يشكل أزمة حقيقية، في ظل استمرار انقطاعات التيار التي تصل لما يزيد على 16 ساعة يومياً.
ومع اندلاع الحرب، تعرضت محطة مأرب الغازية (المزوِّد الرئيسي للبلاد) لسلسلة من الاستهدافات والتعطيل، بالإضافة إلى تدمير مئات المحوّلات وخطوط النقل ذات الضغط العالي.
وفي السنوات الأخيرة، قدّرت بعض التقارير المحلية أن الخسائر المباشرة في قطاع الكهرباء تجاوزت مليارات الدولارات نتيجة القصف المباشر أو التوقف التام عن الصيانة.
وتشتد المأساة في المدن الساحلية مثل الحديدة وعدن والمكلا. هناك، لا تعني الكهرباء الإضاءة فحسب، بل "البقاء على قيد الحياة". ففي صيف تتجاوز فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية، تتحوّل المنازل إلى أفران.
وقد سجّلت المستشفيات في عدن والحديدة حالات وفاة عديدة بين كبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة نتيجة موجات الحر وغياب التكييف.
الاحتياج في عدن وحدها يتجاوز 600 ميغاوات، بينما ما يتمّ توليده في أفضل الأحوال لا يصل إلى نصف هذه القيمة، مع انقطاعات تصل إلى 15 ساعة يومياً، بحسب متابعين.
في مواجهة هذا الواقع، برزت الطاقة الشمسية حلاً بديلاً، لكنها ليست مُتاحة للجميع. فالمنظومات الشمسية، رغم انتشارها، تظل حكراً على الطبقتين المتوسطة والغنية، وبحدود غير كافية.
وتكتفي معظم الأسر المقتدرة بعض الشيء بمنظومة بسيطة من أجل الإضاءة وشحن الهواتف، وأحياناً تشغيل التلفزيون لساعات محدودة، من دون القدرة على تشغيل الأجهزة الثقيلة مثل الثلاجات أو الغسالات أو المكيّفات.
أما غالبية الأسر اليمنية فتعجز عن شراء هذه المنظومات بسبب كلفتها المرتفعة مقارنةً بمداخيل شبه معدومة، ما يعمّق الفجوة بين فئات المجتمع.
بالمقابل، انتشرت "الكهرباء التجارية" (المولدات الخاصة) في المدن الكبرى، لكن أسعارها مرتفعة جداً، ما جعل الاشتراك فيها يقتصر على أصحاب المحلات التجارية أو الأسر الميسورة جداً، وبسقف استهلاك محدود لا يسمح بتشغيل الأجهزة الثقيلة.
ويقول الباحث الاجتماعي رداد المنصوري، "إنّ غياب الضوء دفع الناس إلى العزلة الفردية خلف شاشات الهواتف، ما أضعف الروابط الأسرية.
كما أن العودة للوسائل البدائية في العيش زادت من الضغوط النفسية على ربّ الأسرة الذي يشعر بالعجز، وعلى الأم التي استنزفتها الأعمال اليدوية الشاقة، ما خلق جيلاً ينمو في الظلام، ليس ظلام المكان فحسب، بل ظلام الفرص والمستقبل".
فخر العزب
صحافي يمني