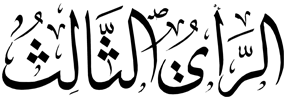تداعيات أمطار اليمن... سلطة بلا خيال ودولة بلا رؤية
في كل مرة تهطل الأمطار الغزيرة على عدن أو غيرها من المدن اليمنية، يتجدد المشهد ذاته منذ سنوات عدة فائتة على نحو صادم ومحبط: شوارع غارقة، بيوت متضررة، ومؤسسات عاجزة عن مواجهة ظرف طبيعي كان يفترض أن يكون عابراً.
هنا لا تُختبر قدرة المدينة على الاحتمال فحسب، بل يُختبر في اعتقادي معنى الدولة نفسها، أي قدرتها على حماية مواطنيها وصون حياتهم في مواجهة الطوارئ.
فما كان ينبغي أن يكون نعمة للطبيعة يتحول إلى لعنة يومية تكشف حجم الضعف الذي يسكن البنية التحتية، وتفضح غياب مؤسسات فاعلة قادرة على التعامل مع التحديات كما ينبغي.
لكن المشكلة في تصوري لا تكمن في الكارثة بحد ذاتها، بل في غياب أي استجابة جادة تعيد النظر في أسبابها وتمنع تكرارها.
هنا يتضح أن المأزق أكبر من مجرد إدارة أزمة آنية، فهو يرتبط بعجز الدولة عن الإنصات للأفكار الخلاقة وتبني المبادرات الوطنية التي يمكن أن تصنع فارقاً.
بهذا المعنى، يغدو المطر أكثر من حدث طبيعي، إنه رمز مستمر لغياب الرؤية، ودليل على أزمة أعمق يعيشها اليمن: أزمة دولة لا تملك القدرة على أن تكون دولة بالمعنى الحقيقي.
دعوني أدخل مباشرة في صلب الموضوع وأكتب: لم يعد مشهد عدن وهي تغرق في مياه الأمطار حدثاً عادياً أو عابراً يثير ضجيجاً وقتيّاً على منصات التواصل الاجتماعي، بل أصبح في تصوري علامة دالة على مأزق عميق يعيشه اليمن.
كلما هطلت أمطار غزيرة في العاصمة الموقتة أو في غيرها من المدن، سرعان ما يتكشف عجز مؤسسات الدولة عن التعامل مع ظرف طبيعي شديد الصعوبة، ليس بسبب استثنائيته، بل بفعل محدودية قدراتها وضعف بنيتها التحتية التي استنزفتها عقود من الإهمال؛ ولعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدن أوائل التسعينيات وتداعياتها التي نالت من المدينة ما زالت محفورة في الذاكرة.
وهنا تتجلى المعضلة: الطبيعة تكشف هشاشتنا، فيما السلطات المتعاقبة تنأى بنفسها عن مواجهة الأسئلة الكبرى المرتبطة بغياب المؤسسات الفاعلة.
ولاحظوا معي على سبيل المثال متى هطلت الأمطار بغزارة هذه المرة على مديريات عدن، ومتى اجتمعت الحكومة للوقوف أمام ما حدث لتتخذ ما اتخذته من قرارات.
لقد اقتضى الأمر بضعة أيام لتعقد اجتماعها، وأبرز ما خرج به اجتماعها يوم الإثنين 25 أغسطس (آب) لم يكن سوى الموافقة على إنشاء "مركز طوارئ" لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
إن هذا النوع من القرارات المتأخرة، الذي يبدو أقرب إلى رد فعل منه إلى استجابة استراتيجية، يكشف بوضوح أن السلطة لا تزال أسيرة معالجات لا ترتقي إلى مستوى الحاجة ولا تعبر عن وعي بحجم المأساة (ملاحظة: بعض القرارات كانت مهمة وتنسجم مع الروح المتوثبة والحماسة اللافتة لرئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك).
إن الأدهى من هذا الانكشاف لا يكمن في عجز الدولة عن إدارة ظرف طارئ فحسب، بل في غياب أي اهتمام قيادي جاد من أعلى هرم في السلطة بالأفكار الخلاقة التي كان يمكن أن تشكل منطلقاً لبناء أو لإعادة بناء مؤسسات قادرة على القيام بمهامها كما يجب.
يتعاقب على السلطة، منذ إطاحة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، رئيسان وحكومات متعددة واحدة تلو أخرى، ومع ذلك يبقى المشهد على حاله،
وكأن دورة الفشل قد تحولت إلى قانون داخلي ملزم. الأسوأ من ذلك أن هذا الركود لا يوحي بأية إرهاصات تشير ولو بأي قدر إلى مستقبل أفضل؛ بل يرسخ قناعة بأن الغد نسخة أخرى من اليوم، وأن إدارة الأزمات مؤجلة حتى إشعار غير معلوم.
في عام 2019، ومن منطلق وطني بحت، سعيت إلى الإسهام في تفكيك هذه المعضلة عبر مقترح عملي، نشرته وقتئذ وسائل إعلام محلية، لإنشاء هيئة وطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مستلهماً تجارب ناجحة في إحدى دول المنطقة.
كان الهدف أن تتشكل مؤسسة متخصصة، تعمل وفق رؤية واضحة، وتضمن التنسيق بين الجهات المعنية من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
غير أن هذا المقترح، على بساطته وضرورته، قوبل بالتجاهل، كما لو أن ما يمسّ حياة الناس لا يدخل ضمن أولويات الحكم. وفي هذا التجاهل ما يكفي ليكشف مأساة أعمق: سلطة بلا خيال، ودولة بلا رؤية.
السؤال المنطقي ببعده الفلسفي الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا يعني استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه؟ إذا كانت كل أزمة طبيعية تنتهي بانكشاف جديد، ومع ذلك لا يتولد من هذا الانكشاف أي فعل جاد-
يستند إلى رؤية- يعيد تصحيح المسار، فإن ما يحدث ليس مجرد إهمال، بل هو إعادة إنتاج لعجز ممنهج يقتل في المجتمع أية إمكانية للتطور.
إن استمرار الحال على هذا النحو يحول الكارثة من حدث عرضي إلى بنية قائمة، أي أن الطوارئ لم تعد استثناءً بل أصبحت جزءاً من القاعدة.
وماذا يعني تجاهل المبادرات الخلاقة؟ على مستوى الوعي العام، هو إفراغ لفكرة المواطنة من مضمونها، وإرسال رسالة صامتة إلى الكفاءات الوطنية بأن حضورها لا قيمة له، وأن المعرفة مهما كانت عميقة لن تجد طريقها إلى الفعل.
هنا يصبح العجز الرسمي في اعتقادي أكثر خطورة من العجز المادي؛ لأنه يضرب في جوهر علاقة المواطن بدولته، ويحوّل الإبداع إلى صرخة في الفراغ.
وهذا الوضع لا يضر فقط بفاعلية المؤسسات، بل يخلق جرحاً عميقاً في وعي النخب، يدفعها إما إلى الانكفاء أو إلى البحث عن فضاء آخر خارج حدود الوطن.
المدن التي تغرق في مياه الأمطار ليست مجرد مساحات عمرانية متعبة، بل هي كما أتصور انعكاس لصورة الدولة كما هي: غارقة في العجز، مفتقدة القدرة على التكيف مع متغيرات الطبيعة ومع تحديات العصر.
وما لم يتم الاعتراف بأن بناء مؤسسات فاعلة هو شرط الوجود السياسي والإنساني لأية دولة، فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة بين حدث كارثي واجتماعات لاحقة له، بلا تغيير جوهري ولا استبصار بالمستقبل.
إن الخروج من هذه الدائرة في اعتقادي لا يتحقق بشعارات عابرة أو بمعالجات آنية أو ترقيعية، بل بقرار سياسي شجاع يعيد الاعتبار لفكرة الدولة بوصفها الضامن لحياة الإنسان.
فالسلطة التي تعجز عن حماية مواطنيها من مياه الأمطار لا يمكن أن تكون قادرة على مواجهة تهديدات أكبر تتجاوزها.
وهكذا، يتحول سؤال الكوارث الطبيعية في اليمن إلى سؤال وجودي حول معنى الدولة ذاته: هل نحن إزاء كيان سياسي قادر على إنتاج أدوات البقاء، أم أمام سلطة تعيد إنتاج الفوضى بأدوات رسمية؟
في الواقع إن ما يتبدى من تكرار المشهد في مدينة عدن وغيرها منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990 وإلى يومنا هذا، لا يمكن النظر إليه بوصفه عارضاً طبيعياً فحسب، بل هو انعكاس لمأزق غياب الدولة عن أبسط وظائفها في حماية المجتمع.
ومع أن الأفكار الخلاقة، مثل الدعوة التي تقدمتُ بها عام 2019 لإنشاء هيئة وطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كانت تسعى لفتح أفق مختلف، إلا أن تجاهلها يعكس بجلاء ضمور الإرادة السياسية أمام متطلبات الواقع.
وعليه يصبح السؤال أكبر من مجرد إدارة أزمة: إنه سؤال عن معنى الدولة نفسها، وعن جدوى بقائها من دون مؤسسات فاعلة قادرة على صون حياة الناس.
وفي هذا المعنى، فإنّ إحياء المبادرات الخلاقة في مختلف المجالات ليس ترفاً فكرياً أو استعراض عضلات، بل ضرورة وجودية تحدد ما إذا كان المستقبل سيبقى أسير دائرة العجز ذاتها، أم سينفتح على إمكانية تأسيس دولة تستجيب لنداء الحياة والإنسان معاً.
سامي الكاف
صحافي وكاتب يمني