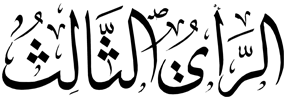هل يمكن أن تصبح الدولة في اليمن موحدة؟
لا تنشأ الدول من مجرد إعلان أو وثيقة، بل من قدرتها على التحول إلى معنى مشترك يسكن ضمير مواطنيها. فحين تغيب هذه القدرة، تصبح الدولة – مهما كانت شعاراتها – مجرد إطار هش تملأ فراغاته بالقوة لا بالقانون، وبالتغلب لا بالشرعية.
وفي السياق اليمني تتجلى هذه الحقيقة بوضوح مؤلم. فبعد 35 عاماً على إعلان الوحدة التي تمت في الـ22 من مايو (أيار) 1990، لا تزال الأسئلة الكبرى مطروحة كما لو أن الزمن لم يتحرك، أو كأن التجربة لم تنتج إلا مزيداً من الانقسام والتشظي.
غير أن المأزق الحقيقي لا يكمن فقط في غياب الدولة، بل في تغييب فكرة الدولة ذاتها، واستبدال شبكات مصالح وسلطات محلية تستمد شرعيتها من السلاح والانتماء الضيق بها، لا من الإرادة العامة أو العقد الاجتماعي.
وبينما ينشغل الخطاب السياسي بمفردات الوحدة والسيادة، ينشطر الواقع إلى جزر منفصلة، لكل منها لغته ورايته ومشروعه الخاص، كأنما اليمن لم تكن يوماً واحدة، وكأنما التجربة الوطنية برمتها كانت محض خطأ تاريخي ينبغي التراجع عنه لا تصحيحه.
هذا الانفصام بين اللغة السياسية والواقع الفعلي لا يعبر عن أزمة في الحكم فحسب، بل عن تصدع عميق في الرؤية الوطنية، وعن غياب مشروع جامع يتسع للاختلاف من دون أن يتفكك، ويستوعب التعدد من دون أن ينفجر.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة لا إلى إعادة طرح سؤال "الوحدة"، بل إلى مساءلة فكرة الدولة ذاتها: ما الذي يجعلها حاضنة حقيقية لليمنيين لا عبئاً فوقهم؟ وكيف يمكن استعادتها بوصفها التزاماً أخلاقياً قبل أن تكون كياناً سياسياً؟
بين الماثل والمثال
في خطابه بمناسبة الذكرى الـ35 لإعلان الوحدة اليمنية قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ما يمكن اعتباره "صيغة معيارية" لبناء اليمن الحديث، قائمة على ثلاثة شروط: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة والإقصاء.
غير أن هذا الخطاب، على رغم صلابته البلاغية وجرأته اللافتة قياساً بخطابات سلفه الرئيس عبدربه منصور هادي، لا يخفي التناقض بين المثال والخطاب من جهة،
والواقع الماثل على الأرض من جهة أخرى خصوصاً حين يكون المتحدث ذاته مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي غير قادرين على رفع علم الجمهورية اليمنية في العاصمة الموقتة عدن، التي يفترض بها أن تكون واجهة الشرعية ومركز سلطتها الانتقالية.
فالواقع السياسي والأمني في عدن، كما في معظم مناطق البلاد، يعكس ما هو أبعد من مجرد اختلال في توزيع القوة أو تناقض في الرؤى، إنه يؤكد – مرة تلو الأخرى – أن الدولة لم تستعد بعد، وأن ما يجري على الأرض ليس أكثر من تقاسم نفوذ هش بين قوى الأمر الواقع يهيمن فيها من يفرض سلطته لا من يملك مشروعية تمثيل الدولة.
وإذا كانت الجماعة الحوثية قد استولت على العاصمة صنعاء بقوة السلاح منذ انقلابها في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يفرض منذ الرابع من مايو (أيار) 2017 واقعاً مشابهاً إلى حد ما في عدن ومحافظات أخرى،
لا يقل خطراً من حيث تقويضه لفكرة الدولة ذاتها، بل ويكرس منطق "الدولة داخل الدولة"، الذي لا ينتمي إلى أي مشروع وطني جامع، وإنما إلى حال انقسام مستدام يعاد تدويره بأدوات سياسية وإعلامية متفاوتة.
ليست المشكلة، كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، في كون الوحدة ممكنة أو مستحيلة، بل في أن كل طرف سياسي يتعامل مع فكرة الوحدة – أو الانفصال – بوصفها قضية هوية مصيرية مغلقة على رؤيته، لا باعتبارها قضية تعايش مشترك ممكنة بالحد الأدنى من الاتفاق السياسي والاجتماعي.
ولذلك يتعمق الخلاف ويتجذر، لا لأنه خلاف حقيقي حول المبادئ، بل لأنه خلاف مغذى بالمزايدات والشعارات، وتحت كل شعار تنمو بذور إقصاء جديدة.
المفارقة المؤلمة أن كل ما هو موقت في اليمن يتحول إلى دائم، وأن كل ما هو تافه يكتسب أهمية زائفة لا تستمد مشروعيتها من فكرة الدولة، بل من منطق الغلبة والسطوة.
أما واقع السنوات الماضية فيشير إلى أنه لا وحدة حقيقية تمت حتى الآن، ولا حدث انفصال.
في الواقع إن الحديث عن "وحدة متكافئة" يبدو أقرب إلى خطاب حالم، ما لم يسبقه فعل جاد لتفكيك أدوات العبث، وإعادة الاعتبار للدولة بوصفها كياناً ضامناً لا طرفاً في الصراع.
من هنا، فإن استعادة الدولة لا يمكن أن تتم بقرار فوقي أو بخطاب احتفائي مهما بدا مُهمَّاً وموزوناً، بل بفعل جذري حقيقي يعيد تعريف السلطة نفسها من كونها غنيمة إلى كونها مسؤولية،
ويؤسس لنظام مدني يتسع للجميع آخذاً في اعتباره أن الجمهورية اليمنية هي نتيجة وحدة تمت بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، نظام لا يسقط في فخ المركزية القديمة، ولا في أوهام صيغ أخرى مفخخة.
دولة كهذه لا تبدأ بشعار الوحدة، بل بنزع أدوات الانقسام، ووقف التطبيع مع سلطات الأمر الواقع، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الكفاءة لا الولاء.
خرائط الضمير
إن السؤال الحقيقي لم يعد: هل يمكن لليمنيين أن يبقوا في دولة واحدة؟
بل: متى يمكن أن تكون هذه الدولة فعلاً حاضنة لهم، لا عبئاً فوقهم؟ ومتى يغدو التنوع مصدر قوة لا أداة للاحتكار والإقصاء؟
وما لم يطرح هذا السؤال في مركز أي مشروع وطني، فإن كل حديث عن وحدة، أو حتى عن استعادة، سيظل حبيس الخطب، وغير قادر على ملامسة أرض الواقع.
بعبارة أخرى أكثر دقة، دعوني أقُل: في لحظات الانهيار الوطني، لا يقاس حضور الدولة بما ترفعه من أعلام أو ما تصدره من خطابات، بل بما تمثله [في وعي مواطنيها] من معنى للعدالة والحماية والاحترام.
فالدولة، كي تكون دولة، لا يكفي أن توجد على الخريطة، بل يجب أن تبنى في الضمائر أولاً، بوصفها مشروعاً جامعاً لا تبتلعه العصبيات، ومسؤولية لا تختزل في المغانم.
وليس السؤال اليوم متى نستعيد الدولة فحسب، بل بأي معنى نريد استعادتها. فدولة لا تضمن العدل ولا تحقق المساواة ولا تصون التعدد ولا تحترم الإنسان، ليست سوى نسخة أخرى من القهر، ولو غلفت نفسها بشعارات "الوحدة" أو "الجمهورية" أو "الانفصال".
لهذا، فإن إعادة تأسيس الدولة لا تبدأ من استعادة السيطرة، بل من استعادة الثقة، ومن شجاعة الاعتراف بأن ما انهار ليس النظام وحد، بل الأسس التي تجعل من الانتماء لهذا الكيان أمراً يستحق التضحية.
سامي الكاف
صحافي وكاتب يمني