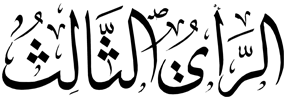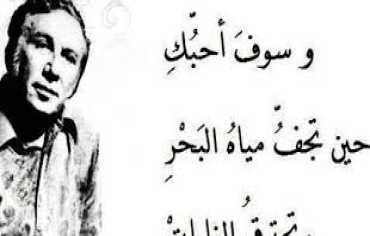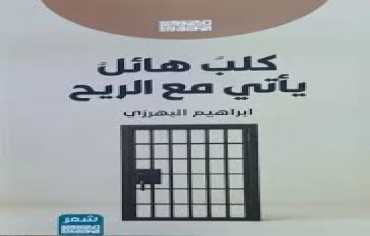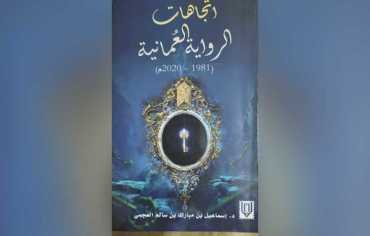آدابُ الغناء في مصر.. تاريخ من محاولات الوصاية
لم تكن المعركة التي اشتعلت في مصر قبل أربع سنوات بين نقيب المهن الموسيقية آنذاك المطرب هاني شاكر، والمطرب الشعبي حسن شاكوش، حول آداب الكلمة المغناة، الأولى من نوعها، بل هي جولة من جولات حرب ممتدة على مدار قرن ونيّف، بين ما يجوز وما لا يجوز أنْ يصدر عن أفواه المغنيات والمغنين.
وإذ انتهت الجولة بتنحّي النقيب عن منصبه، وعودة شاكوش وغيره من مغني الحفلات والمهرجانات إلى "الكلام المباح"، فذلك لأن صلاحيات رجل واحد، وإن كان نقيباً للمهنة،
لا تُملّكه الأدوات اللازمة للوقوف في وجه رغبة جمهور عريض جارفة لسماع نوع من الغناء، يرى نقّاد وقيِّمون ومتذوقون أنه غناء رخيص.
موشحات أم طقاطيق.. سيرة مجتمع
تتتبّع الباحثة المصرية فيروز كراوية في كتابها "كلّ دا كان ليه" (دار ديوان الشرق، 2022)، جذور الغناء في مصر الحديثة، وأشكاله العاميّة والفصيحة، وثماره الحلوة والمُرّة، من مطلع القرن التاسع عشر،
حتى عصر "اللُّعب اللفظية" والفيديو كليب والغناء الإلكتروني، والمنصّات الرقمية التي حررت الغناء من كل سلطة رقابية، رسمية سياسية، أو اجتماعية أخلاقية، أو أدبية نقدية.
وأهم ما يميّز منهجية الكتاب أنها تفسر الظواهر الغنائية من خلال ربطها بالمتغيرات السياسية والتحولات الطبقية، ليبدو صراع الذائقة الفنية الذي شهدته ساحة الغناء، طوال العصر الحديث، بين أداء راقٍ، وأداء مبتذل، سيرة ذاتية للتاريخ الاجتماعي في مصر ومحيطها العربي.
ينقل "كتاب الموسيقى الشرقي" لمحمد كامل الخُلَعي (1879-1931) صورةً من صور الفكر الموسيقي في عصره، الذي تقول فيروز كراوية إنه شهد تطورات كبرى في الحياة الثقافية والفنية بتوجيه من الخديوي إسماعيل، الذي أنفق "إنفاقاً باذخاً على المرافق العامة، وتأسيس المسارح الكبيرة، والسيرك، والأوبرا في حديقة الأزبكية".
لكنّ هذه التطورات لم تقنع الخُلعي الذي كان يؤمن أن الغناء حالة روحانية لا يبلغها إلا ذو نصيب وافر من الثقافة والذوق والرّقي.
انطلق فكر الخلعي من فلسفة الطبيعة القائمة على الانسجام بين العناصر، والتناسب والتكامل والتناغم بينها، وهي فلسفة تبنّاها القدماء، من أفلاطون إلى ابن خلدون. ولم يكن الخلعي راضياً عن مستوى الغناء في عصره،
ويرى أنه مختلّ وفاسد. وأفرد باباً للعادات التي تُفسد الغناء، وتذهب بجمال الأصوات، مثل انتشار الحشيش والخمور وبيوت الدعارة. لم يكن نقده نابعاً من حرص أخلاقي على نقاء المجتمع من العادات السيئة،
وإنما من حرصه على سلامة الذائقة الفنية لدى المغنين والمستمعين على حد سواء، ومن إيمانه بأن الفن، أداء وتلقياً، يقوم على أصول وقواعد صارمة من الاجتهاد في العلم الموسيقي، وامتلاك آداب التلقي.
فهو ينتقد الملحّنين لضحالة علمهم بالمقامات، واقتصار تلحينهم على مقامين دون باقي المقامات. ثم يُفرد فصلاً تحت عنوان "آداب المغني والسامع"، يورد فيه جملة من الشروط المشددة على المغني، تُحوِّله إلى نوع من الروبوت المبرمج، وتَسلبُ منه متعة الغناء،
لكنها تنقله في المقابل من مرتبة الهواية إلى مرتبة الاحتراف، وتشذّب صوته وأداءه الحركي والجسدي، ليكون قادراً بصوته وجسمه على مواكبة الموسيقى، وبلوغ المراد الطربي من دون إخلال أو تقصير.
وتُستشف ثقافة الخُلعي الغربيّة بتركيزه على أعلى درجات الدقة في الأداء، وتنحية المشاعر الإنسانية، وتعطيل المزاج الشخصي، لصالح الإتقان، وتحقيقاً لهدف التعبير الفني على أكمل وجه.
يلخِّص الخُلعي رؤيته إلى الموسيقى بأنها (صناعة أهل الذوق والفطنة والأدب)، وبحسب الشروط التي يضعها على المغني والمُلحِّن والمُستمع، يُفهم أنه يقصد النوع الكلاسيكي من الموسيقى والغناء، الملتزم بأصول المقامات والألحان الشرقية، والناطق بالعربية الفصيحة، والمحصور في الموشحات والقصائد والأدوار، والموجّه إلى نخبة مثقفة من المتلقّين.
ويُسقط الخلعي من حسبانه النوع الشعبي من الموسيقى، والكلام العامي، والأداءات العفوية والمواهب الفطرية التي لم تخضع لتدريب وتأهيل فني وسلوكي.
ويسخر الخُلعي من المغنين الشعبيين في عصره، ويطلق عليهم تسمية "مغنّي القهاوي البلدية"، الذين لا ميزة لهم إلا "الصورة القبيحة، والصوت المُنكر".
ويسمي أشهرهم؛ سعد دبل ومحمد الحضري، ومهران المشنوق، وبلغ من احتقاره أنه هجاهم بقصيدة طويلة، يقول في مطلعها: "ومغنٍ إن تغنّى/ أوسعَ النُدمان غمّاً".
الإسطوانة تدور، والنساء يقدن
تسعفنا فيروز كراوية في وضع الخُلعي، ورؤيته الفنية، وفكره الموسيقى، في سياق تاريخي شامل ضمن رؤية لا تؤثِر نوعاً غنائياً على نوع، ولا تقع فى خطأ التعالي والإقصاء بمبررات الوصاية على الذوق الفني.
فبحسب الباحثة، كان العصر الذي نشأت فيه ثقافة الخُلعي عصر إرهاص فني، أو مخاض لولادة متعسرة، فالمجال الفني المتاح للنساء، كان متداخلاً بالعمل الجنسي،
الأمر الذي اضطرت معه الفنانات، من مغنيات (عوالم)، وراقصات (غوازٍ)، إلى "مجاراة رغبات زبائنهنّ من الأجانب، حيث كانوا مصدر دخلهن الرئيسي".
ولعلّ هذا ما يفسر نقمة الخُلعي على المغنيات، المنطلقة من حكم عام بأن النساء يفسدن الصورة الراقية للغناء التي يدعو لها.
إلّا أنّ الحال تبدّل بعد عهد الخديوي إسماعيل، فبعد فرض الحماية على مصر، عمل الإنكليز على فصْل الرقص وحصره في الصالات، فصار للمغنيات جمهور خاص ووضعن قواعد تحميهن من الابتذال.
وتزامن ذلك مع بدايات تشكّل الطبقة الوسطى، وتزايد جمهور النساء في الحفلات العامة، وظهرت الأسطوانة وشركات التسجيل التي أدخلت الغناء إلى البيوت، وفرضت رقابة ذاتية على الكلمة المغناة.
أما الجمهور الذي يشير إليه الخُلعي فهو الطبقة العليا من المجتمع، التي حافظت على تشدده في الفصل بين الجنسين، وإبعاد النساء عن حفلات الغناء. وهذا ما يفسّر نظرة الخُلعي للفن الراقي بأنه حكر على الطبقة الاجتماعية المحافظة من الذكور فحسب،
ورفضه أن ينظر إلى ما يعتمل في قلب المجتمع من تحولات تساهم فيها المرأة، مغنية ومتلقية، وهو ما قلبته الحالة المكتملة في أم كلثوم، التي جمعت الخبرات والأصول المختلفة في شخصيتها الفنية، ووحّدت الطبقات كلها في ذائقة فنية واحدة.
*نبيل عبد الكريم
قاص من الأردن