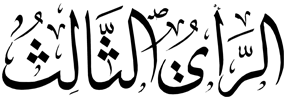أوروبا والهوية في مرآة الأرقام... بين الخوف والدافع للتغيير
تعيش أوروبا اليوم لحظة مواجهة حقيقية مع ذاتها. فالقارة التي طالما قدّمت نفسها للعالم نموذجًا للرفاه والاستقرار، تجد في مرآة الأرقام ما يُثير القلق أكثر ممّا يبعث على الطمأنينة.
فخلف شعارات "الحلم الأوروبي" و"التكامل" و"التنوّع"، تتكشّف أزمة بنيوية عميقة تمسّ جذور الهوية والديموغرافيا والاقتصاد، وتطرح سؤالًا وجوديًا: هل تستطيع أوروبا أن تستمرّ بالوتيرة ذاتها من دون أن تتغيّر؟
تشير أحدث بيانات يوروستات/ Eurostat (مديرية مهمتها تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي) إلى أنّ معدّل الإنجاب في الاتحاد الأوروبي انخفض عام 2023 إلى 1.38 مولود لكلّ امرأة،
وهو أدنى مستوى منذ عقود، مع تراجع عدد المواليد إلى 3.67 ملايين طفل فقط، وهو ما وصفته الهيئة بأنه "أكبر انخفاض سنوي منذ 1961".
هذه الأرقام ليست مجرّد تفاصيل سكانية، بل إنذار حقيقي لنظام الرفاه الأوروبي الذي يقوم على توازنٍ دقيق بين جيلٍ عامل وجيلٍ متقاعد. فكلما تقلّص عدد المواليد، زاد الضغط على صناديق التقاعد والرعاية الصحية، وارتفعت الحاجة إلى تمويل لا يتوافر إلا بوجود قاعدة سكانية عاملة وواسعة.
ورغم محاولات الحكومات تحفيز الإنجاب بسياسات الدعم الأسري، فإنّ النتائج بقيت محدودة. فالتغيّرات في أنماط الحياة، وارتفاع تكاليف السكن والتعليم، وتراجع الثقة الاقتصادية، كلّها عوامل تُبقي الخصوبة منخفضة.
ومع هذه المعادلة الصعبة، لم تعد الهجرة قضية طارئة أو إنسانية فقط، بل باتت جزءًا من معادلة البقاء الأوروبي.
تقريرٌ منشور في مجلة SAGE Publications عام 2023 بعنوان "ديموغرافيا أوروبا وما يمكن فعله حيالها"، يشير إلى أنه "من دون الهجرة، كان عدد سكان أوروبا سينخفض بنحو نصف مليون نسمة في عام 2019".
ويؤكّد معدّو التقرير أنّ الهجرة المنظمة والمُدارة بذكاء تمثّل ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد والسكان في القارة، خصوصًا في دولٍ مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا التي تشهد تراجعًا حادًا في الخصوبة.
على الجانب الاقتصادي، يسلّط تقرير OECD Employment Outlook 2024 الضوء على أزمة أخرى لا تقلّ خطورة: نقص المهارات وفجوات الإنتاجية.
فالمنظمة تؤكّد أنّ "ضيق أسواق العمل لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في دول عديدة"، وأن "الإخفاق في تطوير المهارات والحفاظ عليها بما يلائم احتياجات السوق يترجم إلى نقص في الكفاءات، ما ينعكس سلبا على الإنتاجية والتنافسية".
هذا العجز البنيوي في سوق العمل دفع دولًا أوروبية عدّة إلى تبنّي برامج جديدة لاستقطاب اليد العاملة الماهرة من الخارج، مع تبسيط إجراءات الإقامة والتأهيل المهني.
فالحاجة إلى المهاجرين أصبحت مسألة اقتصادية بحتة لا يمكن تجاهلها، رغم الخطاب السياسي المُتردّد حولها. وفي حين ترتبط أزمة الخصوبة بسؤال "من سيعمل؟"، تطرح أزمة الدين العام سؤالًا موازيًا: "من سيموّل؟".
فبحسب أحدث نشرات يوروستات الصادرة في 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2025، بلغت نسبة الدين العام في منطقة اليورو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام،
مع تباينٍ واضح بين الدول: اليونان 151.2%، إيطاليا 138.3%، فرنسا 115.8%، ألمانيا 63%، هولندا 49%. هذه الفوارق تضع الاتحاد أمام معضلةٍ مستمرّة:
كيف يمكن صياغة سياسة اجتماعية موحّدة إذا كانت قدرات التمويل الوطني متباينة إلى هذا الحد؟ إذ تعني هذه الأرقام أنّ الدول الأكثر مديونية تواجه قيودًا في الإنفاق الاجتماعي، بينما تتمتّع دول الشمال بهوامش مالية أوسع، ما يجعل التضامن الأوروبي شعارًا أكثر منه واقعًا مُتحقّقًا.
وسط هذا المشهد المركّب، يزداد حضور خطاب الخوف والهوية في الساحة السياسية. فالمهاجر الذي مثّل في العقود الماضية أحد أعمدة الازدهار الصناعي والخدمي، تحوّل في الخطاب الشعبوي إلى "تهديد" أو "عبء".
لكن الأكاديمي الهولندي وأستاذ علم الاجتماع في جامعة أمستردام، هاين دي هاس، يفنّد هذه السردية بقوله: "كثير مما يُقال عن الهجرة يستند إلى الأساطير أكثر مما يستند إلى الوقائع.
فمع استمرار الحاجة البنيوية إلى العمال المهاجرين في الاقتصادات الأوروبية، تظلّ الهجرة ظاهرة لا يمكن تجنّبها".
هذا التصريح يلخّص بوضوح حقيقة باتت المؤسسات البحثية نفسها تُقرّ بها: من دون الهجرة المنظّمة، ستعجز أوروبا عن الحفاظ على حجم سوق العمل الضروري لاستدامة نظامها الاجتماعي.
لكن في المقابل، تُظهر دراسة نُشرت في مجلة Nature Human Behaviour عام 2023 أنّ الهجرة ليست عصا سحرية، فهي تُسهم في تعويض النقص العددي لكنها لا تغيّر جذريًا هيكل الأعمار، ما يجعلها جزءًا من الحل لا الحل بأكمله.
وفي يونيو/حزيران 2025، نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) تقريرًا يؤكّد أنّ "انكماش السكان وشيخوختهم يفرضان على أوروبا إعادة التفكير في القوّة العاملة وفي موقعها في الاقتصاد العالمي"، وأنّ "دمج المهاجرين واستثمارهم كطاقة إنتاجية هما أحد مفاتيح استعادة القوة الأوروبية".
التقرير دعا بوضوح إلى الانتقال من سياسة "إدارة الهجرة" إلى سياسة "توظيفها"، أي تحويلها من ملف أمني إلى مشروع تنموي-اقتصادي.
وعلى الأرض، بدأت بعض الدول إدراك هذا التحوّل. فبلدان الشمال الأوروبي نجحت في رفع معدلات مشاركة النساء في سوق العمل عبر حوافز مالية وإجازات أبوة متساوية وسياسات دعم الأسرة،
فيما تبنّت ألمانيا وهولندا برامج اندماج لغوي ومهني مبكّر للمهاجرين تُسهّل دخولهم إلى سوق العمل وتقلّل الفوارق الثقافية. هذه التجارب تبرهن أنّ الهُويّة ليست سورًا يُغلق المجتمع، بل محرّك لإعادة تعريفه وتجدّده.
لكن التحدي الأكبر لا يزال في الموازنة بين الأمن الثقافي والواقعية الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي يجد نفسه بين ضغطين متوازيين: ضغط الشارع الذي يخشى التغيير، وضغط الأرقام التي تفرضه.
وبين هذين القطبين، يحتاج القادة الأوروبيون إلى شجاعة سياسية لقول الحقيقة كما هي: الهجرة ليست خطرًا وجوديًا بل مورد حيوي، والشيخوخة ليست قدَرًا محتومًا بل ظاهرة يمكن إدارتها بسياسات ذكية.
سمير الخالدي
كاتب صحفي وإعلامي تونسي