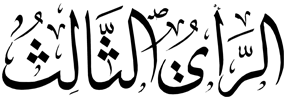قراءة في سردية الانكسار العربي
مشكلة العقل العربي أنه غرق في غباء عنتري ممزوج بخرافات قومية ودينية ويسارية مائعة، لا يرى العالم إلا من خلال شعارات جوفاء. يظن أن إسرائيل كيان مؤقت،
بينما الحقيقة أن إسرائيل، بما تمتلكه من مؤسسات وأنظمة مدنية راسخة، أثبتت أنها دولة باقية، في حين أن ما يُسمى بالجمهوريات والأنظمة العربية كيانات مؤقتة لا جذور لها، تنهار عند أول اختبار أو أزمة.
تبدو ظاهرة السعار الديني في مجتمعاتنا وكأنها قدر محتوم، إذ تتكرر جيلاً بعد جيل وتجد لنفسها دائمًا مبررات للظهور والانتشار. ليست المشكلة في الدين ذاته، بل في الطريقة التي استُخدم بها عبر التاريخ، وتحوله من منظومة روحية وأخلاقية إلى أداة سياسية واجتماعية تُستثمر في لحظات الأزمات والهزائم.
غياب الدولة المدنية هو عامل رئيسي: لم يعرف العالم العربي دولة مؤسسات حقيقية، فالدولة الحديثة القائمة على القانون والمواطنة لم تتجذر في الوعي ولا في الممارسة. السلطة دائمًا ارتبطت بشخص: خليفة، سلطان، إمام، أو زعيم. وبما أنّ شرعية الحاكم كانت هشة،
فقد لجأ إلى الدين ليمنح نفسه قداسة تعوّض ضعف البنية المؤسسية. وهكذا أصبح الدين جزءًا من هيكل السلطة بدل أن يبقى خيارًا فرديًا حرًا.
الفقر والتهميش المزمنان يخلقان حاجة إلى تعويض نفسي. مع غياب العدالة الأرضية، يتحول الدين إلى وعد بالعدالة في الآخرة.
يصبح التدين حالة من الهوس والشحن العاطفي، إذ يجد المقهورون في الشعارات الدينية متنفسًا عن عجزهم أمام واقع قاسٍ لا يملكون تغييره.
المجتمع العربي يُعيد إنتاج ذاته عبر المدرسة، المسجد، والإعلام، كل هذه المؤسسات قائمة على التلقين لا التفكير النقدي. منذ الطفولة يُمنع الطفل من السؤال "لماذا؟"،
فينشأ عقل يهاب الحرية ويجد راحته في الانصياع للشعارات المطلقة، وهو ما يصنع أرضًا خصبة للسعار الديني.
منذ القرن التاسع عشر، شكّلت مواجهة العرب مع تفوق الغرب صدمة نفسية عميقة. الغرب "الكافر" انتصر في السياسة والعلم والاقتصاد، بينما "المؤمنون" عجزوا عن اللحاق به.
هذه المفارقة أفرزت حالة من العجز الجماعي، جرى التعويض عنها عبر السعار الديني بوصفه رد فعل دفاعيًا يبرر الفشل بالتمسك المرضي بالهوية الدينية.
الصحوة الإسلامية لم تكن مشروعًا حضاريًا، بل رد فعل على الهزائم المتتالية، خصوصًا هزيمة 1967. انعكست سلبًا على الوعي الجمعي الإسلامي وأدخلته في حالة تقوقع.
انقسمت إلى شقين، سني وشيعي، وتحولت إلى ساحة صراع نفوذ بين القطب السعودي السني والقطب الإيراني الشيعي.
كل طرف انشغل بمحاربة الآخر ودعم حركات التمرد، فيما استغلت إيران الموقف لصناعة تحالف أقليات ضد الأكثرية السنية. الرابح الوحيد كان إسرائيل، التي استثمرت الانقسام وصعدت على حساب تراجع العرب المستمر.
تسببت الصحوة في تدمير فرص بناء مجتمعات مدنية، وفرغت الديمقراطية من مضمونها، بل حولتها إلى عدو متآمر، رغم أنها الأداة الوحيدة التي كان يمكن أن تعيد التوازن، خصوصًا في الجمهوريات الشكلية.
القطار قد فات، والأضرار كارثية، وكلفة الإصلاح باهظة لا تتحملها هذه المجتمعات. وحتى إن حاولت، فستدفع ثمنها في مزيد من الصراعات الطائفية والدينية.
بعد 1967 كان يفترض أن تحدث مراجعات عقلانية كما فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وألمانيا بعد النازية، لكن العرب اختاروا الطريق الأسهل: شعارات وتدين سياسي والالتجاء إلى الماضي.
الأنظمة السياسية دمجت هذا السعار الديني في بنيتها وجعلته أداة للبقاء، وصار الخلاص منه شبه مستحيل. الشعوب وجدت في خطاب الموت عزاءً عن هزائمها، لأنه يعفيها من مواجهة الحقيقة:
نحن مهزومون. أصبح خطاب الشهادة أكثر إغراء من خطاب الحياة، وتحولت المجتمعات إلى قطعان زومبي، تتحرك بلا وعي وتعيد إنتاج هزائمها بلا نهاية.
إسرائيل لم تنتصر فقط بسلاحها، بل بانضباط مؤسساتها واستثمارها في الحياة، بينما العرب غرقوا في أوهام الصحوة وعبادة الموت. ومن هنا يُحسم المستقبل: من يختار الحياة يبقى وينتصر، ومن يعبد الموت يهوي إلى القاع.
حمزة الموسوي