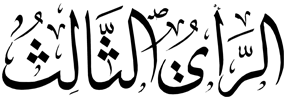'استجداء' مقعد في مجلس التعاون!!
بينما تغرق النخب السياسية في الجدل حول المحاصصة والولاءات، يزحف الزمن نحو لحظة الحقيقة التي يتجاهلها الجميع: يمنٌ يشارف سكانُه على 55 مليوناً في غضون عقدٍ واحد.
نحن لا نتحدث هنا عن مجرد نمو سكاني، بل عن 'زلزال ديموغرافي' قادم في بيئة منهكة اقتصادياً ومدججة بالسلاح.
فهل نملك الشجاعة للاعتراف بأن مخرجنا ليس في 'استجداء' مقعد في مجلس التعاون، بل في ثورة حقيقية لتأهيل الإنسان اليمني ليكون شريكاً لا عبئاً؟
إن مواجهة الحقائق المرة حول الثقل البشري المهدور وضياع منظومة الدولة هي الخطوة الأولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يتحول الطموح إلى كارثة تتجاوز شظاياها حدود الجغرافيا.
إن التوقعات التي تشير إلى وصول سكان اليمن إلى 55 مليون نسمة خلال عقد واحد ليست مجرد إسقاطات إحصائية عابرة، بل هي سيناريو واقعي صادم تفرضه مؤشرات النمو الحالية التي شهدت ولادة نحو 1.4 مليون طفل في عام 2025 وحده،
ومع تمثيل الفئة العمرية ما بين (0-14 سنة) لنحو 41% من إجمالي السكان، نجد أنفسنا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، بعيداً عن أحلام الانضمام لمجلس التعاون أو الرهان على الدعم الخارجي المطلق؛
فالدول تتحرك وفق مصالحها التي قد تفرض علينا أثماناً باهظة من سيادتنا، جغرافيتنا، وقراراتنا الوطنية. إننا أمام مفترق طرق: إما استثمار تاريخي في العقول، أو كارثة ديموغرافية ستتجاوز آثارها الحدود لتطال المنطقة برمتها.
تكمن جذور الأزمة في الركون إلى أوهام 'الإنقاذ الخارجي' كحل سحري، وهو طرح يفتقر للواقعية لأسباب بنيوية عميقة؛ إذ تتوجس العقول السياسية والتنموية في الخليج من استيعاب كتلة بشرية قوامها 55 مليوناً،
تفوق في عددها الشعوب الخليجية مجتمعة (بمعزل عن العمالة الوافدة)، مما يهدد بخلل ديموغرافي وفكري لا يمكن التكهن بتبعاته.
وعلاوة على ذلك، يصطدم طموح الاندماج بواقع الانفلات الأمني والفساد المؤسسي في اليمن، حيث لا توجد معالم دولة صلبة يمكن البناء عليها، في ظل ارتهانٍ للمشاريع الخارجية وعسكرةٍ للمجتمع على حساب التعليم.
لقد أفرزت الحرب واقعاً مأساوياً؛ فتقديرات السلاح التي كانت تشير إلى 60 مليون قطعة قبل الحرب قد تضاعفت اليوم، ليصبح نصيب الفرد قطعتي سلاح بدلاً من مهنة أو جهاز حاسوب، مما يجعل تجفيف بيئات الصراع في ظل غياب الكفاءات والارتهان لـ 'الفشخرة الفارغة' تحدياً مستحيلاً.
يضاف إلى ذلك أزمة الثقة لدى الشركاء الإقليميين بسبب غياب منظومة الشفافية والرقابة، مما يحرم اليمن من إدارة مشاريع ضخمة.
واقتصادياً، تعاني العمالة اليمنية من فجوة مهارية حادة تجعلها خارج دائرة المنافسة مع العمالة الآسيوية المنظمة، فضلاً عن انهيار البنية التحتية وهجرة رأس المال الوطني ولا ننسى كارثة القات وانتشاره، وموضوع الهجرة الأفريقية والحدود المفتوحة.
والخلاصة، نبني دولتنا ونصلح أحوالنا أولاً، وبعدها يجيء التكامل مع غيرنا.
في ظل هذا المشهد، قد يرى البعض في المنطقة مصلحة في استمرار 'حالة عدم استقرار مُحتواة' عبر دعم المشاريع الصغيرة والعسكرة كـ 'سياج أمني' يحمي حدودهم ويبقي اليمنيين تحت السيطرة لعقود، مستخدمين فزاعة التمزق لضمان التبعية.
لذا، فإن الفرصة الحقيقية لا تكمن في الانسلاخ من هويتنا ولا في طلب المستحيل من جيراننا، بل في تبني نهج واقعي يقوم على شراكة مصالح ندية؛ تبدأ ببناء دولة كفاءات، وفتح الأبواب للعمالة اليمنية الماهرة تقنياً، ودعم التعليم المهني لبناء جيل منتج لا يمثل عبئاً على محيطه.
إن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الصحيح الذي يحمي أمن المنطقة، بعيداً عن أحلام الاندماج السياسي التي تعيقنا عن رؤية الحلول الممكنة.
إنَّ الاستمرار في بيع الأوهام للشعب اليمني بوعود الاندماج والإنقاذ الخارجي ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو خطيئة بحق الأجيال القادمة التي ستجد نفسها في مواجهة انفجار ديموغرافي داخل بلدٍ منهارٍ ومسلح حتى النخاع وطرح غير واقعي وعاطفي غير عقلاني.
إنَّ على النخبة اليمنية أن تدرك أنَّ السيادة لا تُمنح كصدقة، والكرامة الوطنية لا تُبنى على موائد المانحين والاوطان لاتبني بحسن نية الجوار والخارج معنا، بل تُنتزع ببناء دولة الكفاءات وتوطين المعرفة.
وعليه إما أن نستيقظ من سكرة 'الانتظار' وبيع الاوهام لنبني جيلاً يمتلك المهارة والتقنية ليفرض نفسه شريكاً لا تابعاً، وإما أن نترك الـ 55 مليون يمني ليتحولوا إلى أكبر كتلة بشرية تائهة في التاريخ الحديث؛
حينها لن تنفع الأسوار ولا السياجات الأمنية في احتواء الانفجار، ولن يرحم التاريخ من فرّط في صناعة الإنسان وارتهن للمشاريع الصغيرة على حساب وطنٍ كان يوماً يسمى سعيداً.