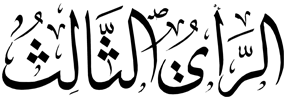منهجية الإحسان تسبق منظومة رقابة القانون في الغرب!!
الحضارة ليست ناطحات سحاب وتكنولوجيا فائقة فحسب؛ بل هي 'الأمان الأخلاقي' حين تنعدم الرقابة. وثائق إبستين لم تكن مجرد فضيحة نخبة، بل كانت كشف عورة لنظام مادي يفتقر للوازع الداخلي. فقبل أيام، أطلقتُ عبارةً قد يراها البعض صادمة، لكنها في جوهرها استقراءٌ لواقعٍ مأزوم:
"إن وثائق إبستين لا تخبرنا سوى بحقيقة واحدة؛ وهي أن منظومتنا القيمية تمثل ذروة التحضر الإنساني". وهذه هي ضريبة العبارات المكثفة؛ إذ غالباً ما تُختزل في تأويلات ضيقة تخضع لأهواء القارئ، رُغم أنني أرستُ دعائمها الفلسفية في طرح سابق.
واليوم، أعيد تفكيك هذه المقولة من زوايا علمية وأخلاقية تتجاوز العاطفة لتبحث في جوهر الحضارة تحت سياق خطبة جمعة.
إن ارتكازي على "ذروة التحضر" ينبع من كون القيم الإسلامية ليست نتاجاً عرقياً أو فئوياً، بل هي نداءٌ مباشر لـ "الفطرة البشرية" في أنقى تجلياتها.
فحين أرسى الإسلام مبدأ "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"، لم يكن يضع مجرد شعار، بل كان يصيغ الإعلان العالمي الأول والأنضج لحقوق الإنسان، محطماً أصنام العنصرية والطبقية قبل أن تعرفها الحداثة بقرون.
وفي الوقت الذي يتخبط فيه العالم بين جشع الرأسمالية وتغول الاشتراكية، وجدت منظومة التكافل (من زكاة وصدقة وأوقاف) كنموذج اقتصادي-أخلاقي فريد، يحمي كرامة الفرد الضعيف ويضمن حق المجتمع عبر "الرقابة الذاتية"؛ تلك القوة الداخلية التي تجعل المرء رقيباً على ثروته أمام خالقه دون حاجة لشرطيٍّ يقف على رأسه، وهي أسمى درجات الرقي الاجتماعي.
إن التحضر الحقيقي ليس تكدساً تكنولوجياً ولا رفاهية مادية جوفاء، بل هو "هندسة التوازن" بين الروح والمادة. نحن نرى اليوم مجتمعاتٍ تملك أحدث الأدوات لكنها تعاني من "يتمٍ روحاني" واغترابٍ مخيف عن المعنى؛
وهنا تبرز قيمنا لتقدم للإنسان الغاية والبوصلة. وهذا التوازن هو ما قصدته بكلمة "الذروة"؛ فهي ليست مجرد انحيازٍ عاطفي، بل هي جملة تقريرية تؤكد أن هذا النظام القيمي هو الأجدر بقيادة البشرية نحو الارتقاء.
والتاريخ يشهد أن هذه القيم كانت هي الوقود الذي أشعل منارات بغداد وقرطبة، محولةً الحضارة إلى "وعاءٍ" استوعب التعددية الدينية والعرقية في زمن كان العالم فيه غارقاً في ظلمات الإقصاء والهمجية.
أنا لا أستدعي هنا سرديات تاريخية للنقاش، بل أتحدث عن "منهجية الإحسان" كحقيقة مطلقة في بناء الإنسان من الداخل. نحن كمسلمين، نمتلك "قانوناً داخلياً" يسبق سلطة الدولة؛ لأننا نؤمن أن كل مثقال ذرةٍ مرصود،
وهذا ما يحمينا من أن نتحول إلى "قصاصات ورق" تذروها رياح الرأسمالية الغربية التي تملك مخالب تمزق الشعوب وتزدري أي نموذج قيمي مغاير.
يجب أن نعي جيداً الفرق بين "القيم في ذاتها" كمبادئ مطلقة، وبين "ممارسات الأفراد" التي قد تخطئ وتصيب.
نعم، قد يكون الغرب اليوم هو المتفوق "إجرائياً" بفضل قوة القانون ووفرة المادة، ولكن الاختبار الحقيقي للتحضر لا يظهر في الرخاء، بل يكمن في صمود المبادئ حين تغيب المادة وتسقط سطوة الرقابة الخارجية.
إن عالم اليوم لا يعاني من فقر في "الوسائل"، بل من إفلاس حاد في "الغايات". الحضارة المادية المعاصرة تشبه طائرة نفاثة فائقة التطور، لكن يقودها طيار فقدَ إحداثيات الوجهة؛
فهي تندفع بسرعة مذهلة نحو المجهول! والمستقبل، بكل مؤشراته، لن يحتاج إلى مزيد من الآلات، بل سيصرخ طلباً لقيمة تعيد للإنسان إنسانيته؛ قيمة تجمع بعبقرية بين "يقظة الضمير" التي يصنعها الإيمان بمحور الاحسان، و"حزم القانون" الذي تفرضه الدولة.