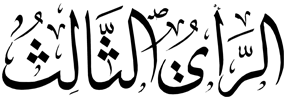اليمن بين مقصلة الانهيار وإدارة “الهوشلية”!!
لو تقدّم أيٌّ من رؤساء الحكومات أو الوزراء اليمنيين، أو نوابهم ووكلائهم خلال العقود الماضية بطلب توظيف في شركة أوروبية ناشئة، لجرى استبعاده من الجولة الأولى دون حتى مراجعة سيرته الذاتية.
ليس في ذلك تقليلٌ من شأن أحد، بل لأن معايير الإدارة الحديثة تقوم على النتائج لا الادعاءات، وعلى الكفاءة لا المظاهر والخطابة.
ففي عالم اليوم يُقاس النجاح بما يُنجز فعلاً، لا بما يُقال، وبقدرة القيادة على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، لا بعدد الاجتماعات أو ضجيج التصريحات.
وهنا تتجسد مأساة اليمن، بلدٌ يتقن فنّ الكلام وافتعال الفهم، بينما تتقدّم الأمم عبر خطط مدروسة وأهداف محددة.
فما زالت مؤسسات الدولة تُدار بعقلية “الهوشلية” — أي بالارتجال والعشوائية — حيث تحل الفوضى محلّ التخطيط، وتُترك إدارة المستقبل للمصادفة، ويُعامل الإخفاق كأنه قدرٌ لا مفرّ منه.
تتغيّر الحكومات لكن النهج واحد، تُعاد الأخطاء نفسها بأسماء مختلفة، وكأن الوجوه تتبدّل فيما يبقى الفشل ثابتًا لا يتزحزح.
الأرقام تروي وحدها سيرة الانحدار. فالأزمة ليست أزمة أموال بل أزمة عقلٍ ومنهج. بلدٌ بمساحة تزيد على نصف مليون كيلومتر مربع، وسكانٍ يتجاوز عددهم 43 مليون نسمة، وساحل يبلغ طوله 2500 كيلومتر على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وأكثر من 180 جزيرة لم تزل مهملة،
يعيش في اقتصادٍ جامدٍ لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجاته مما دفع البلاد إلى دوامة من الصراعات والارتهانات الخارجية، حتى أصبح الجميع يبحث عن كفيلٍ، ولو كان الثمن تدمير الوطن نفسه.
هذه الثروات لم تتحول إلى روافع بناء بل إلى أثقال تشدّنا للأسفل، وأضحى الإنسان فيها جزءًا من دائرة العجز العام لا من رؤية النهوض.
ولفهم الصورة كاملة، لننظر إلى صادرات اليمن في عام 2022؛ لم تتجاوز 1.95 مليار دولار شملت النفط والغاز والزراعة والأسماك.
وحتى حين نستثني الموارد الطبيعية، فإن الناتج من الصادرات الأخرى لا يبلغ 500 مليون دولار سنويًا، أي أقل من أرباح متجر أوروبي متوسط الحجم. وعندما نقارن هذا الأداء بإيرادات فيلمٍ تجاريٍ واحد مثل باربي الذي حقق أكثر من مليار دولار في أسابيع،
ندرك الفرق بين من ينتج بعقل منظم، ومن يكتفي بالانتظار والتبرير.
في المقابل، نرى مثلاً آخر يقدّم درسًا إداريًا بليغًا: شخصان فقط في ألمانيا بدآ من لا شيء وأسسا عام 1962 سلسلة متاجر ALDI، التي وُصفتها ببساطة بـ“بقالة الفقراء”.
بعد ستة عقود، تجاوزت إيراداتها 121 مليار دولار سنويًا. وكذلك سلسلة متاجر "ليدل" التي انطلقت عام 1973، تجاوزت إيراداتها اليوم 175 مليار يورو. في العام ذاته،
كان اليمن يحتفل بانطلاقة ثورته الجمهورية، لكنه بعد ستين عامًا ما زال يناقش شكل النظام بدلاً من قياس إنجازاته. نوزّع اليوم سلال الإغاثة في المدن والقرى، فيما يغترب الملايين أو يضيعون في دوامة الحشود والصراعات.
أي منطق يقبل أن يؤسس اثنان إمبراطورية اقتصادية بفكرة، بينما ينتظر عشرات الملايين سلة غذاء وعودًا خاوية؟
يا فخامة الرئيس رشاد العليمي، مشكلتنا ليست في ندرة الموارد بل في سوء إدارتها مهما كان حجمها. يمتلك اليمن موقعًا جغرافيًا فريدًا على أهم شريان للتجارة العالمية، وثروات نفطية ومعدنية وزراعية هائلة، ومجالًا سياحيًا قادرًا على إنعاش الاقتصاد لعقود.
ومع ذلك يبقى هذا الغنى معطّلاً لأننا نفتقر إلى المشروع الوطني الشامل والعقل المخطط القادر على ترجمة الطاقات إلى إنجازات. إن الخطر الحقيقي ليس الفقر، بل غياب الإرادة التنظيمية التي تبني وتخطط وتحاسب.
العالم من حولنا يُعلّمنا أن المعجزات الاقتصادية ليست مصادفات، بل نتائج لإدارة واعية وانضباطٍ مؤسسي.
فالصين التي لم يتجاوز اقتصادها عام 1990 أربعمائة مليار دولار تخطّت اليوم 21 تريليونًا بفضل التعليم والحوكمة الصارمة.
والهند التي لم تتعدّ حينها 370 مليارًا أصبحت اليوم قوة اقتصادية تفوق ثلاثة تريليونات دولار بفضل الكفاءة والإصلاح. تلك الأمم لم تغرق في الجدل، بل آمنت أن لون القط لا يهم ما دام يصطاد الفئران.
أما نحن فما زلنا نحوّل الخلافات التاريخية إلى معارك دائمة؛ نناقش “الجنوب العربي” و“الوحدة” و“الانفصال”، ونُعقد مؤتمرات لا تثمر إلا مزيدًا من التشرذم،
ومنذ عام 2011 لم نعرف سوى الفوضى نستهلك أنفسنا في الحشود والضجيج الإعلامي، لنستيقظ في النهاية على واقعٍ مرير لا كرامة تحققت، ولا رغيف خبزٍ توفر للمجتمع ولا استقرار.
نختبئ وراء خطاب “المؤامرة الخارجية”، غير مدركين أن التآمر الحقيقي هو سوء الإدارة وتدمير الذات. خسرنا الفرص والدعم لأن المؤسسات بلا خطط قابلة للتنفيذ، والمشاريع بلا مؤشرات قياس، والمناصب تدار بالأهواء لا بالكفاءة.
أما العقول القادرة، فإما هاجرت أو صمتت، ليبقى المشهد بيد من يجيدون الخطابة والتلون والابتزاز لا العمل.
لا مستقبل لوطنٍ كهذا ما لم نُحدث قطيعة مع ثقافة الولاء والمحسوبية والابتزاز. طريق الإنقاذ يبدأ بثورة تنظيمية تُعيد الاعتبار للتخطيط والمساءلة، وترد للدولة معناها كأداة إنتاج وليست منصة استعراض سياسي.
الحل لا يأتي من الخارج ولا بوعود الإنقاذ السريع، بل يولد من الداخل، من أول قاعدة في فن الإدارة: ابنِ المشروع قبل أن تختار الأشخاص. فالحكومة ليست توزيعًا للمقاعد، بل منظومة عملٍ تتنافس بالكفاءة وتُحاسَب بالنتائج.
عندما تصبح الوزارات مؤسساتٍ ذات أهداف محددة ومؤشرات واضحة للمساءلة، يمكن الحديث عندها عن بداية الطريق الصحيح.
اليمن يقف اليوم بين فقرٍ متفاقم واغترابٍ شامل، والشعب أنهكه الانتظار والقلق والازمات. لم يعد المواطن يحتمل مسؤولين يتحدثون بثقة وهم يجهلون كيفية تحويل الكلمات إلى فعل.
فالأمم التي لا تخطط تُدار من الآخرين، والمعرفة التي لا تُوظف تبقى عبئًا يثقل أصحابها. المستقبل لا يُمنح، بل يُصنع برؤيةٍ واضحة، وعقلٍ منظم، وإرادةٍ تؤمن بأن العمل الجاد وحده طريق النجاة.
اليمن لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إدارة تعرف وجهتها، وقيادةٍ تُدرك أن النوايا لا تُقيم الدول بل النتائج. آن أوان إنهاء حقبة “الهوشلية” وبدء عهدٍ جديد من الانضباط والاحتراف والعقلانية الوطنية، قبل أن يتحول المستقبل إلى تكرارٍ مملٍ لفوضى الأمس.