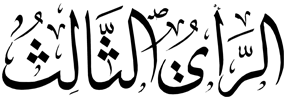اليمن.. شعب بين قيود الفكر وقبضة الزناد
اليمن... آه يا اليمن. هناك بلاد لا تُكتب بالمداد وحده، بل تُروى بالنقوش على صخر الذاكرة، وبعطر اللُبان الممزوج بدم السيف.
كيف لنا أن نختزل هذه الأرض، وهي أول من احتضن الحضارة وصنع التيجان المرصعة بالذهب؟
هي التي شادت السدود العظيمة قبل أن تُعرف مفاهيم الهندسة الحديثة، وصدّرت البخور والعطور لتُطهر معابد العالم القديم.
هي أرض الجنتين التي تغنى بها القرآن، وأرض السعيدة التي حلم بها الرحالة. شعبها هو شعب الأنصار الذين آووا ونصروا، وأصل العروبة الذي منه انبثق اللسان والبيان.
هذه الأرض، بتاريخها الممتد كجدائل شجرة التبلدي، كانت منارة عمران ونقوش، شاهدة على أن الإنسان اليمني صانع لا مستهلك، باني لا هادم.
ولكن، بين الأمس واليوم، وقعت فاجعة الروح. إذا كان المجد القديم قد بُني على تماسك الفكر ومركزية الهدف، فإن حاضر اليمن يكاد يكون مرثية للتشرذم والضياع.
تحوّل هذا الشعب، الذي كان يوحده مجد سبأ وحمير، إلى مجرد "وقود بشري" بين فكّي مقصلة أيديولوجية لا تعرف الرحمة.
إنها مأساة أن يُصبح الفكر، الذي وُجد لتحرير الإنسان من الجهل، قيداً يكبّله ويزج به في دهاليز العداوة.
لقد نجحت المشاريع الهشّة، التي تدّعي الحق المطلق والحقيقة الواحدة، في تفتيت النسيج الاجتماعي، ليصبح اليمنيون شيعاً وأحزاباً وفرقاً ومذاهب وطوائف.
لم يعد الصراع على الوطن كفكرة جامعة، بل صار صراعاً على الحصة من الوطن.
هذا التحول الفاجع أشبه بتحويل نهر عذب جارٍ إلى مستنقعات آسنة؛ تبدو وكأنها مياه، لكنها تحمل كل بذور الأمراض.
فالـ"تبعية" هنا لم تعد اختياراً مبنياً على قناعة فكرية، بل صارت قسرية، مفروضة بوزن السلاح وهيبة الخطاب.
وهنا تكمن ذروة المأساة الفلسفية لليمن المعاصر: أن الفرد أصبح رهينة بين قوتين لا ترحمان: مطرقة الفكر وسندان الرصاص.
فالمطرقة هي التعبئة الأيديولوجية والخطاب الإقصائي الذي يصنف الناس إلى "معنا أو ضدنا".
في هذا المناخ، يُنظر إلى "الحياد" باعتباره خيانة عظمى أو عمالة سافرة، فلا مكان للمنطقة الرمادية، ولا مساحة للرأي المخالف؛ فالانتماء قسري والشك جريمة.
أما السندان، فهو الآلة العسكرية والواقع المسلّح الذي يفرض التبعية كأمر واقع.
فمن لم يُقنعهم الخطاب، أخضعته قبضة الزناد، ليتحول الصامت إلى تابع مرغم، أو قتيل موصوف بـ"الخيانة"، وهي تهمة جاهزة لتبرير سفك الدماء وتصفية الحسابات.
هذا المشهد، الذي يذكرنا بعبثية مسرحيات صمويل بيكيت، حول اليمنيين إما إلى مرتزقة يُقاتلون بوعي أو بدونه، أو إلى أسرى في جغرافيا الـ "لا خيار".
وأشد مرارة من هذا الصراع، هو الثمن الباهظ الذي دفعته الذاكرة اليمنية.
فالعقول الحرة التي رفضت أن تكون وقوداً أو أتباعاً، اختارت الهجرة والشتات.
تركوا وراءهم فراغاً ضخماً ملأته أصوات الطائفية والجهل.
هؤلاء الذين هربوا، هم نخب اليمن الممكنة، الأمل في إعادة بناء سد المعرفة والمدنية.
أما من بقي في الداخل، فصار مجبراً على الانضواء تحت راية المكونات المتصارعة.
لا يهم إن كان يؤمن بها نفسياً؛ المهم أن يبقى على قيد الحياة.
لقد تحول الفرد، في معزل عن قناعته الداخلية، إلى ترس صغير يعمل في آلة صراعية ضخمة، وهذا هو الخذلان الأكبر للذات؛ أن يُجبر الإنسان على قتل فكره ليحافظ على جسده.
إن اليمن اليوم أشبه بقصائد إيليا أبو ماضي في حيرتها الأبدية: تملك كل مقومات الجمال والعذوبة، لكنها حزينة، محاصرة بالأسئلة التي لا إجابة لها، تُناجي النجوم بينما الطين يغطي جذورها.
إن النجاة من هذه الدائرة المفرغة لن تأتي بانتصار فكر على فكر، ولا بتفوق رصاصة على أخرى.
بل تبدأ باستعادة الإنسان، وكسر قيود التبعية الفكرية، ونزع هيبة الزناد من أيدي المتاجرين بالأوطان.
يجب أن نستعيد مفهوم "الجمهورية الفكرية" التي تتيح لأبناء الأنصار والملوك والعلماء، أن يلتقوا على أرضية مشتركة هي اليمن العظيم، لا على حطام الفرق الضيقة.
إن مهمتنا الفلسفية تبدأ من الإيمان بأن اليمن يستحق أن يكون فكرة حرة، لا رهينة محاصرة.