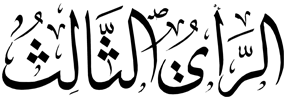الحرب وإعادة تشكيل نفسية اليمني
لا تدمّر سنوات الحرب الطويلة في أيّ بلد المدن وتغيّر شكل الحياة فقط، بل تُعيد أيضًا تشكيل الإنسان نفسه. فأثرها الحقيقي لا ينتهي عند المباني المُهدّمة، بل يمتدّ إلى طريقة تفكير الناس وقيمهم وسلوكهم اليومي.
وقد أثبتت تجارب دول كثيرة أنّ إعادة إعمار الحجر مُمكنة خلال فترات زمنية معقولة، أما إعادة ترميم الإنسان فمسار أبطأ بكثير. فالثقة، والإحساس بالأمان، والاطمئنان للمستقبل، وروح المبادرة لا تُبنى بقرار ولا تُستعاد بمشروع، بل بمسار طويل قد يمتدّ لأجيال.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة ما جرى في اليمن: فسنوات الحرب لم تغيّر ظروف العيش فقط، بل غيّرت نظرة اليمني إلى الواقع نفسه، كيف يثق، وكيف يحكم، وكيف يعرّف الصواب والخطأ، وكيف يقيس النجاح والنجاة والواجب.
في الحالة اليمنية، يمكن رؤية هذا التحوّل بوضوح منذ ثورة فبراير 2011 وما تلاها من مرحلة انتقالية اتسمت بروح المشاركة والأمل. برزت آنذاك قيم التغيير السلمي والعمل الجماعي والإيمان بإمكانية بناء مسار سياسي جديد.
لكن مع تعثّر المرحلة الانتقالية ثم انزلاق البلاد إلى الحرب وتراجع مؤسسات الدولة، دخل المجتمع في حالة ضغط ممتد، ومع طول الخطر بدأت أولويات الإصلاح تتراجع أمام ضرورات البقاء.
أوّل ما يتآكل في مثل هذه الظروف هو ثقة الناس بالمؤسسات والقوانين. قبل الحرب، كانت هذه الثقة، رغم هشاشتها، موجودة بدرجة ما في الجهات الرسمية.
ومع الانقسام وازدواج السلطات وتضارب القرارات، ضعفت الثقة بهذا الإطار، وانتقلت إلى الدوائر الضيّقة: العائلة والجماعة المحلية وشبكات العلاقات.
يتجلّى ذلك عمليًّا في الاعتماد على "من تعرف" أكثر من الاعتماد على النظام، والبحث عن واسطة لإنجاز معاملة بدل اللجوء إلى المسار الرسمي. هذا التحوّل ليس ثقافيًّا فقط، بل نفسي دفاعي؛ فالعقل تحت عدم اليقين يقلّص دائرة الاعتماد إلى ما هو مباشر ومضمون.
كما اختلّ ميزان الحكم على الأفعال. في أجواء الصراع، لم يعد السؤال: ماذا حدث؟ بقدر ما أصبح: من الذي فعله؟
الخطأ قد يُدان إذا صدر من طرف بعيد، لكنه يُبرَّر إذا صدر من طرف قريب أو محسوب على الجهة نفسها. كثيرون يتشدّدون في إدانة تجاوزات "الطرف الآخر" ويتسامحون مع تجاوزات "طرفهم"، حتى لو كان السلوك واحدًا.
مع الوقت يصبح الانتماء أهم من القاعدة، والقرب أهم من المبدأ.
وتضرّرت كذلك قيمة التخطيط طويل المدى بفعل اتساع الفقر والحرمان.
وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو 82.7% من سكان اليمن في فقر مُتعدّد الأبعاد، أي إنهم يعانون نقصًا حادًّا في مؤشّرات أساسية مثل التعليم والصحة ومستوى المعيشة.
في مثل هذه الظروف، يتغيّر أفق التفكير تلقائيًّا: ينشغل الناس بتأمين احتياجات الأسبوع أو الشهر بدل التخطيط للمستقبل البعيد، فتؤجَّل مشاريع التعليم والسكن والعمل، وتُفضَّل الخيارات السريعة والأكثر أمانًا لأنّ المستقبل نفسه غير مضمون.
هذا ليس ضعف وعي، بل استجابة طبيعية لضغط قاسٍ.
ومن القيم التي انكمشت أيضًا قيمة المجال العام. فالمشاركة في العمل المدني والمبادرات المجتمعية الواسعة تراجعت لصالح الانشغال بالشأن الأسري المباشر. كلفة الانخراط العام أصبحت أعلى، بينما أثره بدا أضعف في نظر كثيرين.
لذلك يميل الناس إلى الانكفاء على دوائرهم القريبة. هذا الانسحاب لا يدل دائمًا على اللامبالاة، بل قد يكون وسيلة حماية نفسية في بيئة غير مستقرة.
في المقابل، لم تُنتج الحرب تآكلًا فقط، بل أنماط تكيّف أيضًا. ظهرت مرونة أعلى داخل الأسر، وتعدّدت مصادر الدخل، وتقوّت شبكات التكافل بين الأقارب والمعارف.
كما برزت واقعية حذرة بدل التفاؤل السريع؛ ارتفعت عتبة التصديق، ولم تعد الشعارات الكبيرة تقنع بسهولة.
وبالتوازي، ظهرت نزعة أقوى نحو النجاة الفردية، حيث صار كثيرون يقدّمون الأمان على الفرص في السكن والعمل والإنفاق، ويفضّلون السيولة والعلاقات الشخصية على المسارات الطويلة والإجراءات غير المضمونة. هذه أنماط تكيّف مفهومة في بيئة مضطربة.
لكن بيئة الحرب أفرزت أيضًا سلوكات سلبية لم تكن بهذا الاتساع من قبل. مع ضعف الدولة وغياب الردع، برزت لدى فئة محدودة مظاهر مثل الابتزاز وقطع الطرق والسطو المسلّح والاحتيال وفرض الإتاوات غير الرسمية والاتجار بالمساعدات،
إضافة إلى الاستعداد للقتال مقابل المال واتساع اقتصاد السلاح والتهريب. هذه السلوكات لا تعبّر عن طبيعة المجتمع، بل عن بيئة انخفضت فيها كلفة المخالفة وارتفعت جاذبية الربح السريع في ظلّ انسداد الفرص.
وإذا كان أثر الحرب قد أعاد تشكيل سلوك الكبار وأنماط تفكيرهم، فإنّ أثره الأعمق يظهر بوضوح عند الأطفال الذين كبروا في سنواتها. هؤلاء لا يحملون فجوات تعليمية فقط، بل آثارًا نفسية عميقة أيضًا.
ملايين منهم، بحسب تقارير دولية، تعرّضوا لانقطاع دراسي مُتكرّر وضغوط نفسية مستمرّة، ونشؤوا في بيئة خوف وعدم استقرار.
ينعكس ذلك في ارتفاع القلق وضعف التركيز وتراجع الدافعية للتعلّم. لذلك لا يقتصر التحدي على إعادة الأطفال إلى الصفوف، بل يمتدّ إلى إعادة بناء الإحساس الداخلي بالأمان والثقة. فترميم المدرسة أسهل من ترميم الشعور بالأمان داخل الطالب.
بعد كلّ هذه السنوات، خرج المجتمع بميزان قيم مختلف تشكّل تحت الضغط، ولم يعد ذلك مجرّد أثر جانبي للصراع بل نتيجة مركزية له؛ إذ تبدّلت أولويات الناس وأنماط ثقتهم وطرق حكمهم على الأفعال والقرارات.
هذا التحوّل مفهوم في سياق الخوف وعدم اليقين، لكنه يصبح خطرًا إذا تُرِك ليتحوّل إلى نمط دائم يوجّه السلوك العام ويُعيد إنتاج الهشاشة حتى بعد توقّف الصراع.
لذلك لا يكفي أيّ مشروع جاد للتعافي أن يركّز على السياسة والاقتصاد وحدهما، بل يحتاج قبل ذلك إلى إعادة الاعتبار للإنسان نفسه، لاستعادة الثقة، وترميم الحسّ العام، وتصحيح ميزان الصواب والخطأ في تعامل الناس بعضهم مع بعض ومع الشأن العام.
فاستقرار بلا تعافٍ قيمي يظل سطحيًّا، وإعمار بلا ترميم اجتماعي يبقى قابلًا للتآكل، بينما يبدأ التعافي الحقيقي حين يستعيد المجتمع بوصلته الداخلية، لا حين تتحسّن أرقامه فقط.
جلال المحمدي
باحث وأكاديمي يمني.