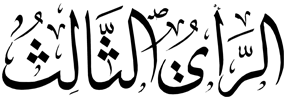الوحدة اليمنية... المنجز المبلل بدم الغبن والنضال الجنوبي (1 – 2)
لا تفوت مناسبة سياسية لذكرى تحقيق الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي إلا ويحضر معها السجال السياسي المحتدم، مثيراً الحديث عن جدوى المشروع الذي ولد صبيحة الـ22 من مايو (أيار) 1990 ساحباً معه سلسلة تقييمات جدلية تراجع التجربة ومدى جدواها من عدمها. تتحدث إحداها عن فشلها باجتياح القوات الشمالية للجنوب إثر حرب صيف 1994 ومن ثم آن الأوان لإعادة الأمور إلى عشية توقيع الاتفاق بين الرئيسين الأسبقين، علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض،
وهو صوت علا منذ عام 2007 وتعبر عنه قوى جماهيرية وسياسية علانيةً، وترفع علم الدولة الجنوبية الذي كان معتمداً في مرحلة ما قبل وحدة البلدين.
في المقابل، يتمسك طرف بخيار إصلاح مسار "المنجز التاريخي" الذي جاء تتويجاً لنضالات اليمنيين عبر إقامة دولة اتحادية من أقاليم عدة مثلما تضمنت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني (2013 – 2014).
وفي خضم الذكرى يبلغ الجدل قمة السلطة الشرعية التي تتقاسمها قوى سياسية من ضمنها تلك التي تتبنى خيار "فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية"، وطرح شعبي جنوبي يستذكر بحنين جارف الدولة التي سادت منذ الاستقلال عن الاحتلال البريطاني في عام 1967 ثم غابت في إطار دولة الوحدة الاندماجية وهو التلاشي الذي تسرده رواية قطاع واسع من الجنوبيين في الأقل.
من الحنين إلى الأنين
مثلما تعترف كل القوى اليمنية بـ"القضية الجنوبية"، لا يبدو الأمر بالنسبة إلى الجنوبيين مجرد نوستالجيا لماضٍ جميل تهفو إليه الأنفس بفعل الواقع الصعب الذي يعيشه اليمن اليوم شمالاً وجنوباً، ويعبر عنه الركام الرهيب الذي خلفته آلة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني منذ عام 2014، ولكنها حسرة على دولة يرون أنها جرى سُلمت بلا هدى للحليف الشمالي الذي كان يقوم على نظام تقليدي مختلف كلياً.
عقب سلسلة تحولات وأزمات سياسية دامية توحّد شطرا البلاد تتويجاً لمبادئ وأهداف ثورتي الدولتين في ستينيات القرن الـ20، ممثلتَين بثورة الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962 ضد حكم الأئمة في الشمال، وثورة الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) 1963 في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني، مدعومتين بآمال الفكر القومي الداعي إلى "الوحدة العربية".
وخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات كانت آمال الوحدة بين شطري اليمن تتجلى وعقب ماراثون من المفاوضات التي رعتها دول عربية، أعلن زعيما البلدين، علي عبدالله صالح عن الشمال، وعلي سالم البيض عن الجنوب، نقل الحلم اليمني إلى أرض الواقع بوحدة اندماجية أُعلن عنها صبيحة الـ22 من مايو 1990 في خطوة عُدت تالياً بـ"العاطفية والمتسرعة" كونها لم تُدرس كما يجب لضمان نجاحها ولم تراع نواح عدة للمشروع،
أهمها تركيبتي الدولتين وخلفيتيهما السياسة والأيديولوجية والفكرية، وطريقة الإدارة والأبعاد الدولية إذ أُعلنن في أوج الحرب الباردة التي كان لها انعكاسات على طبيعة المشهد الوليد وتبعاته.
تحول الحلم الجميل الذي اجترح لأجله اليمنيون نضالات مشهودة غرسها الجنوبيون تحديداً في وعي الأجيال المتعاقبة، إلى غبن دام وكابوس ما زالت امتداداته ماثلة إلى اليوم يعبر عنها الجدل المستعر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها انكسارات عميقة في وجدان صانعيه والحالمين به على السواء، إذ واجه اليمن الموحّد أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة،
فضلاً عن الاختلاف الناشئ في رؤى الحزبين الحاكمين "المؤتمر الشعبي" في الشمال و"الحزب الاشتراكي" في الجنوب، انعكس على بنية الدولة وأداء الحكومة بفعل مساعي الاستئثار بالسلطة ثم التنافسية وتدافع الإزاحة التي أطلت منذ الأيام الأولى لـ"دولة الوحدة".
هذا الصراع جاء على حساب برامج التنمية والخدمات التي ينتظرها الناس عقب تحقيق "الحلم الكبير" ودخلت البلاد في متاهة التوافقات الشطرية وظل نجاح أية خطوة تراعي مصالح الناس مرتبطاً بمدى توافق المؤسسات السلطوية والتنفيذية المتقاسمة للقرار في الدولة، فبدأ التراجع ملحوظاً على كل مستويات الحياة وتفاقم الصراع نتيجة حواجز اتخذت أبعاداً سياسية وقبلية ودينية تضافرت في ما بينها لمنع تنفيذ بنود اتفاق المشروع ومواد الدستور التي ترسي نظام حكم مدني وديمقراطي،
كذلك فشلت مساعي دمج القوات المسلحة، والشرط الأخير عُد نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين هيأت الظروف للانفجار الدامي.
تفجر الخلاف
لعل أبرز الأسباب التي أوجدت صدعاً في جدار الوحدة، بحسب سردية قادة الجنوب، هو سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت نحو 120 شخصاً من قياديي "الحزب الاشتراكي" حملت طابعاً سياسياً واضحاً ومثلت عنواناً بارزاً لمستوى أزمة الثقة،
وأولى بوادر التراجع الجنوبي عن الاستمرار في الشراكة على رغم التنازلات الجنوبية الكبيرة لأجل تحقيق الوحدة ممثلةً بالتخلي عن العاصمة الجنوبية عدن، والموافقة على اختيار صنعاء عاصمة لليمن الموحد، وتنازل الرئيس البيض عن الرئاسة إلى منصب نائب الرئيس صالح والتشارك الكامل بالثروة والسلطة لمصلحة الشمال ذي الغالبية السكانية.
تجلت مظاهر الخلاف باعتكاف نائب الرئيس الجنوبي البيض وعدد من المسؤولين من أعضاء "الحزب الاشتراكي" في عدن ورفض الوساطات للعودة إلى عاصمة الوحدة صنعاء، وصولاً إلى حد الاختفاء عن المشهد السياسي بصورة تامة.
وعقب محاولات إقليمية وأممية لرأب الصدوع التي اتسعت بفعل الخلاف العميق الذي يدور في غالبيته حول القضايا السياسية والمسائل التنظيمية، إلا أنها لم تمنع تفاقم الأمور عندما بدأت رواسب العدالة التاريخية واختلاف تجربة كل منهما في الحكم تطل برأسها، مع دخول مسؤولي البلدين ممثلين بالحزبين الحاكمين، "المؤتمر الشعبي العام" يسانده "حزب الإصلاح" ذو المرجعية الإخوانية، و"الحزب الاشتراكي" اليمني، وصولاً إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين عام 1994،
وانتهت باجتياح القوات الشمالية عدن وبقية المحافظات الجنوبية تحت شعار "الشرعية والحفاظ على اللحمة الوطنية ومجاهدة المد الشيوعي" بفتاوى وحملات تحشيد دينية متطرفة لا تزال تثير أسى وسخط الإنسان الجنوبي حتى اليوم.
يوجد إقرار واسع في اليمن بأن نظام علي عبدالله صالح، عقب اجتياح الجنوب بروح المنتصر، عمد إلى تقليص مهمات معظم الوزراء والمسؤولين والقادة العسكريين التابعين للحزب الاشتراكي على رغم معارضة كثير منهم الحرب وقرار الانفصال.
كذلك يرى قسم كبير من اليمنيين وخصوصاً في الجنوب أن آلة حرب عام 1994 أزهقت روح الوحدة السلمية الطوعية القائمة على الشراكة في السلطة والثروة،
واستبدلت بها مشروع "الضم والإلحاق" القائم على القوة والغلبة وإلغاء الآخر، وهو اعتراف أقره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحالي، رشاد العليمي في كلمته التي ألقاها لمناسبة الذكرى الـ35 "للعيد الوطني للجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو" مساء الأربعاء الماضي، التي قوبلت بارتياح جنوبي غير مسبوق،
إذ وصف العليمي مشروع الوحدة اليمنية بأنها "كانت مبادرة جنوبية بامتياز وأن الاحتفاء بها اعتراف متجدد بالأخطاء والتزام تصحيح مسار القضية الجنوبية ومعالجة المظالم والضغوط التي تعرضت لها في الماضي"،
مؤكداً أن "الروح الجنوبية كانت سبّاقة إلى الحلم الوحدوي نشأةً وفكراً وكفاحاً فكان النشيد جنوبياً والراية جنوبية والمبادرة جنوبية بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا ونبل المقاصد".
المسرّحون عنوان الرفض
وبروح المنتصر، مارس "نظام صالح" سياسات إبعاد قسرية من الوظيفة العامة في حق كوادر الجنوب خصوصاً من السلك العسكري على رغم كفاءة الكوادر الجنوبية المجربة.
وأطلق النظام محشوداً بآلة دينية أيادي القوى التقليدية المتنفذة التي كانت توالي بريطانيا خلال احتلالها الجنوب قبل الاستقلال عام 1967 للسطو على الممتلكات العامة والخاصة بداعي "عودة الحق لأهله"،
مما اعتبره مراقبون حال انتقام من "ثورة أكتوبر" وقيمها العادلة وهو ما ضاعف المظالم وفاقم الأزمات وأوغل في الجرح الشعبي.
تعقّد وساء المشهد السياسي في البلاد ككل وشهد عام 2007 ظهور أول الاحتجاجات المعبرة عن التوق الجنوبي الجارف لدولته السابقة استمرت على رغم حال القمع التي قوبلت بها.
وتصاعدت المطالب حتى وصلت إلى حد المطالبة بـ"فك الارتباط والاستقلال".
التحقت قطاعات واسعة من أبناء المحافظات الجنوبية بقوى "الحراك الجنوبي" الذي اندلع عام 2007 باحتجاجات سلمية وفعاليات مدنية على يد "الضباط المسرحين" الذين شكلوا النواة الأولى للرفض الشعبي ضد النظام القائم بعدما رأوا أن خيارات الشراكة في دولة الوحدة باتت منعدمة جراء حال الازدواج التي تعتري طبيعة التركيبة السياسية للبلاد وإدارتها، يعززها التهميش في الوظيفة مع اتهام بطمس وتجريف الهوية التي يتهمون بها القوى الشمالية، حتى جاء الاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى لتصيب الوحدة، وفقاً لمراقبين، في مقتل.
إزاء كل الغبن كانت السلطة تتعامل بتجاهل تارةً، وتخوين وقمع تارةً أخرى. وعلى رغم سعى علي صالح (1978 – 2012) إلى استيعاب قادة الحراك في السلطة فإن ذلك لم يهدئ الشارع الملتهب بل زاده سعيراً.
الإجراءات ذاتها انتهجها الخلف الجنوبي، الرئيس السابق عبدربه منصور هادي (2012 – 2022) عندما سارع إلى تعيين مستشارين وقادة عسكريين محسوبين على الحراك من دون إحداث تغييرات عميقة تزيل أسباب السخط الشعبي الواسع.
بين تجربتين
عُدت هذه العوامل جرحاً مفتوحاً في الوجدان الجنوبي عززه شعور المهزوم الذي ظل يقاوم هذا الإحساس بصور شتى، أخذت في التصاعد حتى وصلت إلى إعلاء صوت المطالبة بـ"استعادة الدولة".
وبحسب قادة "الاشتراكي" نفسه، لم تكن تجربة الحكم في الجنوب مثالية، ولكنها نجحت في جوانب وأخفقت في أخرى مع الأخذ بجملة التحديات التي كان يعيشها الجنوب من شح الموارد وصراعات بينية دامية.
ووفقاً لسردية قطاع واسع هناك، فالجنوب ذو التركيبة المدنية لسلطة اختارت النهج الاشتراكي نظام حكم، أقام دولة تحكمها القوانين المدنية،
بينما تحدد الأعراف القبلية والقروية في الشمال طريقة حياة الناس بالاستناد إلى نظام حكم خليط من القبائل ورجال الدين والعسكر والتجار والساسة النفعيين.
وعندما كان الهرم الاجتماعي في شمال اليمن ينقسم إلى طبقات عليا ووسطى ودنيا، كان اليمن الجنوبي يعيش حياة مدنية تتساوى فيها فئات الشعب تحت سقف القانون، مع ازدهار موثق في جودة التعليم والتطبيب والرعاية الاجتماعية والأمن والاكتفاء الذاتي.
في الحلقة المقبلة سنواصل مع عدد من الشخصيات السياسية نقاش جدل الوحدة اليمنية والمساعي الجنوبية إلى فك الارتباط وتداعيات عقود من المشكلات التي أوصلت البلد إلى ما يعانيه اليوم.
توفيق الشنواح
صحافي يمني