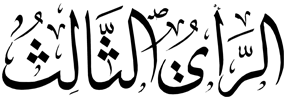مجتمع الأزمات الآتي.. هل يدفع الغرب ثمن اللامساواة؟
ما الذي يجعل فرنسا تسير بوتيرة سريعة نحو هيمنة اليمين المتطرف داخل كل النطاقات، وآخرها المصادقة على قانون يحاصر المهاجرين الذين يشكّلون قوة العمل الرئيسة التي ساهمت في بناء فرنسا غداة الحرب العالمية الثانية؟ وما الذي يجعل الولايات المتحدة، القوة الرأسمالية الأعظم في العالم، تتجه نحو مزيد من تصاعد أشكال اللامساواة التي تدفع بالكثيرين إلى الذهاب نحو اليمين الشعبوي الذي صار دونالد ترامب أحد رموزه؟
هذه التساؤلات لا تقتصر على فرنسا والولايات المتحدة فحسب، بل تنسحب على ما يسمّى بــ "الغرب"، ويشمل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وهي تساؤلات باتت تشمل أيضاً جزءاً من مجتمعات ما يعرف بــ "عالم الجنوب" الذي صارت بعض دوله تتبنّى السياسات الليبرالية.
في كتابه الأخير الصادر عن دار "غاليمار"، يعلن عالم الاجتماع الفرنسي، إيمانويل تود، بوضوح ''هزيمة الغرب"، وهو العنوان الذي يحمله الكتاب نفسه.
أما الهزيمة التي يعلن عنها تود فليست هزيمة حربية أو عسكرية، بل بمعنى تهاوي "سردية الغرب" التي تشكّلت في إثر الحرب العالمية الثانية في إطار مقولة الدولة الوطنية كإطار أيديولوجي وثقافي، يهيكل الوجود التاريخي للمجتمعات الغربية التي أنتجتها الحداثة.
وينطلق تود في رأيه هذا من الحدث الذي هزّ أوروبا، وهو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بيّنت هذه الحرب بالدرجة الأولى تهاوي الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث لا علاقة لهمها الآن بالتاريخ الذي كانا عليه كدول "وطنية" و"قوية" و"مجدّدة". حتى أن تود ينهي كتابه عن الحرب المدمّرة التي تشنها "إسرائيل" على غزة، معتبراً أن "هزيمة واشنطن" وتراجع الولايات المتحدة كقوة مؤثّرة في السياق العالمي، سيسهّل خروج "إسرائيل" من فخ غزة ويتم هذا بدفع من روسيا التي صارت تشكّل منذ الحرب الأوكرانية "الشبح" الذي يجتاح ويخيف أوروبا والغرب.
ولا يحلّل تود هذه الهزيمة من الحدث الأوكراني في راهنيته، بل ينطلق منه كدال على تقلّبات عرفها الغرب لعقود على المستويات الاقتصادية والقيمية والجيوستراتيجية، وهي تقلّبات تتعلّق في العمق بتحوّلات النظام الرأسمالي وطرق اشتغاله والكيفية التي يعيد بها في كل مرة تعريف ذاته.
الغرب والرأسمالية الجديدة.. نقمة وظلم وشعبوية
منذ نهاية العقود "الذهبية"، يعيش الغرب، وأوروبا تحديداً "حالة أزمة'' عبّر عنها عالم الاجتماع والفيلسوف البولندي زيغمونت باومان (1925 - 2017) بــ "عصر السيولة"، حدت بكثير من المفكّرين إلى مراجعة الأطر الفكرية ونماذج تأويل ورواية التجربة الإنسانية في المجتمعات المعاصرة، وهي تجربة تتسم بصعود اللايقين والمخاطر المتعددة، مثلما وصف ذلك بحصافة منقطعة النظير، عالم الاجتماع الألماني أولريش بك (1944 - 2015) في كتابه ''مجتمع المخاطر". وهي مخاطر صارت بموجبها مقولة إن "الغد سيكون أجمل من الحاضر"، التي ارتبطت بوعود الحداثة وأيديولوجيا التقدّم، لم تعد محفّزة للأجيال الجديدة.
ذلك أن وعود التقدّم وتحقيق السعادة والحرية والفردانية المنعتقة من كل إكراه، تبيّنت حدودها منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث انفجرت في أوروبا كما في الولايات المتحدة مطالبات جديدة تتمحور حول مطالب العدالة الاجتماعية والحرية.
وظهر أن تحقيق النمو كان على حساب ذاتيات الأفراد (ولا يزال)، كما على حساب البيئة وحقوق النساء والمهاجرين والأقليات، وأيضاً على حساب الفرد نفسه الذي بات "متعباً أن يكون ذاته"، وفق تعبير الفرنسي آلان إهرنبرغ، حيث عليه أن يهتم بشؤونه في ظل تهاوي أطر الحماية المؤسساتية التي كانت توفّرها دولة الرعاية الاجتماعية في أوروبا. الأمر الذي دعا مؤرّخاً كبيراً كإريك هوبزباوم، إلى التساؤل عن "الشيء" الذي سيحلّ مكان دولة الرعاية.
.jpg)
إذ يقول هوبزباوم إنه: "في القرن الحادي والعشرين، ماذا سيحلّ محلّ الدولة القومية القائمة على الحكومة الشعبية (إذا افترضنا أن شيئاً ما سيحل محلها)؟ لا نعلم، وبالتالي ما كان يعهد في السابق للمؤسسات الاجتماعية صار يعهد للفرد نفسه".
هكذا لم يعد الأفراد يحيون بالأمان نفسه الذي كانوا يشعرون به في السابق، نتيجة التشظّي والانقسام المفرط واضطرابات الهوية، وفق عبارة الأنثروبولوجي آلان كاييه. فقد بات الأفراد يعيشون في مجتمعات تتطاير فيها الهويات إلى شظايا ممزقة، تحيل الأفراد إلى حالة من التعددية تجبرهم على المكابدة من أجل تحقيق الوجود الذاتي.
كل هذا في ظل ضعف الروابط الاجتماعية وإعادة تشكيل عالم عمل لم يعد اجتماعياً ومنتجاً للهويات المهنية الصلبة، بل مجالاً لتنافسية سامة يعمل فيها المسيّرون الجدد وأرباب العمل غير المرئيين، على إضفاء بعد نفسي على عالم العمل بطريقة تجعله مجرّد تجربة ذاتية يتحمّل فيها الفرد وزر نجاحه وفشله في آن. فالنجاح والفشل في أي عمل صار موكولاً للفرد وحده، ولمدى قدرته على التأقلم مع إكراهات النظام.
لقد أصبح الاستغلال الحاصل اليوم في عالم العمل لا يقوم على الانتفاع من القوة الجسدية للعمل، بل ينحو أكثر إلى توظيف الرغبات واستغلال العواطف والمشاعر الدفينة للفرد، كشعور الحب والرغبة في التضحية والنجاح، بطريقة يغدو معها الفشل والنجاح المهني قصة تعاش على المستوى الذاتي والفردي.
إن الفردنة المتسارعة في عالم العمل أضعفت أطر التنشئة المهنية التقليدية على غرار النقابات والأحزاب الجماهيرية، التي لم تعد قادرة على تعبئة الغاضبين في أطر أيديولوجية مغلقة مثل مقولة الصراع الطبقي (النظرية الماركسية اللينية). فالصراع الاجتماعي لم يعد يتمحور حول عالم العمل مثلما عهدت ذلك المجتمعات الغربية منذ القرن التاسع عشر إلى حدود ستينيات القرن الماضي. وكذلك الأمر بالنسبة للفاعلين الذين لم يعودوا يتحدّثون بلغة اجتماعية وسياسية كما كانوا ماضياً، بل بلغة معيارية وقيمية تتعلق بالعدالة والاعتراف، وكل ما يتصل بالحميمي والذاتي لخلق تضامنات وأطر فعل جديدة وأشكال مستحدثة للالتزام السياسي.
في هذا الصدد، يذهب الفرنسي فيليب كوركوف إلى التأكيد أنّ الصراع الاجتماعي لم يعد قائماً على التناقض بين العمل وبين رأسمال، بل أساساً بين رأس المال والفردنة، حيث تتيح الرأسمالية الجديدة مجموعة من القيم المتعلقة بتحقيق الذات والنجاح الفردي والمتعة الاستهلاكية، لكنها في الوقت عينه تعمّق اللامساواة بين الأفراد التي تتحوّل إلى إحباطات عميقة تدفع بالكثير ممن لم ينخرطوا في عالم العمل والاستهلاك إلى اللجوء لمسارات هوياتية انطوائية، كالراديكالية الإسلاموية في الضواحي الفرنسية، أو مجموعات اليمين المعادية للمسلمين والمهاجرين.
يؤسّس هذا المعطى الجديد لاقتصاد أخلاقي لم تعد المعارضات من خلاله قائمة بين تشكيلات وطبقات اجتماعية، بل بين هويات تنازع من أجل الاعتراف بها. هذا ما تؤكده بعض الأبحاث الاجتماعية في فرنسا حول الضواحي الفرنسية التي صارت شبيهة بـــ "غيتوات السود" في الولايات المتحدة. ولذلك بات من الصعب التفكير بما يجري في هذه الضواحي بمنطق المعارضة، بل عبر تغيير زاوية النظر ومقاربة الصراع الاجتماعي بلغة المسافة. أي بين من هم مندمجون بشكل كامل داخل نطاق العمل والاستهلاك، وبين من هم خارجه.
وهنا يصبح التعارض بين "نحن" و"هم" تعارض تحرّكه مشاعر النقمة والشعور بالظلم والضيم، وكل تلك الأهواء الحزينة التي تحدّث عنها الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا. يشكّل اليوم المجال الحيوي الذي تزدهر فيه الحركات الشعبوية اليمينية والدينية في أوروبا التي تعبّىء المقصيّين من مجتمع النمو المتسارع الوفرة الاستهلاكية في اتجاهات متعددة. فنرى النقد الحاد ضد النخب الرسمية لكونها "فاسدة'' ولا تمثّل الشعب "الحقيقي"، بالتوازي مع تصاعد معاداة المهاجرين بوصفهم تهديداً للصفاء العرقي والثقافي المزعوم في مجتمعات الاستقبال.
وفي الآن ذاته، تنكفئ المجموعات المهيَمن عليها (المسلمون كجماعة ثقافية في أوروبا وغيرهم) في هويات شبه مغلقة أقرب إلى الطوائف، على نحو يؤسس لمجتمعات تقوم على التنوّع في الظاهر. لكنه تنوّع خادع حيث الحدود غير المرئية تحكم كل الحياة الاجتماعية بدءاً من الانتداب في الوظائف، والعلاقات البيداغوجية داخل المدرسة، وصولاً إلى الممارسات البوليسية العنيفة في أحياء الضواحي الفرنسية.
.jpg)
الديمقراطية الليبرالية.. مركب يترنّح
تطرح التحوّلات المذكورة آنفاً أسئلة تتعلق بأزمة الديمقراطية الليبرالية كما صيغت في الغرب. فقد بات التساؤل الطاغي هو: هل بتنا نعيش في سياق عالمي يتميّز برفض نموذج الديمقراطية الليبرالية واستبدالها بالسلطوية الشعبوية؟
ملامح الإجابة عن هذا السؤال تعطي دلالات قوية في اتجاه الشعبوية، يمكن ملاحظتها في الولايات المتحدة مع انتصار دونالد ترامب وإمكانية عودته إلى الحكم، وكذلك في الهند مع مودي وفي تركيا إردوغان.
أما في أوروبا، فإن العودة إلى السلطوية تسير في اتجاه متسارع مثل حكم أوربان في المجر ودودا في بولونيا، في حين تقوى في فرنسا ودول أوروبية أخرى كالنمسا تشكيلات اليمين في اتجاه الوصول إلى السلطة. وبالتالي صار الانزياح نحو اليمين واقعة عالمية مثيرة للقلق في ظل تعدّد وتباين التفسيرات حولها.
ومن بين التفسيرات السائدة لتصاعد اليمين تأكّل العلاقة بين المواطنين والمحكومين، ما يدعو إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية لتفسير النطاق السياسي، الذي خرج من الإطار الأيديولوجي باتجاه تحكمه الكراهية وغياب الثقة.
إذ ينظر اليوم إلى النخب بوصفها جماعة تمارس فوقية واحتقاراً ضد عامة الشعب والمقصيّين اقتصادياً واجتماعياً. لكن من ناحية أخرى يستفيد القادة الشعبويون من أزمة الدولة الوطنية التي انبنى وجودها على السيادة، وهي أزمة ترتبط اليوم بإعادة تعريف دور الدولة (غنية أو فقيرة) العاجزة عن السيطرة على اقتصادها الوطني في ظل الرأسمالية الجديدة.
ذلك أن اقتصاداً كبيراً كاقتصاد الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصبح اليوم رهيناً للاقتصاد الصيني، ما يجعل من ثنائيات الشمال والجنوب التي صيغت في بعض الأدبيات الماركسية تفقد قوتها التحليلية والتأويلية الكافية.
هكذا يعمل القادة الشعبويون اليوم (مثل ماري لوبان في فرنسا)، على استخدام سجل خطابي يعلي من قيم الزعامة والسيادة الوطنية كآلية لترسيخ الهيمنة بغية الوصول إلى السلطة والتعبئة في الحملات الانتخابية. كما أنهم يستعيدون القيم التقليدية المحافظة كفكرة العائلة والدين وغيرها من الروابط، التي شكّلت ذاكرة الأجيال المحبطة من حاضر تهيمن عليه الفردانية وقيم اقتصاد السوق النيوليبرالي.
أزمات مركبة.. أزمات معولمة
لم تعد الأزمات التي يعرفها العالم المعاصر محلية بل معولمة أساساً، وتالياً فإن أزمات الغرب ترخي بثقلها على بلدان "الجنوب" ويعاد إنتاجها على مستوى عالمي.
أزمات الغرب اليوم متعددة ومركّبة تتراوح بين "أزمة السترات الصفراء" في فرنسا، و"الأزمة الصحية" و"أزمة الأقليات" وأزمة "النوع الاجتماعي" و"الأزمة الأيديولوجية". كلها أزمات ترتبط بأزمة أكثر شمولية هي "أزمة النيوليبرالية" أو "أزمة الرأسمالية"، وتعبّر هذه الأزمات عن "مجتمع آتٍ".
هذا الأمر يعني أن التفكير في المجتمعات المعاصرة عموماً والغربية خاصة، يجب أن يتم عبر براديغم القطيعة. إذ تتهاوى الديمقراطية وتتصاعد اللامساواة، وتضع التحوّلات المناخية بثقلها على الفاعلين في السياسات العامة. علماً أن هذه اللحظة الحرجة التي يعرفها الغرب والمجتمعات المعاصرة، لا يمكن إدراكها بلغة الأزمة فحسب، بل كلحظة مقاومة تتزايد فيها أشكال التعبئة ضد الرأسمالية وغياب العدالة على مستوى عالمي.
ولقد كانت "الثورات" العربية جزءاً من هذا النقد العالمي للظلم واللامساواة، لكنها فشلت بأدوات النيوليبرالية نفسها. ففي اللحظة التي كانت الاحتجاجات تتصاعد في عواصم عربية، كانت القوى المهيمنة تعبّئ نخبها المعولمة لدعم وترسيخ السياسات نفسها التي أدت إلى تلك الاحتجاجات.
لماذا يتعلق العرب بالغرب؟
يرى المؤرخ التونسي هشام جعيط، أن الغرب من منظور عربي هو ذلك المكروه المحبوب. ذلك أن العرب رغم عقود من الاستقلال لا يزالون يعيشون الغرب كمأزق وإشكالية ويبالغون في فهم مشاكلهم من خلاله، إلى الأمر الذي تغدو فيه الحروب الطائفية والأهلية والأزمات الاقتصادية مؤامرة وصناعة غربية.
فأزمات الغرب لم تدفع صنّاع القرار في العالم العربي إلى صياغة مشاريع تحررية، وتطوير نظرة استراتيجية لمستقبل المنطقة، بل إن الذي يحدث هو تعميق التبعية للغرب بوصفه قوة مهيمنة.
كلّ هذا يتم تحت رعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتواطؤ جزء كبير من النخب المحلية المعولمة. ذلك أن سردية الغرب تسكن مجتمعاتنا وتقوّي "الرغبة في الغرب"، بعبارة الباحث التونسي وائل قرناوي، وهي رغبة تدفع بالكثير من الشباب العربي إلى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا حيث يموت الآلاف في الطريق نحو "الجنة" الأوروبية المأزومة.
المراجع
Emanuel Todd, La défaite de l'occident, Paris, Gallimard, 2024,
Alain Ehrenberg, la fatigue d'être soi, Paris, Odile Jacob, 1998
Ulrich Bek, la société du risque : sur la voie d'une autre modernité, Paris, Aubier, 2001.
Robert Castel, La montée des incertitudes, Paris, Seuil, 2009.
Didier Fassin, La société qui vient, Paris, Seuil, 2022.
Garnaoui Wael, Harga et désir de l'Occident, Tunis Nirvana, 2022.
* فؤاد غربالي