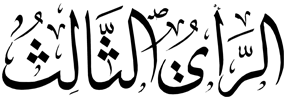تغريبة يمنيّة في "عمى الذاكرة"
لا تُعرِّف جائزة كتارا للرواية العربية الجمهور بأسباب منحها لدى المحكّمين لهذا العمل أو ذاك.
وبذلك، لك أن تَحزَر، مثلاً، "حيثيّات" تكريم رواية "عمى الذاكرة" (منشورات جدل، الرياض، 2024) لليمني، حميد الرقيمي (أظنّه في الثلاثين عاماً)، الشهر الماضي، بواحدةٍ من جوائز الروايات الثلاث المنشورة.
ومع كلاسيكيّة سرد الراوي العليم وقائع النص، بألف بائيّةٍ تقليديّة، فإنك سترى عناصر أخرى مايزت الرواية التي تعرّفنا على كاتبها، وهي الثانية له، عن غيرِها من أعمالٍ نافستْها.
وفي ظنّ صاحب هذه المقالة أنّ ما يجوز تسميتها الرّهافة الضافية في لغة الراوي (الكاتب بداهة) ربما أغوت من صعّدوا (من هم؟) الرواية إلى الفوز.
وفي ظنٍّ آخر، ما أعطى هذه الرهافة التي قد نُصادفها (أو في منزلتها) في نصوصٍ غير قليلة الجدارة في "كتارا" أنها مبثوثةٌ وظاهرةٌ في حكي الراوي عن الحرب،
أو الأصحّ الحروب، في اليمن، والتي ظلّت وراء الشعور بالفقد، بالخسران، بالتيه، بالنقصان، بالانكسار، بالخوف، بالحرمان، الشعور المتوطّن عميقاً في نفس البطل، بدر الذي يصير يحيى، منذ طفولتِه في قريته في اليمن، مروراً في عيشِه في صنعاء،
ثم في دراسته الجامعية التي لا يُنهيها بسبب الحرب، ثم رحيله إلى القاهرة فالسودان فمحاولته الهجرة عبر صحراء ليبيا إلى أوروبا، وحتى مختتم الرواية عندما يلقى نفسَه في مستشفى في إيطاليا.
سيكون من الشطط أن تعدّ "عمى الذاكرة" رواية التغريبة اليمنية، لكنها، بالتأكيد، مقطعٌ من هذه التغريبة، يضجّ بالرهافة، وبلذّة البساطة.
ولئن يراها مُتطلّبٌ ذوّاقة في الرواية أشبه بحدّوتةٍ عن فتى أخذتْه مقادير الحياة، شابّاً، في أتون الحروب، إلى مجازفات الروح المتطلّعة إلى أشواق الخلاص من تعاسة قتل الأحلام بحياةٍ طبيعيةٍ يستحقّها البشر في أي مكان، لئن نُظر إليها هكذا، تهويناً من جدارتها بجائزة مقدّرة،
فهذه وجهة نظر لستُ أظنّها ممتلئةً بوجاهة كافية، غير أن قولاً موازياً يجوز تنويهٌ لازمٌ إليه، إن انتباهةً إلى رواية شابٍّ يمنيٍّ مجتهدٍ (ومكافحٍ) يشجّع تكريمُها هذا على الانتباه إلى مشاغل السرود اليمنية الراهنة التي يُنجزها جيل الحرب الأهلية الحادثة هناك منذ نحو عقد.
الحرب التي تتعدّد وجوهٌ لها، فيقول الراوي الذي يرتدي حميد الرقيمي قناعَه "الحرب الأخرى الأكثر ضراوةً هنا في هذه المدينة المنكوبة، على أطراف المدارس المهجورة، وفي أعماق المستشفيات الممتلئة، وعلى أزقّة الشوارع المليئة بالمتسوّلين وساحات الأسواق التي تتقلّص بوتيرةٍ عاليةٍ من المواد.
لا أحد يعرفُ أن الدكتور الجامعي تحوّل إلى بائعٍ متجوّل، وأن المدرّس النزيه صار يبحثُ عن عملٍ عند طالبِه، وهو مطأطئ الرأس".
يُعثر على الطفل ناجياً في واحدةٍ من مجازر حروبٍ يمنيّةٍ لا تتوقّف، إلى جانب والديه المقتولين، فتتبنّاه أسرة، وتصير سيّدةٌ أمّاً له يغادرها زوجها، ثم يُزجي له من يعدّه جدّه بالحكايات، ثم حكايته بعد عشرين عاماً.
يقول "صدّقتُ تلك الحكاية التي كنتُ أعتقد بأنها من وحي الخيال. وعرفتُ لماذا كنتُ مختلفاً طوال تلك السنوات التي عشتُها، بعد أن صنعتْني قذيفة طائشة وأصابت ذاكرتي بالعمى". و"...، عشرون عاماً وأنا أحمل الحرب في جسدي وصوتي وملامحي".
تقتلُ الحرب صديقاً له، كان مُرشدَه وملاذَه وناصحه. تقتل آخرين بلا عددٍ في الرواية الشفيفة، لكنها لا تقتل الحكاية، وهنا مربط الرواية على ما أخمّن، أو أقترح، مدخلاً إلى نصّ حميد الرقيمي الذي يرمي عباراتٍ مثقلةً بالإيحاء، عند وصول الراوي إلى مطار القاهرة، في المرّة الأولى التي يرتحل فيها عن البلاد،
والأولى التي يركب فيها طائرة. "رفاقي معي وهم في نشوة عبورهم الأول. فارغة أيادينا من حقائب المسافر العادي، ممتلئةٌ قلوبُنا بالأسى الذي يُثقل خُطانا، وهاربون من ماضٍ يستحيل التخلّص منه".
ليس مقصد هذه المقالة إيجاز رواية صغيرة (174 صفحة)، ففيها، إلى الموت الكثير، وإلى النجوى عن ذاكرةٍ مُنهكة، الحبُّ والحضور الخاص للمرأة، والغبطة بالجمال والفنون، وإنْ ظلت رواية البحث التائه عن مصيرٍ مجهول،
رواية تتجدوَل في مجرى التغريبة اليمنيّة، المُضنية، حين ينعدم معنى الوطن، فيأخذ شباباً إلى صحراء، إلى "عمق الكابوس"، حيث الوحوش هناك، على ما ذهب وصفها في السطور الأخيرة للرواية، فيما الوحوش في مفتتح الرواية لم يأخذوا اسمَهم هذا،
وهم لا يقتلون فقط والدي الراوي المتكلّم، صاحب حكاية الحكايات هنا، وإنما يقتلون اليمن كله.
معن البياري
كاتب وصحفي من الأردن