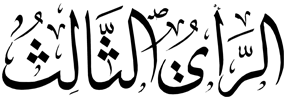خيانة المثقفين العرب: غياب الموقف وحضور التفاهة
(1)
يعنّ أن المثقف العربي توارى إلى الخلْف ملتزما الصمت والخلود إلى الراحة الأبدية، بعيداً عن جلبة ما يجري من تحوّلات رهيبة في بنية المجتمع والعالَم،
بل عاجزا عن مجابهة القضايا المجتمعية والكونية، والصّدح بالحقيقة المؤلمة أمام التغوّل الغربي والمدّ الصهيوني، الذي ينخر الأوطان تحكّما وسيطرة،
والسعي إلى الهيمنة الكُلّية على دواليب الحكم والاقتصاد وتخريب منظومة الأسرة والتربية والتعليم، من خلال فرض توجهات لا تمت بصلة للعقيدة الإسلامية، بقدر ما هي توجيهات مبطّنة مقصديتها القضاء على لحمة المجتمع العربي الإسلامي إن بقي أصلاً،
فهو في جوهره وحقيقته لا وجود له إلا في ذاكرة الأجيال السابقة، بينما الأجيال الحالية تعيش في عوالم بعيدة كل البعد عن الواقع، فهم غارقون في أوهام السوشيال ميديا ووسائط التواصل الاجتماعي حالمين متوهمين أنّ تلك العوالم هي الواقع الحقيقي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الثورة الرقمية كانت جريمة في حق أجيال العالَم المتقدّم، تخلّفا وجهلا، والخارج عن ركبها، ما أفضى إلى ظهور هذه الظواهر الاجتماعية الغريبة عن الواقع القائم على القيم النبيلة والجليلة.
ونعتقد أن الأجيال الحالية، بعد سنوات، ستجد ذاتها تائهة وضائعة، تعاني من انفصامات نفسية وروحية، جرّاء الصدمة الكبرى النّاجمة عن واقع المفارقات،
واقع شرس لا يرحم، واقع لا يؤمن إلا القوة المادية والتكنولوجية، ولا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية،
إنه واقع غابويّ، القويّ يلتهم الضعيف، والعامل يقضي على الخامل، والتطور العلمي والطفرة التقنية الهائلة ستحاصر، نور العلم والتقنية المجتمعات الغارقة في مستنقع التأخر الرقمي والحضاري،
وسيكون هناك بونٌ شاسعٌ بين عالمين متنافرين متباعدين، عالم التكنولوجيا، حيث الآليات الرقمية تسيطر على مظاهر الحياة أكثر وأكثر،
وعالم رازح تحت نير التواكل وتحويل الإنسان إلى عبد للشركات العابرة للقارات والمجهولة الهوية، وسجين الأحلام الوهمية التي تمت بصلة لواقعه ووضعه.
في ظلّ هذا الوضع الكارثي نجد المثقفين العرب في واد، والواقع تجرفه سيول عولمة لا ترحل، لا صوت لهم ولا أثر،
في المقابل ينخرط المثقف الغربي في أسئلة العصر، مبدعاً ومبتكرا وخلّاقا ومقترحاً مساهما في نصرة الحق والعدل والحياة.
فالمجتمعات الحيوية هي تلك التي تنفض عنها غبار التكاسل والتواكل وتنبذ الوصولية والتبعية العمياء، والمستسلمة للمبتذل والرافضة للجوهري والعميق فكرا وإبداعا ووجودا،
وهذا لن يكون إلا بفضل المثقف الواعي والمدرك لأدواره ومهماته الإنسانية، دفاعا عن الجمال والجلال ومقاوما للقبح والابتذال.
(2)
ونقرّ بأن المفهوم التقليدي للمثقف غدا متجاوزاً في عرف ثقافة العولمة المؤسسة لعقيدة فكرية جديدة قوامها التركيز على ترسيخ المصلحة الذاتية والبحث عن الحلول الفردية بكل الوسائل المتاحة، والعمل على تقديم صورة مشوّهة عن الثقافة والمثقفين،
ما انعكس على وظيفة المثقف، فلم يعد له أيّ تأثير على الناس، بعبارة أخرى لم يستطع أن يكون مؤثّرا في الأحداث، ومنغمساً في الواقع بآرائه وتصوراته،
بل استقال من قضايا المجتمع، وانخرط مع القطيع في تفاهات الحياة، في سياقٍ متغيّر ساهم في تقزيم أدواره، وخفوت صوته. ومع ذلك ورغم هذه العراقيل المفتعلة والمتاريس المصطنعة،
ينبغي ألا يظل صامتاً على قول الحق والجهر بالرأي السديد، والوقوف في وجه هذا العتاد الجهنمي الذي تمتلكه القوى العظمى، التي تستثمره لبناء إنسان فاقد للإرادة وللإنسانية، ولتوطين منابت عبودية جديدة تجتهد في بناء مجتمعات على مقاس إمبراطورية الشر،
التي تتزعمها الولايات الأمريكية، بدعم من ذيولها الأوروبية، التي تعيش وضع الضّعف والوهن بفعل الهيمنة الرأسمالية وانهيار الاقتصاد الأوروبي أمام التمدّد الأمريكوصهيوني المتحكم في الاقتصاد العالمي.
لذا على المثقف، اليوم، التخلّص من النرجسية المرضية والأوهام المضلّلة، والسعي إلى مواجهة الشر الإمبريالي، بما يملك من اقتدار معرفي ووجودي، وحصانة فكرية تؤهله لكشف حقيقة هذا الشّر وفضحه بشتى الوسائل والأدوات، سواء المادية أو المعنوية، لإزالة هذا الوضع اللاإنساني الذي جرّد الإنسان من كينونته الوجودية والحضارية، وحوّلها إلى بنزين لإشعال الحروب والصراعات والخراب والدمار.
إن صمت المثقف العربي دليل على عجز الذات على المواجهة، وانتفاء الرغبة لديه لكسر طوق الخوف والوهم، أمام ثورة رقمية تتفنّن في تعليب الكائن وتسليعه، بفعل ما تملكه من قوة في تغليب السطحي والعابر، وإقبار العميق والأبدي.
فما بلغته من فتوحات مثيرة ومحيّرة للعقل البشري تطرح أكثر من سؤال، حول مصير الإنسان أمام هول عولمة جارفة وكاسحة للمعنى.
فاللامعنى مرآة تعكس حقيقة الجهل الإنساني بما يحمله من عواقب وخيمة على الكون برُمّته، وتجسيد للعمى الحضاري الذي يقود العالم إلى الهاوية والفناء الأزلي، بل إنه آلية من آليات إثارة الأهواء والرغبات الحيوانية والشهوانية، التي تغيّب العقل وتنتصر للتقليد.
وما يسمُ المثقف العربي أنه لا يحرّك ساكنا ولا يمتلك طروحات ترج العقل الإنساني، بل يعاني عسرا في الإبداع والنقد، ويفقد صوته أمام عظمة السوشيال ميديا، المكرّسة لثقافة التفاهات والضحالة، نظرا لما تمتلكه من ترسانة رقمية وتكنولوجية، غيّرت بوصلة المعنى إلى متاهات التفكّك القيمي، والتشظي الداخلي.
ونعتقد أن الداعي الرئيس في هذا الوضع المزري والمثير للشفقة يكمن في كون المثقف لم يعد يحمل مشروعا ثقافيّا، وتصوراً للفعل الثقافي بإمكانه انتشال المجتمع مما هو فيه من تخلّف وخمول في التفكير واستسلامه للأمر الواقع، دون أن نغفل دور مؤسسات الدولة، التي قامت بأدوار عكسية تجاه الثقافة، لا باعتبارها قاطرة للتنمية والتطور وبلوغ سلّم الرقي والمكانة الحضارية،
ولكن بتدجين الممارسة الثقافية وإشاعة ثقافة الفلكلور والمواسم والزوايا، ومحاربة كل ما من شأنه تنوير الإنسان وتكوينه وبناءه بناء حقيقيّا، فالصراع قائم بين الثقافة المنبثقة من صلب الواقع وإشكالات العصر واللاثقافة التي تجتهد وزارات الثقافة والمؤسسات المنتخبة وهيئات ما يسمى «المجتمع المدني» على تكريس المظاهر البرّاقة، لكنها فارغة من العمق والأصالة.
(3)
ومن تجليات خيانة المثقف العربي، انخراطه في حروب مجانية ذاتية فوتت عليه مواكبة الواقع والوعي بارتجاجاته وتبدّلاته، ليظل خارج سكة المجتمع بعيدا عنه قريبا من سفاسف الأمور، وتوافه القضايا المصطنعة لتكون موجّهة للقطيع وتجييشه ضد العميق والرصين، ضد ما يحافظ على كينونة الكائن من كلّ انحراف حضاري مبعثه الغطرسة الإمبريالية أولا.
وثانيا سقوطه في فخ التقليد والاحتذاء والاجترار، بدل تقديم الناجع والأفيد والأجدر بالإنسان،
وثالثا أصبح مجرّد موظّف يؤدي واجبه الوطني، ويمشي في الأرض غاضّا بصره وعقله عن حقوق المجتمع في حياة رغيدة، وخلْق مؤسسة تعليمية فاعلة، منتجة ومساهمة في التنمية، ومستشفى يصون صحته العقلية والبدنية ليكون المجتمع سليما ومعافى وليس معتلّا ومختلّا، وفي مؤسسات دستورية قادرة على تكريس العدالة والمساواة، بدل الطبقية وممارسة الظلم بأشكاله المتعدّدة.
ورابعا طغيان الفكر الوصولي لدى البعض، ما أفقد المثقف مكانته داخل المنظومة الاجتماعية.
إن هذه المظاهر صورة تبرز حقيقة الخيانة التي تعرض لها المجتمع العربي من لدن حملة الحلم والخيال، الذين انسلخوا عنه ليقيموا في أبراجهم المشيّدة بالأوهام.
(4)
لا مندوحة من القول إن طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما نتج عنه من تداعيات رهيبة، كشف حقيقة الصهيونية وعقيدتها ومخططاتها الجهنمية،
التي بلغت شراستها البغيضة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، من خلال، التقتيل والتهجير والتجويع والحصار، عرّى العالم الغربي وشعاراته وعقلانيته وأنواره المظلمة في حقيقتها،
بل يمكن اعتبارها مجرّد أقنعة أو وسيلة للتحكم في رقاب العالم المتخلّف، كما فضح المثقف العربي الذي يكتفي فقط بالبيانات دون التفكير في اتخاذ إجراءات ملموسة للتأثير على أصحاب القرار في العالم العربي، من خلال استثمار الوسائط الاجتماعية لتمرير مواقفها وتصوراتها ورؤاها للتأثير في المجتمع،
لكن كل هذا لا يعدم وجود مثقفين جهروا برأيهم وعبّروا عن مواقفهم. بينما «اتحادات الكتاب» في الوطن العربي لزمت الصمت، وانتبذت الزوايا الضيقة المعتمة تجتر صراعاتها وحروبها حول المكاسب الآنية؛
لم تستطع توحيد مواقفها لإدانة العدوان الصهيوني بالقول والفعل. والإدانة التي نقصد لا تشبه إدانة الحكام العرب، وإنما بوساطة التعريف بالقضية الفلسطينية وإيصال محنة الإنسان الفلسطيني في غزة إلى العالَم،
والراجح أن موالاتها للأنظمة الحاكمة والاستفادة من ريعها ومؤسساتها من بين العوامل التي شلتّ قوة هذه الاتحادات التي تجاوزها التاريخ والعصر.
(5)
إذا كان المثقف العربي في الستينيات والسبعينيات، نوعا ما، حمل مشعل الثورة والتغيير ضد الواقع المتخلف، ومقوّضا الأنساق الاجتماعية المهيمنة والمواضعات المكرّسة بنيويّا ومؤسساتيّا، وحالما بأفق مشرق لواقع أكثر تقدّما وتنويراً وعقلانيّا،
فإن مثقف الألفية الثالثة تنكّر لهذه التركة العظيمة أمام انهيار اليقينيات والسرديات الكبرى والتشكيك في الانتماء إلى عالم يسمى «عربيا إسلاميّا» إضافة إلى واقع الخذلان والخنوع والإحباط،
وقد نتفق مع هذا المثقف، لأن السياقات تختلف ومفهوم المثقف النسبي والمتحوّل، مع ذلك، أمام الملمّات والأحداث الجسام وما يحدث في غزة من هولوكوست في حقه، ضدّا على الحق والحياة
يجب على المثقف الانخراط الفعلي والحقيقي للوقوف إلى جانب الفلسطيني كإنسان من حقه الاستمتاع بالحياة، واسترجاع أرضه المغتصَبَة بكلّ ما يملك من قوة فكرية ووجدانية، لفضح جوهر العقيدة الصهيونية.
وأن يكون في طليعة المجتمع ويستغل مؤهلاته، بوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة لإسماع صوت الحق والجهر به، في ظلّ تغوّل الرأسمالية الصهيونية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
فما يقع في غزة من ممارسات لاإنسانية من لدُن الصهاينة مسؤولية ملقاة على عاتق المثقف وأمانة يحملها نيابة عن المجتمع العربي، بفعل الاقتدار على الحديث والتواصل مع الآخر الغربي الذي أصبح عربيّا أكثر من العربي، حيث نجد المثقف الغربي دائم الحضور في كل الأشكال النضالية المساندة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية،
بعد أن تيقّن من أن الصهيونية تقود العالم إلى نهايته، وأنها عدوة الإنسان المختلف معها عقديّا، ولأن عقيدتها دموية. وهنا الفرق قائم بين المثقف الغربي المناصر والمثقف العربي المتخاذل والخائن.
هذا الوضع يثير أسئلة متعلقة بالأدوار الكفيلة للمثقف العربي ليس بالمفهوم الغرامشي، ولكن بالدلالة الإنسانية والوجودية التي تفرض على من يحمل شعلة التفكير والمعرفة،
الإسهام الفعّال في تحويل الثقافة طريقة من طرق الدفاع عن الوجود الفلسطيني، وأداة من أدوات المواجهة مع عدوّ يمتلك ترسانة عسكرية وتكنولوجية، ويمارس الإبادة الجماعية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أمام عجز المنتظم الدولي لردع الاحتلال الصهيوني. وعلى المثقف العربي إذا أراد أن يكون له مفعول على المجتمع وضع مسافة بينه وبين السلطة،
هذه الأخيرة تعمل جاهدة على الحطّ من دوره وتبخيسه، والانتقاص من تأثيره بتشجيع ثقافة الأضرحة لأن الثقافة ـ كما قال محمد الدغمومي – «حرث يسعى إلى تشجير كل الصحاري التي تحاصرنا».
هذا الحرث يتطلب قوة مثقف جدير بتحمل مسؤولياته التاريخية والحضارية، وإرادة حقيقية لاستعادة المكانة اللائقة به.
(6)
أعتقد أن مهمة المثقف العربي لا تنحصر في الكتابة والإبداع، بل تمتد إلى تحمّل المسؤولية التاريخية تجاه المجتمع، من خلال، تنويره وتبيان أعطابه والبحث عن الحلول الناجعة لقضاياه والانخراط في الدفاع عنها، بعيدا عن أيّ شوفينية ذاتية ونرجسية،
خصوصا في ظلّ مجريات مؤلمة ومخزية للذاكرة الجمعية وتاريخها وحضارتها ووجودها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في وظائفه والتفكير مليّاً في تغيير النظرة إليه، باعتباره منتج خيال فقط،
بل إنه الطريق المفضي إلى نور المعرفة والعقل، وهو صانع الجمال خَلْقاً والمعبّر عن الواقع بما يحفل به من أوضاع ووقائع تستلزم الانخراط الفعلي في الدفاع عن الحق العربي في التقدّم والتطور والحق الفلسطيني في استرداد أرضه المحتلة والمغتصبة.
صالح لبريني
شاعر من المغرب