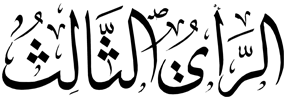شهرزاد تخرج عن صمتها.. من يروي الحكاية في سورية؟
للفلسطينيين حكايات مؤلمة من قبل النكبة، ولكن اتفق المؤرخون على أن المسار التاريخي المفجع يتحدد سنة 1948.
اقتحام الماضي واستعادة الحكاية هي التي دفعت إدوارد سعيد إلى القول آمراً فضلاً وطالباً ومتمنياً: "على كل فلسطيني أن يروي قصته".
وكثيراً ما حدث، في الحالات المأساوية لشعب ما، أن تولى راوٍ رواية حكايتهم، بالنيابة عنهم أو بتكليف منهم. هذا تواطؤ متفق عليه حدث أن سمّاه الناس في واحد من أطواره: الأدب.
من هذا المنطلق يمكن فهم غسان كنفاني ورشاد أبو شاور وإميل حبيبي وسحر خليفة وعشرات غيرهم. لقد كُلِّفوا أو تبنّوا أن يرووا حكايات الآخرين، لا لأن الآخرين تعوزهم القدرة على الروي، بل لشيء آخر أبعد من ذلك.
فأم سعد عند الشهيد كنفاني أمكن لها أن تروي قصتها، بطريقة ما، لكن وجب أن تكون بطلة القصة، لا راويتها.
ابتدأ الراحل إلياس خوري كلمته الافتتاحية في مؤتمر "الثقافة الفلسطينية إلى أين؟"، الذي نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في جامعة بيرزيت سنة 2016، بسؤال: من يروي الحكاية؟
مثل الثقافة الفلسطينية، لا يمكن قراءة إلياس خوري بمعزل عن "النكبة المستمرة"، فالتفوق الأخلاقي للثقافة الفلسطينية بالنسبة إليه هو شرط قدرتها على توليد الكلمات والمعاني الجديدة.
لذا فإن صراعها مع الصهيونية على من يروي الحكاية هو في جوهره صراع عمّن يرث الأرض والمستقبل.
في واحد من الحوارات الكثيرة معه، قال خوري إنه في عمله الروائي الذي احتل العمر كله، كانت مسألة كيف وأين تبدأ الحكاية هي السؤال. الحكّاء خرّيج مدرسة "ألف ليلة وليلة"
ويعرف أنه لا وجود لنهاية القصة، فهي قادرة على التوالد الدائم والاستعادة وإعادة التكوين إلى ما لا نهاية.
شهرزاد، بالنسبة لخوري، هي أول حكاية في الأدب العالمي، ومنها بدأت القصص، وهي المعلّمة الأولى التي وضعت أسس العالم الخيالي الذي لا يوازي الواقع، لكن يصنعه.
بهذا المعنى تغدو الحكاية، بالنسبة لخوري، لا عالماً متعالياً على الواقع، بل العالم والحكاية والحياة على المستوى الأدبي.
الحكاية شهادة
نعرف أن خصوصية شهرزاد وحكاياتها هي أنها تروي هرباً من الموت، حتى يصح القول: "وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح"، وهذا نهجها في الحكاية.
سورية هي شهرزاد صامتة أكثر من نصف قرن، الآن وقد زال معذّبوها، تخرج عن صمتها. الحكاية لم تعد من أجل النجاة، بل لاستذكار النجاة. إنها اقتحامٌ للماضي، من أجل أن يحاكم الحاضر ويُصنع شيء من المستقبل.
للسوريين حكايات مؤلمة منذ 1963، هكذا اتفق المؤرخون، ولكنهم مُنعوا من الإعلان عن حكاياتهم هذه حتى نهاية 2024. بعضهم يحاول اليوم أن يروي، يتعلم، يحبو في مطلع الحكاية،
ولكنه عند نهايته سوف يحس ذلك الإحساس المنيع العتيد الذي يقول: إنما من أجل هذه اللحظة عشت.
الحكاية المؤلمة إذن هي شهادةُ عيش، شهادة عيشٍ تحت الظلم والقهر والمجزرة، وهي في الآن نفسه شهادةُ نجاةٍ من الظلم والقهر والمجزرة.
وقد يحصل تواطؤ ضمني، فيُكلَّف أحدٌ بالروي، بالنيابة عن آخرين، وسوف نطلق على ذلك: الأدب، الأدب السوري الجديد.
يمكن لشهرزاد أن تتكلم
بدأ السوريون يقتحمون بالتذكّر الماضي، زمناً لم يعد كائناً، لكن آثاره وشظاياه كلها في الحاضر، وبهذا الاقتحام، بالتذكّر، تذكّر الموتى، تذكّر شهرزاد الصامتة قهراً وقسراً نحو نصف قرنٍ من الزمن، يستولد السوريون إحساساتهم، ويرتبطون بالحاضر ارتباطهم بالتذكّر نفسه.
في نقد بول ريكور لفهم هايدغر للوجود والزمن، يستند الفيلسوف الفرنسي إلى أساس التواصل الإنساني الاجتماعي القائم على السرد واللغة.
ويرى أن حركة الزمن لا تتوقف بالموت، بل تظل موجودة مع وجود الجماعة، ووجود التواصل بينهم، والسرد هو العنصر الأساسي الذي يضمن استمرار الحركة، عبر ما ينطوي عليه من تفاعل عضوي بين الماضي (زمن المسرود) والحاضر (زمن السرد).
ما يعني أن الكمون الزمني الماضي للوجود المسرود، يُبعث ويستعاد باستمرار عبر السرد الحاضر، وهو ما أطلق ريكور عليه "الهوية السردية".
صحيح أن فهم ريكور هنا ينطبق على الأدب، لكنه ينسحب على الحالة السورية أيضاً. إن "المسرود" في سورية هو نحو خمسين عاماً من الصمت الذي يغلّف الموت والنجاة كصفتين عامتين لتجارب السوريين، أما "السارد" فهو ما تبقى، ما نجا، ومن نجا.
"المسرود" هم السوريون جميعاً. "المسرود" هو الوجه الذي لا يُعرف له اسم وأُرسل إلى دار أيتام خطفاً من أهله المعتقلين، المسرود هو المغيَّب قسراً، وهو صيدنايا. المسرود هو مليون شهيد على امتداد عقدٍ ونصف.
المسرود هي سورية، شهرزاد الصامدة، والسارد هم السوريون جميعاً.
* يوسف م. شرقاوي
كاتب فلسطيني سوري مقيم في دمشق