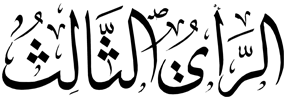نهاية العالم كما نعرفه
تُطلّ إيميلي ديكنسون من نافذتها، وتُخاطب شخصاً على بعد مسافة قصيرة: "أنا لا أحد، وأنتَ من تكون؟ هل أنت لا أحد أيضاً؟ إذا ثمة اثنان منّا". لكنّها لم تجرّب ذلك يوماً، على عكسنا نحن، الذين نعيش في عالم نرى فيه كلّ شيء، إلّا أنّنا غير مرئيين، بقدر ما نحن مكشوفون فيه. كأنّه نسخة من واقع لم نعرفه يوماً. ولم نلحظ السرعة التي تغير بها، حتى صار له وجه آخر تأخّرنا في إدراكه، رغم أن إيمانويل والرشتاين (Immanuel Wallerstein)، قدّم كتابه "نهاية العالم كما نعرفه" عام 1999، الذي يأتي في 500 صفحة، بمقولة تعبّر عن طبيعة العالم، "التّغيير أبدي، لا شيء يتغيّر على الإطلاق".
يشرح ذلك أن القول إنّ "التغيير أبدي"، أو التذمّر من "عدم التغيير"، مجرّد تفضيلين لقياس بعض الأمور، يرافقان أحياناً الاعتقاد بقدرة البشر على التقدم المبنيّ على قواعد عقلانية، تفترض الذهاب نحو الأحسن. بشعارات مختلفة، منها "التنوير" الذي حاول دفع الإنسان إلى الانتقال من التخلّف إلى النور الذي يعوّض ظلام العصور الماضية. لكن، لماذا لم يتحقّق التنوير في أوروبا حين انطلق عصرُه نظرياً؟ وبدلاً من ذلك، بدأ عهد الاستعمار المظلم بعده، بل حمله شعارا برّرت به الدول الأوروبية مطامعها الاستعمارية. ثم جاءت الحربان العالميتان لتُخلّفا معا ضحايا أكثر مما فعلت العصور المظلمة. بعدهما أيضا، لم يتحقّق النور الذي وعد به التّنويريون والعقلانيون، بل بدأ القرن الجديد بالدم الذي زرعه الغرب في المنطقة العربية، ليُنشئ حالة رهيبة من عدم الاستقرار.
لكن والرشتاين، في "نهاية العالم كما نعرفه"، اعترف بأن الحداثة، في هذا السياق، كما يقول "لا وجود لها على الإطلاق"، فنحن "لم نكن حداثيين على الإطلاق"، بالإحالة إلى عنوان كتاب المفكّر الفرنسي برونو لاتور (Bruno Latour) الذي يحمل هذه الجملة عنوانا، وكل ما يحدث هو تهجين. وبالتالي، "التغيير الذي حدث في العالم هو تحوّل البشر إلى مخلوقات هجينة (ساربوغ)"، لا هي المتقدّمة ولا المتخلّفة. أناسٌ "تحسّنت قدراتهم الطبيعية بالتكنولوجيا"، لكن ماذا عن نفوسهم وأطماعهم؟
شمل التهجين الطبيعة والثقافة، وأدّى إلى هشاشة شاملة، فصار كل شيء قابلا للانهيار التام، أو التفسّخ بأمراض ناتجة عن التهجين العشوائي للعالم، فانتقل به من نسبةٍ معينةٍ من المنطق، إلى الجنون التام. وإلّا أين المنطق في الأشياء التي تحدُث كلّ يوم؟ وفي حرب غزّة التي لا تدمّر فيها إسرائيل غزّة وحدها، بل نفسها، في حربٍ مسعورة غير منطقية، ولا استراتيجية، كما يجب أن تكون الحروب.
يقترح والرشتاين فكرة نهاية اليقينيات، دليلا على انتقال العالم إلى منطقة غير المعروف. وهو شيء إيجابي في نظره، لأنه يؤدّي إلى اعتناق التعدّدية، من أجل إيجاد أجوبة مستمرّة لمشكلاتٍ تتوالد مع الزمن. بحيث صار لزاما أن نسجّل أفعال اليوم في الماضي، لأنها تُصبح جزءا منه بمجرّد أن يُنطق بها. لكنه اعترف بأنه لا يمكن التنبؤ بمسار الزّمن مع ذلك. لكنّنا، في عالمنا اليوم، لا نعجز عن معرفة المستقبل فقط، بل عن التعرّف على الحاضر، فنحن غرباء في حياتنا اليومية، وتفوتنا الأحداث أو تتجاوز سرعة إدراكنا، فمن منّا لم يسخر منه الباعة، حين يُذكّرهم، مع هذا الغلاء الهائل الذي تركه لنا تضخّم ما بعد كورونا، بأسعار الشهور الماضية، بأن ما نعرفه صار في حكم المندثر، وعلينا اللحاق بركب التغيير؟
طبعا، تتحدّث قصيدة الشاعرة الأميركية إيميلي ديكنسون، "لا أحد"، من منطق شاعرة تودّ لو تكون خفيّة، لتهرب من عين من حولها. لكن الإنسان في الواقع الذي نعيش فيه، والذي يُفرض عليه فيه أن يعمل ويشتري ويبيع، لا يريد حتماً أن يكون نكرة، أو أن يجد نفسَه أمام عالم لا يكترث بوجوده، ولا بعقله الذي يودّ استخدامه من أجل المصلحة العامة.
لكن من يضمن أنه سيفعل؟ لذا ختم والرشتاين بالتأكيد على أن غطرسة الإنسان هي أكبر قيوده، وأن العقل خلاصه إذا "استعملناه، بعضنا مع بعض"، لكن كيف؟ وماذا نفعل بالعقول المعطّلة؟ وهل سيعود العالم إلى ما نعرفه؟
* عائشة بلحاج - كاتبة وصحافية وشاعرة مغربية