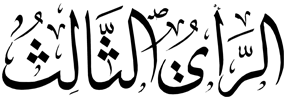مقاطعة الأدب والسينما الغربيّين.. هل البديل العربيّ متوفّر؟
"لم أعد أحبّ التحدّث بلغتهم أو مشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم ولا سماع أغانيهم أو حتى متابعة مشاهيرهم"، "لم تعد تغريني زيارة بلدانهم"، "هؤلاء يمتلكون قلوباً كالحجارة"، "ينظرون إلى الفلسطينيين والعرب كأنهم دون البشر". من المؤكد أن هذه الجمل، وأخرى مشابهة كثيرة، قرأناها أو سمعناها على شاشات التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار ردود الفعل العربية على الانحياز الغربي لــ "إسرائيل" في عدوانها على غزة.
قد يكون تناقل هذه الكلمات وإعادة نشرها بكثافة، عند البعض، مجرد لحظة اندفاع عاطفي. إلا أن الأمر مختلف تماماً عند الكثيرين ومنهم الأردنية سهام عطا لله، التي غيّرت نظرتها للأدب الغربي على ضوء ما يجري في غزة، وهي المتعمّقة فيه بحكم دراستها للأدب الفرنسي، والعمل لاحقاً كمترجمة للغة الفرنسية في العاصمة الأردنية عمّان.
تقول سهام، إن حالة من الصدمة وخيبة الأمل أصابتها حين رأت وسمعت حجم استخفاف الولايات المتحدة والغرب بحياة الفلسطينيين والعرب، وكذلك حقوق وحرية الإنسان التي كان أدباء الغرب يتغنّون بها على الدوام، ومنهم الأديب الفرنسي فولتير، الذي كان بمثابة قدوة لها عندما يتعلق الأمر بحرية الحياة وكرامة الإنسان. ففي معظم كتاباته كان يصرّ على هذه الحرية رغم تضييق الكنيسة التي كانت مسيطرة على حرية الرأي والتعبير.
كانت سهام مولعة، كما تصف، بأسلوب فولتير وتلاعبه بالكلمات والمفردات، بهدف التحايل على سلطة وسطوة الكنيسة في وقتها، وهو ما جعلها تعتمد الأسلوب ذاته في منشوراتها على "فيسبوك". لكن ردة الفعل الغربية على قتل الأبرياء في غزة شكّلت لديها حالة من عدم الثقة بكل ما يقوله فلاسفة الغرب وأدباؤه الذين يبدو أنهم عزلوا أنفسهم تماماً عن الواقع والحقيقة.
وتضيف عطا لله أنها حذفت عشرات الاقتباسات لفولتير عن صفحتها، ولم تعد لديها رغبة بقراءة اللغة الفرنسية، رغم أنها في صميم عملها، لا بل أنها تفكّر جدياً بترك عملها الحالي كمترجمة، والبحث عن عمل كمدرّسة للغة العربية التي تتقنها بشكل جيد جداً.
هوليوود والتلاعب بالعقول
على عكس حروب الاحتلال الإسرائيلي السابقة على قطاع غزة، تابع العشريني محمد شنك الاعتداء الحالي بشكل أكثر تركيزاً، وتحديداً زيارات المسؤولين الغربيين السريعة والمتكررة للقاء قادة الاحتلال، و"تقديم فروض الولاء والطاعة للصهاينة، وإعلان استعدادهم لتقديم كل ما يمتلكونه من تكنولوجيا قتالية لإراقة دم أخواننا الفلسطينيين"، كما يقول.
شنك، المولع بأفلام هوليوود والمسلسلات الأميركية، يقول إنه شعر لوهلة بأنه يتابع فيلم "أكشن" وهو ينظر إلى أشلاء أطفال غزة المعبّأة بأكياس سوداء. حينها، بدأ يعود في ذاكرته لأفلام حضرها سابقاً تظهر أيضاً سهولة القتل.
فقد "أصبحت في كل مرة أرى مجزرة في غزة أتذكّر مشاهد مماثلة لأفلام أميركية كانت تسرد قصصاً عن تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة أو دولة ما، وبدأت أراجع نفسي كيف كنت سعيداً عندما أرى عناصر المارينز يُبيدون قرية أو مدينة كاملة من أجل تحرير رهينة على سبيل المثال، واعتبر أنهم بذلك حقّقوا نصراً، لكن سرعان ما اكتشفت أن شعور السعادة والنصر الذي كان ينتابني هو نتيجة تلاعب بعقلي من قبل صنّاع الفن والدراما الأميركيين، وبات عقلنا يصوّر عنفهم وقتلهم وكأنه بطولة وانتصار على الباطل".
ويضيف: "هذا تحديداً ما يحدث اليوم في غزة، فالاحتلال لا يتوقّف عن تصدير صورة المظلوم والمعتدى عليه، رغم كل المجازر والدماء المسالة من أجساد الأطفال والنساء، والأغرب أن أميركا والغرب كذلك لا يرون إلا السردية الإسرائيلية".
لا يعلم محمد شنك إن كان موقفه هذا محصوراً في انزعاجه من الغرب المناصر للاحتلال، وما إذا كان سيعود إلى سابق عهده في متابعة إنتاجات هوليوود، لكنه متأكّد أنّ انفعاله وحماسته وتعلّقه بكلّ ما هو غربيّ "لن يعود كما كان"، خاصة أمام المجازر المروّعة المرتكبة بحقّ الفلسطينيين.
هل يعود الأدب العربي بديلاً من الأدب الغربي؟
"لنتفق بداية على أن الإقبال على القراءة عربياً في تراجع مستمر، خاصة في ظل التطوّر التكنولوجي الذي يُمكّن الأشخاص من الحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة". هكذا بدأ رئيس "اتحاد الناشرين الأردنيين" جبر أبو فارس حديثه ، لدى سؤاله عن الأدب العربي ومكانته مقارنة مع الغربي.
ويرى أبو فارس أنّ الكتاب الورقي أو حتى الإلكتروني لم يعد مصدر المعلومة الوحيد للجمهور العربي على وجه الخصوص، بل هو (أي الجمهور) يريد أن يبذل أقل جهد ممكن للحصول على المعلومات، ولا يكلّف نفسه عناء التحقّق من صحتها، حتى وإن كانت معلومات تاريخية أو عن أشخاص محدّدين.
لكن بعيداً من هذا الواقع يقول رئيس "اتحاد الناشرين الأردنيين" إن المجتمعات العربية مولعة بالسردية الغربية، وتمتلك ثقلاً أكثر من السردية العربية لديهم، وهذا الأمر، من وجهة نظره، يعود لعوامل عديدة، أهمها سقف حرية التعبير الممنوحة للكاتب. فالقارئ العربي، عموماً، يعلم بأن مقصّ الرقابة لا يتوقّف عن العمل ويقلّم ويلملم كل ما هو محظور بالنسبة له، ويبقى الكاتب في هذه الحالة يكتب لإرضاء الرقابة وليس لإمتاع الجمهور.
لذلك فإن القرّاء العرب على مختلف درجاتهم الفكرية والثقافية، يتوجّهون نحو الروايات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص تلك المنقولة إلى اللغة العربية، وهو أمر غير مستغرب، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القارئ يبحث عن المتعة والمعلومة والحرية عندما يقرّر اقتناء كتاب.
إلا أنّ أبا فارس يستدرك ليؤكّد أن "الكتّاب العرب الذين أنتجوا أكثر من 350 ألف كتاب ورواية ما بين أعوام 2015 إلى 2019، بحسب أحدث تقرير لــ "اتحاد الناشرين العرب"، قادرون على إعادة استقطاب القارئ العربي، لكن بشرط توقّف الماكينة المشغّلة لمقصّ الرقابة من جهة، وإعادة تقييم ما تتمّ كتابته ويجري نشره من جهة أخرى. فالجودة أهم من الكمّ، كما يقول المثل الإنكليزي".
هل يمكن مقاطعة السينما الأميركية؟
نحو 400 مليون دولار ميزانية أحد أفلام الأبطال الخارقين في (هوليوود)، وأقل من 20 مليون دولار ميزانية إنتاج فيلم لأشهر ممثل مصري. هذه هي المعادلة التي بنى عليها المخرج السينمائي الأردني محمود البراري وجهة نظره المتخوّفة من قدرة المشاهد العربي على التخلّي عن السينما الغربية، وتحديداً الأميركية، لصالح السينما العربية. فالموازنة المالية المخصصة لإنتاج الأفلام تؤدي دوراً مهماً بالنسبة للمخرج البراري في تحديد نوعية وجودة المنتج النهائي الصالح للعرض.
ويؤكد البراري في حديثه: "حتى وإن حصلت الأفلام العربية على القدرة الإنفاقية للأفلام الغربية ذاتها، فلن تستطيع التفوّق عليها. لأن المتابع العربي يبحث عن فضائيات مرئية خارجة عن المألوف والواقع المعيش، وغالباً ما يجد الجمهور ضالته لدى صنّاع السينما في الغرب، القادرين على إخراج المشاهد من دائرته الضيّقة إلى عوالم واسعة لا حدود لها، وبذلك تضمن ولاء الجمهور وشغفه الدائم، وربما الإدمان في بعض الحالات على هذا النوع من الأفلام".
في المقابل، يفتقر الإنتاج السنمائي العربي، وفق البراري، للأدوات التي تمكّنه الخروج من الدوائر المغلقة المكررة في كلّ إنتاجاته.
إذ رغم مرور أكثر من 100 سنة على بدء إنتاج الأفلام العربية وتحديداً المصرية، فإن هذه الصناعة بقيت محصورة في نوعين من الأعمال، الأول وهو الأفلام التجارية، والتي تعتمد غالباً على الإنتاج بأقل التكاليف وتحقيق أكبر العوائد عن طريق قصة وسيناريو "ركيك" يهدف إلى شدّ انتباه الجمهور من دون وجود معنى أو مغزى من القصة. أما النوع الثاني فهو نقل للواقع المجتمعي بكلّ مشكلاته وسلبياته وحتى إيجابياته، وهذا تحديداً ما ملّ منه الجمهور العربي على مرّ العقود.
*محمد عدنان حمد - الميادين الثقافية