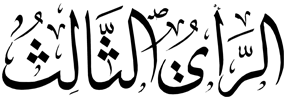"العرب" بين فكرة القومية ومأزق الحريّة!
عندما تأسّست جامعة الدول العربية عام 1945م، بصفتها منظمةً إقليميةً تمثّل كياناً جغرافياً يسمّى "الوطن العربي"، افترض البعض في حينه أنّ هذه الخطوة الأولى نحو الوحدة العربية، وأنّ المشروع البريطاني خلال فترة الانتداب على دول المنطقة، ساهم في ولادة هذه الجامعة، بهدف "تأهيل" الكيانات السياسية العربية الناشئة تحت مظلّة قوميّة! فيما افترض آخرون أنّ دعم بريطانيا للجهود العربية في قيام الجامعة العربية، بعد الحرب العالمية الثانية، هدفه ضمان بقاء الكيان الجديد تحت تأثير نفوذ القوى الإمبريالية القديمة والجديدة.
لا شك أنّ الجامعة العربية، ومنذ عام 1990م، تعكس خيبة أمل شائعة بين الشعوب العربية، وشعوراً واسعاً بالإحباط من مؤسّسات العمل العربي المشترك، في ظلّ خمولها وغيابها التام في القضايا الكبرى والأزمات المصيرية،
وتعرّضت لنقد شديد من النخب السياسية والفكرية على امتداد الجغرافيا العربية، فلم تنجح في تحقيق الحدّ الأدنى من أهدافها المعلنة، ولا في التعامل الفعّال مع القضايا السيادية؛ فلسطين، لبنان، العراق، سورية، السودان، اليمن وغيرها،
وفي كثير من القرارات بقيت رمزية أو غير مُلزِمة، ما جعل دور الجامعة، وفكرة "القومّية" محلّ تساؤل وشكٍ دائمَين.
وبرأينا أنّ البُنية الإقليمية "للجامعة العربية" لم تُصمَّم أصلاً لتحقيق وحدة أو تكامل، بل لضبط الإيقاع ضمن حدود لا تهددّ المصالح الغربية ولا تُفككّ المنظومة التي رسمها الاستعمار بخطوطه وحدوده،
فالجامعة "بُنيت لتقسيم الجيوسياسي العربي" بما يتماشى مع نظرية إدارة التفكّك لا مقاومته، أي أنّ المؤسسة توفّر غطاءً شكلياً للوحدة، بينما في الواقع تكرّس الانقسام!
والأمثلة الواقعية التي عصفت بالمنظومة العربية خلال العقود القليلة الماضية، تؤكّد صحة هذه الفرضية، فالمواقف متباينة بين الدول إلى درجة العداء والقطيعة أحياناً، فضلاً عن استغلال الجامعة، أحياناً، أداةً في صراعات إقليمية بدلاً من كونها محايدة وموحِّدة.
ومع ذلك، هناك من يرى أنّ ضعف الجامعة لا يعني بالضرورة أنّ فكرتها كانت خاطئة من الأساس، بل إنّ المشكلة تكمن في الإرادات السياسية للحكومات الأعضاء، لا في الهيكل ذاته.
فهل البديل يكمن في نموذج جديد للوحدة العربية، أم أنّ فكرة "الوحدة" بحدّ ذاتها لم تعد واقعية؟
بعد قرن من تفككّ المشروع القومي، تغيّر إدراك الدول والأنظمة العربية، لمقاربات الوطني والقومي،
وفكرة "الوحدة"، التي كانت في لحظة من التاريخ حلماً تحمله النخب والجماهير، أصبحت من الأطلال والتراث، أمام صعود الدول القُطرية وترسيخ مفهوم السيادة بمعناه الضيّق، والتحوّلات الاقتصادية والسياسية التي ربطت بقاء الأنظمة باستقرار خارجي لا داخلي،
إضافة إلى التجزئة الثقافية والإعلامية التي عمّقت الفوارق بدل أن تردمها، وأيضاً خلوّ الساحة من مشروع أيديولوجي جامع بعد تراجع القومية واحتواء الإسلام السياسي!
ويكمن جوهر المشكلة في غياب الأيديولوجيا العابرة للحدود القومية التي بإمكانها أن توحّد، أو حتى تقرّب بين الشعوب قبل الأنظمة،
فالوحدة في الخطاب السياسي غالباً ما تُذكر، إما لأغراض شعبوية أو في سياق عاطفي، لكن لا توجد أدوات فعلية لتحقيقها، ولا حتى رغبة حقيقية من الأنظمة العربية، التي ترى في كلّ مشروع وحدوي تهديداً لمصالحها أو وجودها.
وجذر المأساة (أو الملهاة إن شئت) السياسية العربية المعاصرة، يعكس واقعاً تُهيمن عليه أنظمة أوليغارشية تتغذّى على الاستبداد والفساد والتهميش،
وتتصرّف بصفتها "ثقباً أسود" يمتصُّ الطاقات، ويبتلع المبادرات، ويعيد تشكيل كلّ تهديد مُحتمل ليصبح جزءاً من بنية هذه الأنظمة!
وفكرة التغيير التي تبدأ من الأسفل، أي من الشعوب، كما يرى البعض، تصطدم بجدار سميك، فغياب الحرية يجعل الوعي مشوّهاً، والإرادة الجماعية مكسورة، والبدائل غائبة أو مُصادَرة، والاحتكار الإعلامي والثقافي؛ من الأنظمة، يجعل حتى الحلم بالتغيير يُجرَّم أو يُشوه!
إنّ فشل الربيع العربي، أو بالأدق "إفشاله"، مثّل ضربة كبرى للثقة الشعبية بإمكان التغيير السلمي أو الجماهيري، فقد مثّل "الربيع العربي" مشروعاً جماهيرياً للتحرّر وإعادة توزيع الثروة وتداول السلطة،
وكان فرصة نادرة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، لكن أحلام الشعوب قُمعت من الداخل والخارج، وتحوّلت بعض مساراتها إلى كوابيس من الفوضى أو الحروب الأهلية، ما أعاد تثبيت خطاب "الاستقرار مقابل الحرية" الذي تتسلّح به الأنظمة.
وبلا حرية، لا يمكن أن يُبنى مشروع وطني أو قومي، لأن كلّ مشروع مشترك يتطلّب مشاركة، والمشاركة لا تقوم إلّا على الإرادة الحرّة.
وهكذا، قد لا تكون أزمة الجامعة العربية سوى انعكاس لأزمة أعمق:
غياب مشروع عربي جامع، لا تصنعه الأنظمة، بل تتبناه الشعوب، حين تُتاح لها الحرية.
فهل كانت الجامعة العربية انعكاساً لعجز الأنظمة أم تعبيراً عن موت الحلم القومي؟
وهل يمكن لمشروع وحدوي أن يولد في غياب الحرية، وتحت قبضة أنظمة ترى في كلّ تقارب تهديداً لوجودها؟
أم أنّ المعضلة الحقيقية ليست في فشل المؤسسة، بل في غياب الإرادة الشعبية الجامعة، التي وحدها تستطيع أن تحوّل الشعارات إلى واقع، لو أُتيح لها أن تُعبّر وتختار؟
لعل السؤال الأهم لم يعد: هل يمكن أن نتوحّد؟"، بل.. هل ما زال أحد يريد ذلك حقاً؟
ياسر قطيشات
باحث وخبير من الأردن.