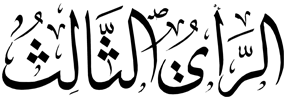ديدان السياسة وأرباب الفساد أكثر ضررا على الأوطان..!
قُرانا كانت تفتقر للكثير مما نحتاجه أو نلجأ إليه. لا توجد مستوصفات صحية ولا مرافق طبية. لا توجد مختبرات يمكنها كشف عللنا وتشخيصها حتى اليسير منها.. لا يوجد شيء اسمه وعي صحي، ولا شيء لدينا اسمه إرشادات طبيب.. كان غالباً التوكل في الصحة على الله، وكثيراً ما كانت تتدهور الصحة ويهتد حيلنا من المرض. كان الممكن قليلاً وغير متسع، أو هو في حكم ما قل وندر لمن لديه بعض من فسحة ومقدرة.
كانت العلاجات المتوفرة في “الدكاكين” لا تزيد أسماؤها عن عدد أصابع اليد الواحدة؛ وهي “الأسبرو” و “الأسبرين” و “أبو فاس” و “المستليتم” و “شربة سنة” هذا كل ما نعرفه عن العلاج الذي يباع، ومتعارفاً عليه في تلك الأيام.. هذه كانت كل صيدليتنا التي نلوذ بها ونلجأ إليها كلما داهمنا الرشح، أو الزكام أو الحمى أو وجع الرأس أو ألم المفاصل وصرير العظام.
أما الكي أو ما نسميه بـ”المياسم” فيستخدم لمعالجة بعض الأمراض التي لم تستجب للعلاج المعتاد، أو كانت مستعصية على ذلك الزمان والمكان. إذا عجز المريض من الحصول على الطبيب والتطبيب المناسب؛ فالكي آخر العلاج، وربما ليس بآخره، وهناك من فضّله. وربما تتعدد وتتنقل “المياسم” في الجسد الواحد بحثاً عن الشفاء، حتى وإن تركت تشوهات فيه، ورافقت أصحابها حتى آخر العمر. وبالكي على المريض أن يشفى، أو يصبر ويبحث عن البديل، أو يصابر وينتظر موته معلولاً بالمرض الذي يعانيه.
أما ما نسميه “الصفار” ويسمّى اليرقان، فكان يصيب عدد غير قليل من الناس، وكان العلاج هو قطع أحد الأوعية الدموية تحت اللسان.. والتشافي كان غالباً ما ينجح، ويستعيد المرء لونه وصحته، والبعض تتضافر أمراضه، وتسند بعضها بعضا، حتى تهد قواه وتتلاشى حيلته، ويمضي إلى حتفه مختاراً أو غير مختار.. مستسلماً و راضياً أو دون رضاه.
أما الجراح فكنّا نستخدم الأشجار لتلتئم من خلال مادة صمغية توجد في شجرة “الأبكي”.. وهناك بعض النبات والأشجار الأخرى يمكن أن يتم اللجوء إليها لأمراض أخرى اعتاد عليها الناس كـ “القُطِّبة” مثلاً لتفتيت أو وقف نمو حصوات الكلى أو مساعدتها على الخروج.
كما أن بودرة “البنسلين” ربما تصل إلي المريض عبر صحي، أو طبيب يأتي من بعيد إن كان للمريض سعة ومقدرة، فيتشافى أو يدركه الأجل. علماً أن هذا لا يحدث إلا نادراً بسبب أتساع الفقر وقلة الميسرين..
أما خلع الأسنان فربما تجد من يقوم بها في مكان غير بعيد، ولكن من دون تخدير أو إحتراف.. أما تسوس الأسنان فكان يوجد في قريتنا فقيهاً يعالجها بطريقة نقلها من الحبشة تشتمل على “عرصم” وأنبوب وشمعة، أما صناعة الفك والأسنان؛ فكان يمتهنها رجلاً يأتي من بعيد، ربما يمكث أسبوعاً أو أقل في قرانا، ثم يرحل، ولا يعود مرة أخرى إلا بعد عام أو أكثر.. وهذا الرجل يبدو أنه كسب مهنته تلك بالخبرة لا بالتعليم والدراسة.
المصل أو التطعيم لم نعرفه غير مرة وصل إلينا عبر المدرسة، وكان ضد مرض الجدري.. مازلت أحمل “مشلاه” على ساعدي إلى اليوم. كنا نشعر أننا نعيش في مكان قصي من هذا العالم العصي حتى على مخيلتنا في تلك الأيام.
الطبيب والذي كان أبي يسميه “الحكيم” لا يوجد إلا في منطقة بعيدة لم نلجأ إليه إلا إذا بلغ المرض مبلغه، وصارت الأعراض شديدة تكبّنا إليه كبّاً.. ولكن لا نلجأ إليه في الغالب إلا إذا كان الحال يسمح والمرض قد أصابنا بمكين. كنّا نقاوم أمراضنا أو نتعايش في الغالب معها حتى تهدّنا أو تدفعنا الضرورة إن كان في الأمر متسع للذهاب إلى الطبيب الذي يبعد عنّا أميالاً وفراسخ.
المرَّتان اللتان أسعفت فيهما إلى الطبيب في القرية؛ كانت الأولى إلى منطقة “ثباب” في الشمال، والثانية إلى عيادة في منطقة “شعب” بالجنوب، والتابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. حدث هذا عندما داهمني انقطاع النفس فجأة في ساعة متأخرة من الليل في حالة تشبه “الربو” أو هي كذلك. وفي الحالتين كان إسعافي قد تم على ظهر حمار.. لم تكن السيارات يومها تصل إلى قرانا.
كنّا في قرانا غالباً نتعايش مع أمراضنا، أو هي تتعايش معنا، وحالما يهدّنا المرض يمكن أن نبحث عن حيلة أو طبيب، أو نقصد المدينة لمن له قدرة وسعة. أغلب الناس كانوا لا يصلون إلى طبيب أو مدينة. كنّا نتعايش مع “المخاوف” كلها.. كان الفقر والمرض يتكالبان علينا، وينالان منّا كل منال.
***
ذهبنا إلى سوق الخميس أنا وابن عمي سالم. عزمنا على الهروب، وهربنا بالفعل إلى منطقة “الرما” لنلجأ إلى بعض أقاربه هناك. كان فعلنا أشبه بلجوء إنساني ننشده. وفي طريق هروبنا في “العتبة” شاهدتُ الجبال تسير بسرعة.. حاولت دعك عينيى وإمعان النظر فيما أراه فوجدته يبدو مؤكداً، بل رأيتها تركض بسرعة مذهلة.
سألت رفيقي سالم، الهارب معي، هل يرى ما أراه؛ فأجابني أنه أيضاً يشاهد ما أشاهده.. الجبال كلها حولنا تسير بعجل وسرعة. تحدثنا واتفقنا أن ما نشاهده حقيقة لا خيال.. بدا لنا الأمر وكأن إلهاماً سماوياً وكشف عظيم خصّنا الله به.. ظننا أننا أعدنا اكتشاف ما سمعناه عن دوران الأرض، وسير الجبال، والحقيقة هي إن كلانا كانا دائخين ونعيش لحظات دوار، بسبب سوء التغذية وعدم تناول وجبة الفطور.
وصلنا إلى منطقة “الرما”.. استقبلونا بعض من أهله بفزع، ومخاوف من ردود فعل أهلنا. استضافونا ساعة زمن، ثم أعادونا إلى أهلنا بعجل.
عانيت في طفولتي من الدوخة والإعياء وفقدان الشهية. عانيت من ضعف وإنهاك وإرهاق وسوء تغذية. آلام في البطن تشتد بعض الأحيان، ومغص وبعض اضطرابات معوية تنتابني بين حين وآخر.
أحياناً أعاني من القيء والإسهال وانتفاخ البطن. أحياناً أشعر بحاجتي للتبرز وقتاً طويلاً أو معاودة التبرز بعد وقت قصير، ثم لا أرى أحيانا إلا شيئاً قليلاً من الخراج، لا يخلوا من مخاط، وكنّا نسمي تلك الحالة بالـ”أُزه”، ونعاني من أمراض معوية أخرى، وأعراض شتى وأكثر.
كنت أبدو منهكاً وأعاني من أمراضي وأحاول التعايش معها، وكان يرجع جلّها إلى عدم توفر الأكل الصحي وقبله الماء النظيف. في مواسم النزاف ولاسيما الشديد منه كان الغالب على الماء الذي نجلبه من الآبار ونشربه متكدرا ورائحته لم تعد مستساغة، إن لم تكن قد صارت كريهة، ولا بديل لنا ولا مناص إلا أن نشربه.
لقد كنّا نعيش صراعاً من أجل الحياة والبقاء، وكان بعض مما يبقينا على الحياة هو في الوقت نفسه جالباً للمرض أو مسبباً له.. أقدار فرضت علينا مشيئتها دون سؤال، وعيش اضطراري مرغمون عليه، وغياب البديل.. “مكرهاً أخاك لا بطل”.
فقر الدم كان ملازماً لطفولتي، أو هذا ما عرفته لاحقاً.. وأكثر منه كنّا مستوطنات لكائنات تعيش فينا رغماً عنّا.. كنت أشعر أن أمعائي في بطني قد تحولت إلى مستوطنة للديدان الكثيرة والمتنوعة.. كنت أشاهد الديدان في برازي أكثر من نوع وفصيل، غير أن في إحدى المرات كانت المفاجأة كبيرة فاقت تصوّري وتحمّلي، بل وخيالي أيضاً.
***
كان أبي يفلح بمدرج في الجبل، وعمتي أم عبده فريد في مكان غير بعيد، وكنت أنا أقضي حاجتي في مكان قريب منهما. ذهبت لأتبرز وبدلاً من البراز شاهدت شيئاً يخرج من أمعائي عبر فتحة الشرج.. كائناً أبيض يشبه الثعبان.. سألت نفسي في لحظة اضطراب وإرباك: ثعبان يعيش في بطني.. ماذا يفعل وكيف يعيش؟! أنا الآن في لحظة معرَّض للدغه.. لقد عشت لحظات إرباك تفوق خيالي!! جالدتُ نفسي، وحاول حيائي أن يعينني على الصبر. ولكن ما حدث كان أكبر مني ومن خيالي!
عشت لحظات من المحنة والحيرة والهلع الكبير.. استمررت بزحاري لأخرجه، ولكن بدا لي أن الثعبان يطول، وصبري كاد ينفد، فيما ذلك الكائن العالق مستمراً بالتمدد والخروج.. وصل طرفه الأرض وهو لازال متدلياً من فتحة الشرج يتمدد ويطول، ولا أدري طرفه الآخر إلى أين يمتد.. تخيلت أنه أكبر من أمعائي.. اعتراني مزيداً من الخوف والهلع والاضطراب.
حاولت أن أتحمل الأمر لعله يكتمل خروج هذا الكائن الغريب، ومن دون أن يحدث ما بدا لي أشبه بالفضيحة. إن صرخت وعرف الناس قصتي ربما تظل تلاحقني بقية عمري دون فكاك، غالبتُ نفسي، وكابدت حيائي للحظات؛ فيما لازال هذا الكائن متدلياً دون أن ينتهي، ودون أن أعرف منتهاه!!
نفدَ صبري وفاق الأمر تحملي وخيالي، وتجربة طفل لا زال منعدم المعرفة بحالة كتلك.. لم أعلم لكتمان بأمر من هذا قد أصاب غيري كبيرا كان أو صغيرا.. لم أمر من قبل بتجربة مماثلة وعلى هذا النحو من الجسامة التي بدت أكبر منّي. كانت التجربة قاسية، واللحظات المربكة فظيعة على طفل مثلي.
انطلقت بهلع يسبق الصوت.. أنطلقتُ وأنا أصرخ صراخاً متطايراً في كل اتجاه “حنش.. حنش.. حنش…” والهلع يجتاحني من رأسي حتى أخمص قدمَيَّ.. صراخي يسبق ركضي بمدى الصوت.
هرعت عمتي بعجل نحوي، وحاولت تستكشف الأمر، وما لبثت أن عرفت قصتي، فسحبت ذلك الكائن إلى الخارج وهي تقول “قلاليط.. قلاليط” لم أكن أعلم بهذا الاسم.. أول مرة أسمع به وبدا لي من تصرفها وهي تهدئ من روعي إنه معروف لديها ومخبور إن لم يكن شائع.. استمرت تهدّئ من فزعي وهلعي، وتهدهد خجلي وحيائي الكبير الذي استبد بي، وكان يشتد مع لحظاتي التي تمر.
شاهدتُ الدودة من قامتي وهي كثعبان على الأرض، ربما يتنفس أو يبدي حركات خفيفة، هدأ روعي وفي المقابل أشتد خجلي من نفسي بما لا سابق له.. أحسست إن خجلي يبتلعني.. تمنيت لحظتها أن تبتلعني الأرض التي أقف عليها حتى لا يراني أحد، وعرفت أنه كان يلزمني قليل من الصبر لأتمكن من التخلص من ذلك الكائن الذي أصابني بالهلع، ثم أسأل عنه وعمّا حدث لي، وأعرف كل شيء بجواب سؤال.
ما حدث فاق سني وتجربتي، وكانت المرة الأولى التي وقعت فيها على ذلك النحو الذي أخزاني، وأحسست إن الجبل رصد كل ما حدث لي ورآه بأم عينيه، فيما أبي عرف الأمر وكان يقهقه بصوت زادني خزياً وحرجاً أشد.. إن هلعي وروعي الذي بلغ ذروته تحول إلى لحظات خزي تشبه الفضيحة.
لحسن حظي أن أقراني الأطفال لم يعلموا بقصتي، وإلا لكانت فضيحتي على كل لسان، وربما دفعتني للانتحار أو للهروب بعيداً عن قريتي إلى مكان قصي أعيش فيه بعيداً عما عشته ورأيته.. ولكن عندما كبرتُ ووعيت وخبرتُ الحياة بدا لي الأمر عادياً جداً، بل وبإمكاني أحكيه وأكتبه وأسخر منه، وأكثر من هذا تيقنت أن حجم الوعي أو تناميه يمكنه أن يبدِّل نظرتنا لكثير من الأشياء والمفاهيم بما فيها “العيب” الذي لطالما عشناه.
كانت تلك الديدان المتنوعة صغيرها وكبيرها تقتات على غذائي وما في معدتي.. تقاسمني حقي في العيش والحياة، بل وشعرتُ أنها كانت تقتاتني دون علمي.
عندما كبرت وقرأت عرفت أن ذلك “الثعبان” الذي أتصوره إنما هو دودة “الأسكارس” ويطلق عليها أيضاً اسم “ثعبان البطن”، حيث يبلغ طوله تقريباً ٢٧ سم، وتتراوح ذروة الحياة بالنسبة له من عامين إلى ستة أعوام.
أما ديدان “الأسكارس” اليوم فهم غير أولئك الذي شهدتُ كبيرهم في طفولتي الباكرة.. إنهم أشد واغلظ.. أكثر نهماً وضرراً وفتكا.. يتورمون فساداً ونهباً.. استولوا على قوت شعبنا الذي بات بوجودهم يتضور جوعاً، ويموت مجاعة.. بات الوطن بما فيه لا يكفيهم.. أفسدوا حياتنا والتهموا وطناً من أوله إلى آخره، ويتمنون لو استطاعوا إفساد الكون كله.
***
– من مذكراتي ..